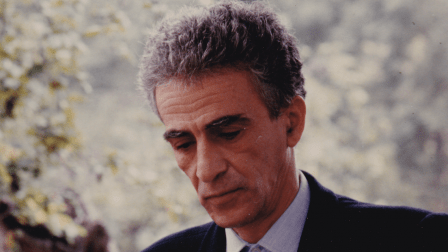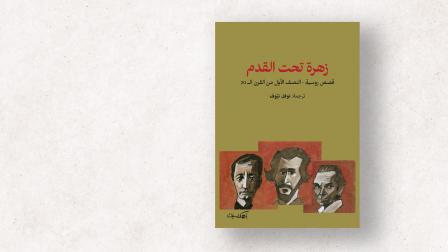رجل يقود سيارته في الطريق بين دمشق وبيروت 1948
-1-
عرفتُ لبنان شابّا وافدا من تونس يدرس في جامعة دمشق مطلعَ ستينيات القرن الماضي. كنتُ أقصد بيروت مع غيري من الطلبة المغاربة نمتح منها كلٌّ حسب استعداداته وميوله ومشاربه. كانت زياراتنا إلى لبنان ثم عودتنا إلى الشام مثيرة بأكثر من معنى. في تلك السنوات كانت الأحداث العربية في تزاحمها الشديد ونفَسها الملحمي مثيرة للآمال القومية زاخرة بالثقة في النفس وفي المستقبل لكنها مع ذلك كانت تطرح أسئلة محيّرة.
كنتُ أجدني في كل مرّة أعود من بيروت إلى دمشق مستغربا من الفارق النوعيّ بين المدينتين والبلدين. لماذا كل هذا الاختلاف بين طبيعة الحياة هنا وهناك؟ هل هو اختلاف ظرفي سطحي أم إنّه قديم عميق؟ لماذا لم تتمكن القواسم المشتركة البيّنة بين القطرين من تقليص الفجوة التي تبدو كأنها مرشّحة دائما للاتساع؟
كان لبنان أيامَها برئاسة فؤاد شهاب يتعافى من اضطرابات سنة 1958 المحلية والإقليمية التي اختلّ جراءَها الأمن مما أدّى إلى إنزال للقوات الأميركية. سوريّة من جهتها أُرغمت على مغادرة تجربة الجمهورية العربية المتحدة إلى نظام الانفصال تلته مرحلة قلقة مهّدت لوصول حزب البعث إلى الحكم.
من تلك السنوات بقيت بيروت-لبنان ودمشق-سورية مرتسمتين في وعيي بقربهما وبعدهما بوابةً للمشرق العربي كلّه بثرائه وما يثيره من إعجاب وغموض لا ينقطعان. بقي السؤال قائما بعد ذلك طوال سنوات ومعه حيرة ملازمة عن ذلك الفارق النوعي بين الجارتين المتنافستين.
-2-
ثم تراكمت التجارب واتسعت الرؤية وتضافرت المعارف بما أفضى إلى انكشاف تدريجي لطبيعة ذلك التنافس الشديد. أدركتُ أن لكل مدينة دلالة رمزية ثقافية تختلف عن الأخرى.
بيروت، التي كان فيها من كل شيء، جعلها موقعها البحري قريبةً من أسطورة الأميرة "عليسة الفينيقية" أو " ديدون" رمز الحرية التي خلّد ذكرها الشاعر اللاتيني " فيرجيل" في ملحمته الشعرية: الإنياذة.
أما دمشق فقد تمثّلتْ موقعَها الجغرافي الحضاري موليّةً ظهرها البحر مُقبلةً على بلاد الرافدين وفارس والهند فكانت نسيجا من العراقة و الإباء. ذلك ما اعتنى بإبرازه المؤرخون القدامى والمحدثون من أمثال "ابن عساكر" قديما في كتابه المرجع " تاريخ دمشق" و "فيليب حتّي" حديثا في مؤلفه الشهير" تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين".
من حنايا المدينتين تشخص لنا نظرية "عبقرية المكان" التي اشتغل عليها بألمعية "الدكتور جمال حمدان" في دراسته المتميزة " شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان".
تعيّنت تلك العبقرية في بيروت في انفتاح ذكيّ على المحيط يعرض إمكانياته في واقعية ومرونة بينما تجسّدت نفس تلك العبقرية في دمشق شخصية مغايرة معتزّة تسعى إلى حضور نضالي وتعمل على أن تكون قلبا للعروبة النابض ليس بما تعرضه بل بما تفرضه.
بذلك تحدد التنافس بين القطرين من خلال مفهومين مختلفين ينتظمان الحياة العربية المعاصرة: السياسة والحكم.
-3-
في بيروت- لبنان اعتَمد رمزُ الحرية مفهومَ "السياسة" الحامل لقابلية الـتعدد والساعي إلى الوفاق بينما تجلّت دمشق-سورية معبّرةً عن ذاتها بتقمّص مفهوم "الحكم" المولي الأولية للاستقرار والانفراد بالحضور.
في بيروت، كان الشعار هو: أقل ما يمكن من سلطة الدولة وأكثر ما يمكن من الحريات تعبيرا عن الشراكة الداخلية وإغناءً للذات بالعلاقة مع الخارج. في دمشق تعيّن نموذج "الدولة الخارجية" حيث تكون السلطة السياسية المتمركزة هي الضامن لاستقرار المجتمع وللحركة والإبداع فيه.
من تقابل هذين المفهومين يمكن تفسير جانب هامّ من التنافس بين الشقيقين اللدودين.
لكن أخطر ما في هذا التنافس هو تحوّله إلى تناقض. تباينُ المفهومين أدّى إلى استعصاء العطاء اللبناني على تحقيق كامل الفعل في الداخل المحلّي والقومي بسبب الممانعة السورية. كذلك تأكد أن بيروت تستطيع تقليص فاعلية دمشق أو المسّ من مكانتها في مجالها الإقليمي بما للبنان من تفاعلات داخلية وما تحيل عليه تلك التفاعلات من مؤثرات دولية.
من ثم اتضح أن ثنائية السياسة والحكم تفتح مجال فهم تعثر التقدم العربي لشدة ارتباطها بإحدى معضلات الفكر السياسي المتمثلة في طبيعة العلاقة بين قدرة المجتمع وسلطة الدولة وحرية الفرد.
هي معضلة قديمة تبرز بوضوح في النصوص المرجعية والتي انكب عليها المؤرخ التونسي الدكتور أحمد عبد السلام في كتابه "دراسات في مصطلح السياسة عند العرب".
-4-
ما نجده عند ابن منظور في "لسان العرب" أو في المعاجم اللغوية العامة متعلّقا بالسياسة يجعلها تراوح بين ثلاثة اعتبارات: الأول: امتلاك الأمر (سوّسه القومُ: جعلوه يسوسهم) والثاني: القيام على الشيء بما يصلحه، والثالث: التيسير (سوّس فلان لآخر أمرا زينه له ليجعله مقبولا لديه).
يعضد هذا ما نعثر عليه في كتب الفقه والسياسة الشرعية التي تكاد تتفق على أن السياسة هي جملة القوانين الموضوعة "لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأموال". إنها كما عرفها الفقيه الحنفي أبو البركات النسفي: "السياسة حياطة الرعية بما يصلحها لطفاً وعنفاً" أو ما حدده محمد علي التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون بأنها " إصلاح للخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل والآجل على الخاصة والعامة ".
من هذه الزاوية تقترن السياسة بأمرين هما تفوّق السائس وطلب المصلحة.
حقل السياسة إذن في منظومتنا العربية الإسلامية يهدف للربط بين الخبرة والترويض وهو بذلك يقترب من التعريف الحديث للسياسة التي هي "علم حكم الدول".
أما الحكم فقد استُعمِل قديما بمعنى القضاء أو بما هو من لوازم الفصل بين المتخاصمين أي الحكمة كما ورد في آية " آتيناه الحكم". لذلك قيل: "هو يتولّى الحكومات ويفصل الخصومات" اعتبارا لصبغة الحكم التنفيذية التي نبه إليها عبد الملك الأصمعي فيما تستدعيه من بُعد النظر ومراعاة قيمة العدل.
-5-
الحكم، على هذا، أخصُّ من السياسة لأنه أحد شُعبها وميدان من ميادينها. لكن الاستعمال الحديث وسّع من دلالة مفهوم الحكم فأتاح له وهو الجزئي أن يعادل مفهوم السياسة الكلّي رغم أنّه كان أحد مقتضياتها، ذلك الذي يطلق عليه الفقهاء القدامى فيما أثبته التهانوي في كشافه "الشوكة الظاهرة والسلطنة القاهرة ".
يمكننا على ضوء هذه التعاريف المستمدة من التراث السياسي أن ندرك أن التنافس التبايني بين الجارين يعود في جانب منه إلى خلل في معادلة السياسة والحكم. في دمشق تحوّل الجزءُ إلى كلٍّ عندما استعلى الحكم على السياسة وعندما اعتُبرت هذه الأخيرة مسألة ثانوية لارتباطها بتعددية الرؤى والمصالح في المجتمع.
في هذه الحالة يتحقق التنافي بين قدرة المجتمع وحرية الفرد وبين سلطة الحاكم لرهان هذا الأخير عمّا يقوّي فاعليته في الخارج تحقيقا لمشروع يعتبره مصيريا. أما في بيروت فالسياسة حصيلةٌ للثراء الوطني بما يجعل حريات المجتمع ومختلف مكوناته مشروعة و متحققة. لكن حالة ضعف الحكم وطغيان السياسة تهدد الاستقرار و تزيد من مخاطر التدخلات الأجنبية.
عند هذا الحدّ يبرز ابن خلدون كأفضل من يشخّص هذه الوضعية القديمة - الحديثة. لقد قرن السياسة بالملك بصورة شَرطية فلا مجال له إلاّ بالسياسة التي تعني الفكرة المؤسِّسة أو المشروع الذي يجمع بالمعنى الأصلي للاجتماع. ذلك ان "الملك الكامل" عند ابن خلدون هو الذي يحافظ على العمران وهو ما اصطُلح عليه حديثا بالحكم الرشيد. أما "الملك الناقص" فيؤدي حسب قانون الاجتماع في "المقدمة" إلى "خراب الأوطان، باختلاف الأيدي وانحراف السياسة إلى أن ينقرض عمرانهم".
-6-
الإشكال المُـتبَقي والماثل أمامنا، بخاصة اليوم، بعد ما عرفته عموم البلاد العربية في السنوات الخمس الأخيرة من حراك ممتد ونوعي هو كيف يمكن لبيروت ودمشق وغيرهما من عواصم العرب مغادرة مواقع الملك الناقص إلى الملك الكامل، الملك الذي يعني أن تكون السلطة ذات مشروع وأن تكون إفرازا للتعددية ومحققة للاستقرار؟
قد نختلف في تسمية هذا الحراك الهائل بين اعتباره ثورة أو انتفاضة أو تمردا أو هيجة كما كان يحلو لبعض المؤرخين القدامى وصف بعض أحداث الخروج الكبرى عن طاعة الأمير أو السلطان. الأولى بالعناية أمران:
- أننا لم نعد قادرين على الملك الناقص مهما حاولنا الحفاظ على الأنماط السابقة والشد إلى ما ارتبط بها من قيم الترويض والخبرة والتمركز والحرية.
- نحن نعيش حدثا تاريخيا عميقا دلالته الصميمية تتعين في أن مجتمعاتنا تغيرت بصورة جذرية بما يفرض مراجعة جادة لمسائل السياسة والحكم.
ذلك أن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت تغييرا اجتماعيا سريعا دفع بفئات ونخب جديدة إلى مجال الفعل السياسي والحضاري في حين بقيت المؤسسات السياسية والنخب الحاكمة تعيد إنتاج نفسها بصورة مذهلة.
لذلك فقيمة السياق الانتقالي الجديد لا تكمن في كونه قد يعيد صياغة الخارطة السياسية العربية العامة بشكل نوعي فحسب، بل في كونه حاملا لدلالات جمّة لم يقع إلى الآن رصد دقيق ومتكامل لأبعادها الفكرية والسياسية المؤذِنة بإمكانية انبثاقِ نسقِ معاييرَ جديدةٍ قيمية ودستورية سينبني وفقها النظام الاجتماعي السياسي العربي.
-7-
مؤدى هذا أن رهانات ستينيات القرن الماضي التي عبرت عنها بيروت - لبنان من جهة بمقولة "أقل ما يمكن من سلطة الدولة" ودمشق- سورية من جهة ثانية من خلال مقولة " الدولة ضامنة لاستقرار المجتمع" استنفدت أغراضها. منطلق الرهانات الجديدة يتمثل في توق لا مردّ له للانعتاق من إطار الدولة القائمة على احتواء المجتمع والتسلط على الفرد وحقوقه الأساسية إلى نظام مغاير تقوم الدولة فيه على التعايش المتوازن مع المجتمع والشخصية المفردة ضمن سياق حضاري معولم. ما يرجح هذا التوجه الحضاري مؤشرات ثلاثة:
- ما شهدته أقطار عربية عديدة من تحولات ليس ناجما عن أوضاع محلية اجتماعية ـ سياسية فحسب بل يتنزل بالخصوصيات المحلية ضمن حراك تاريخي إنساني مُستَحضـِرٍ لاحتياجات تتجاوز المجال القطري الخاص.
- إعادة الاعتبار لقدرات المجتمعات العربية التي انتقلت من كونها مجرد تجمع لجملة من الأفراد المُوحَّدين بقوة الدولة وعنفها، لتصبح تعبيرا عن قوة صاعدة ذات مصالح متمايزة ومرجعيات مختلفة مشكلة نسيجا من العلاقات وتواصلا ينمو ويغتني بالتنافس السلمي.
- بروز أولوية الخصوصيات المجتمعية-الثقافية في السياق العربي الجديد بتحول أنساقه المعيارية الفاعلة في التطور الاجتماعي بما يخرج الدولة من دائرة التجاذب السياسي والعقدي متيحا للمجتمع تمثل قدراته في المستويات الثقافية والسياسية والقانونية والإنسانية.
محصلة هذا التوجه الحضاري الجديد يمكن إيجازها في ضرورة تجاوز مركزية الدولة الحديثة وما انتهت إليه من استلاب المجتمع وتغييب الفرد. هو انخراط في رهان أرقى بمسارين متلازمين: تمكين الدولة من إعادة بسط سلطتها دون أن تعيد إنتاج آليات الهيمنة القديمة وتحوّل المجتمع إلى مركز واع بذاته وقادر على التفكير والإبداع والعمل.
(باحث وأكاديمي تونسي)