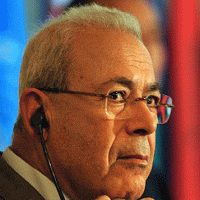17 أكتوبر 2024
بؤس العالم العربي وغيابه في معركة المصير السوري
ليست جامعة الدول العربية إطاراً حقيقياً للتعاون (فرانس برس)
لم يعد يخفى على أحدٍ أن الحرب التي تدور رحاها في سورية منذ ست سنوات تحوّلت، من صراع داخل سورية على تغيير قواعد الحكم ونظام السيطرة السياسية إلى حربٍ على سورية لتقرير مصير الهيمنة الإقليمية، وأن السمة الأبرز لهذه الحرب هو الغياب الكبير للعالم العربي، وأن المستهدف الأول في هذا الصراع المتعدّد الأطراف والأبعاد هو المكانة الاستراتيجية والسياسية والثقافية والدينية التي احتلها العرب، في ما يمكن أن نسميه، تجاوزاً، شبه النظام الإقليمي الذي ولد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ومن وراء ذلك استقرار المنطقة العربية وأمنها ومواقعها الدولية وتحالفاتها العالمية. ومنذ الآن، لا يكاد المرء يرى على هذه الأرض السورية التي كانت قلب العروبة النابض، عن حق أكثر من قرن، سوى آثار الاحتلالات الأجنبية والمليشيات الدولية والإقليمية، تزرع الموت والدمار، بينما لا يكف دور العرب فيها على التراجع، على الرغم من أن الدول العربية التي انخرطت فيها مستمرة في تقديم الدعم والتضحيات الكبيرة منذ سنوات.
كيف يمكن أن نفهم هذا المآل الحزين للدور العربي؟ وهل هناك بصيص أمل في أن يستنهض العرب للمشاركة في تقرير مصائرهم الوطنية والجماعية؟ هذا ما يسعى هذا المقال إلى إثارته، وتقديم بعض عناصر الإجابة عنه.
إفلاس العالم العربي
ارتكز الموقع المتميز والمهيمن الذي احتله العالم العربي في العقود السابقة الطويلة، والمستهدف اليوم من الدول الإقليمية، وربما العالمية، بعد أكثر من 70عاماً على ولادة جامعة الدول العربية، على عدة عناصر قوة: الأول نهاية الإمبرطورية العثمانية التي كانت القوة الرئيسية المسيطرة في المنطقة خمسة قرون متتالية، وانسحاب تركيا الكمالية من المنطقة، وتوجهها نحو الغرب، وبالتالي، نشوء فراغ جيواستراتيجي لم يكن أحد يستطيع ملأه في المنطقة سوى العرب، وهذا ما دفع الغرب إلى التعاون لإنشاء جامعة الدول العربية التي ضمت 22 دولة، وهي المنظمة الإقليمية الوحيدة فيها. والثاني الوزن الديمغرافي الطاغي للناطقين بالعربية في الإقليم، والثالث مركزية الثقافة العربية في تاريخ شعوب المنطقة، لما لها من وشائج وقرابة مع الإسلام ونصوصه وتاريخه، والرابع الدور الطليعي الذي لعبته الشعوب العربية في الصراع ضد الهيمنة الاستعمارية خلال القرن العشرين بأكمله، والذي استمر، في ما بعد، في شكل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة سياساته العدوانية والاستيطانية، والخامس الثروة النفطية التي حولت بلدان الخليج إلى أكبر مورّد لتصدير الطاقة في العالم، ودفع إلى شمولها بنوعٍ من الحماية الغربية، والأميركية بشكل خاص، ما جعلها في منأى عن المطامع الإقليمية الأخرى.
واضح لأي مراقب أن هذه العناصر لم تعد موجودة اليوم، أو أن أثرها ضعُف إلى حد كبير، بل أصبح بعضها عبئاً على العرب، بدل أن يكون رصيداً لهم في صراعهم للاحتفاظ بمكانتهم ودورهم الإقليمي ومصالح شعوبهم، فقد أدى فشلهم في تطوير جامعة الدول العربية، لتكون إطارا حقيقيا للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ومن ثم قوة قائدة في السياسات الإقليمية، إلى إحداث فراغٍ جيوستراتيجي كبير دفع إلى صعود قوى إقليمية جديدة، عازمة على لعب دور رئيسي، بل على فرض أجندتها على العرب أنفسهم، وإلحاقهم بمشروعها، سواء كان مشروعاً امبرطورياً عسكرياً شبه استعماري في طهران، أو مشروعاً رأسماليا توسعياً واقتصادياً في أنقرة. بل إن التنازع بين هاتين القوتين على إلحاق العالم العربي بمشروعهما هو أحد أهم دوافع الحرب المستمرة منذ سنوات. ومن أجله تستخدم طهران كل أسلحتها العسكرية والسياسية والمذهبية، كما تستخدم تركيا كل مغريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح صدرها للعرب الذين تحولوا اليوم إلى أكبر سوقٍ مفتوحةٍ لأي قوة إقليمية اقتصادية صاعدة. أما الكتلة البشرية الكبرى التي يمثلها العرب، فقد تحوّلت، بسبب فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى عبء ثقيل تنوء بحمله الدول، بدل أن تمثل بالنسبة لها أكبر موردٍ لتعزيز مكانتها الإقليمية، وتمكينها من فرض الاحترام لحقوق شعوبها وإرادتها ومصالحها العليا. وكما نجحت أنقرة - اسطنبول في استقطاب آمال ملايين العرب من أبناء الطبقة الوسطى ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى التعاون مع تركيا، للخروج من الركود الاقتصادي وتحقيق مزيدٍ من التنمية والأرباح لمشاريعهم واستثماراتهم، نجحت طهران في استقطاب قطاعاتٍ واسعةٍ من الرأي العام العربي التي لاتزال تستبطن مشاعر العداء للسياسات الاستعمارية الغربية، وترفض التسليم بسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلي، وذلك بمقدار ما يبدي المسؤولون العرب قبولاً بالأمر الواقع، وتراجعاً ملحوظاً في الاستثمار في قضية فلسطين. وبانتزاعها إيران من محور التحالف الغربي الإسرائيلي الاستعماري، أدخلت الثورة الإيرانية الإسلامية لعام 1979 طهران في صميم الفضاء الجيوستراتيجي المشرقي، وفتحت لها على مصراعيها أبواب النفوذ والتدخل في شؤون العالم العربي، إن لم تمكّنها من مصادرة ورقة تمثيل الإسلام، وانتزاعها من يد العرب حماته التاريخيين، ومن استقطاب تعاطف مسلمين كثيرين في مواجهة نزعة العداء المتنامية في العالم ضد الإسلام والمسلمين، بما في ذلك داخل البلاد العربية نفسها. أما المركز المتفوق الذي كان يتمتع به العرب في سوق صادرات النفط، فلم يعد مصدراً لمزيدٍ من الحرص على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية، وإنما أصبح، بالعكس، سبباً في إسالة لعاب عدد متزايد من الدول الصناعية، بعد أن زال اهتمام الولايات المتحدة به، والاعتماد الكبير عليه.
هل يمكن إنقاذ الرهان العربي في سورية؟
هكذا، فقد العالم العربي، في أقل من نصف قرن، الجزء الأكبر من رصيده الحضاري والتاريخي. فبدل أن يعمل على تثمير موارده البشرية والاقتصادية والثقافية الهائلة الموروثة، ليكون فاعلاً قوياً في إقليمه والعالم، كما يليق بكتلةٍ تضم بضع مئات ملايين إنسان، قدم موارده ومصادر قوته جميعا هدية مجانية للآخرين: الجيوسياسية والديمغرافية والاقتصادية والثقافية والدينية. حتى أصبحت الدول الإقليمية تدّعي ملكيتها وتستخدمها لصالحها، تماماً كما تستخدم شباب العرب مرتزقةً تنظمهم في مليشيات وحشود شعبية وقبلية ومذهبية، لتحقيق أهدافها على حسابه. واكتفت نخبه الحاكمة والسائدة بهدر ما وقع في يدها منها، والاشتغال بمراكمة الثروات الشخصية، أو بالبحث عن آليات تعظيمها، حتى كادت السياسة تتحوّل إلى علم التفنن في تنمية الفساد ونهب المال العام، ومع انحسار معدلات التنمية في أقطار عديدة، في مقاسمة الشعوب لقمتها وحرمانها من الحد الأدنى من شروط البقاء.
وبمقدار ما خسر العالم العربي معركة التعاون الإقليمي من داخل جامعة الدول العربية وخارجها، وفي إثرها معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخفق في إيجاد حل للمسألة الاستعمارية - الإسرائيلية، وتخلى أو أجبر على التخلي عن القضية الفلسطينية، وظهر خواؤه من أي مشروع اقتصادي أو سياسي أو ثقافي محفز لأجياله الشابة ومعبئ لها، ظهر ضعفه وهشاشة بنياته، وفقد وزنه في موازين القوة الإقليمية والدولية. وبموازاة تنامي حجم المشكلات والإحباطات والحسابات المعلقة في بلدانه، لم يلبث العالم العربي أن تحول بؤرة ملتهبة من التوترات والنزاعات والصراعات المتقاطعة، وفي مقدمها الصراع على السلطة. وانشغلت نخبه، ولا تزال، بجمع ثرواتها وتحرير نفسها من أي مسؤولياتٍ أو التزاماتٍ، ضاربة عرض الحائط كل ما يجري من حولها. وها هو يكتشف اليوم تهافت بنيانه في مواجهة قوى إقليميةٍ صاعدة، عرفت كيف تستفيد من العقود الماضية، لتفرض نفسها على النظام الدولي، وتتعامل معه بندية، وتطمح إلى إلحاق العالم العربي، أو أجزاء أساسية منه، بمشروعاتها والتلاعب بتناقضاته، وربما تحطيمه وحدة ثقافية.
حاولت ثورات الربيع العربي أن ترد على هذا الوضع، لوقف التدهور واستئناف دورة التقدم التاريخي، لكن موجاتها الأولى تحطمت على جدار تحالف القوى المضادة الداخلية والعربية والإقليمية والدولية. وأدى تكسّرها هذا إلى تهاوي الأوضاع العربية، وتفاقم سقوط وزن العرب في موازين القوة الإقليمية والدولية. وهكذا، يجد العالم العربي نفسه اليوم محيداً وغائباً عن نفسه ومصالحه، في أكبر معركةٍ يتقرّر فيها مصيره. بل يبدو لي أن العالم العربي صار، اليوم، بعد انفجاره الأخير، أقلّ من أي فترةٍ سابقة، حقيقة واقعة. فلم يعد يمثل كياناً متماسكاً ومتضامناً يتمتع بالحد الأدنى من التفاعل والتعاون والتنسيق الضروري للقيام بأي عمل هادف ومتسق. وربما كان وضع جامعة الدول العربية التي تحولت إلى علبة بريدٍ، لتوجيه رسائل إلى لا مكان هو أفضل تعبير أو تجسيد لحقيقة هذا الوجود الهلامي الهش. هناك نخب عربية، لكل منها قيادتها وتوجهاتها وخياراتها. لكن، بالتأكيد ليس هناك اليوم للأسف عالم عربي.
لا يعني هذا بالتاكيد أنه لن يكون هناك عالم عربي في القريب أو المستقبل، أو أن حقيقة الوجود العربي، كهوية وثقافة وديناميكية سياسية وحضارية، سوف تغيب عن الوجود، لكنه يعني أن هذه الحقيقة وتلك الهوية والثقافة والديناميكية لن تظهر قبل أن يشفى من مرضه، ويتجاوز الأزمة الوجودية التي تعصف به، والتي تجعل من حكوماته ودوله جداراً يحول دون تحقيق مطامح شعوبه وتطلعاتها وهويتها ووجودها. وعندما نفكّر بالدول العربية، كل على حدة، نكاد لا نعثر على نقطة مضيئة واحدة، نرتكز عليها أو يمكن ان نراهن عليها، من أجل تفعيل آليات التضامن والتعاون بينها، ودفعها إلى الخروج من حالة الفريسة المستسلمة لمصيرها، بانتظار ما يقرّره لها الآخرون. وباستثناء الأقطار الخليجية القليلة المنخرطة في الحرب السورية والإقليمية عامة، لا يكاد يصدر عن معظم بلدان هذا العالم العربي أي حركةٍ تشير إلى إدراكها أهمية العمل المشترك، وتنسيق الجهود والسياسات، بل إلى اهتمامها الجدّي بما يجري. وحتى جامعة الدول العربية التي حاولت أن تلعب دوراً نشطا في بداية الثورة السورية تبدو الآن وقد قبلت تهميشها وسلمت، كما فعلت معظم الدول الأعضاء فيها، قرارها للدول الأجنبية.
هكذا يبدو العالم العربي الذي يشكل أكبر كتلة بشرية في ما اعترف على تسميته الشرق الأوسط، فاقداً أي دور في المعركة الدولية الكبرى التي تجري على أراضيه، من أجل إعادة ترتيب التوازنات وتوزيع المصالح، وربما تغيير الخرائط الجيوسياسية، وصوغ الأجندة السياسية للمنطقة المشرقية لأجيال عديدة قادمة. ويجد العرب أنفسهم أكثر فأكثر اليوم مجبرين على القبول بالمشاركة في معارك مفروضة عليهم في إقليمهم، والانصياع لقراراتٍ لا تخدم مصالح دولهم وشعوبهم، والتنازل عن دورهم والكثير من حقوقهم.
ومع ذلك، لم تنته معركة تحرير العالم العربي وإعاده بنائه، بل هي، بالكاد، قد بدأت. لكن، إذا كان لا يزال هناك أمل في كسبها، فهو معقودٌ على الشعوب والرأي العام، وبشكل خاص على جيل الشباب الذي حرم من ماضيه، وهو مهدّد بالحرمان من مستقبله أيضا. أما الدول والنخب الحاكمة فأغلبيتها تتخبط اليوم، ولزمن طويل، في أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المتفاقمة، بينما هي مضطرّة للزج بنفسها، من دون حمايةٍ ولا شراكةٍ ولا حليف، في جحيم المواجهات الضارية، للدفاع عن وجودها، وحيدةً، من دون حمايةٍ ولا صداقة ولا حلفاء.
كيف يمكن أن نفهم هذا المآل الحزين للدور العربي؟ وهل هناك بصيص أمل في أن يستنهض العرب للمشاركة في تقرير مصائرهم الوطنية والجماعية؟ هذا ما يسعى هذا المقال إلى إثارته، وتقديم بعض عناصر الإجابة عنه.
إفلاس العالم العربي
ارتكز الموقع المتميز والمهيمن الذي احتله العالم العربي في العقود السابقة الطويلة، والمستهدف اليوم من الدول الإقليمية، وربما العالمية، بعد أكثر من 70عاماً على ولادة جامعة الدول العربية، على عدة عناصر قوة: الأول نهاية الإمبرطورية العثمانية التي كانت القوة الرئيسية المسيطرة في المنطقة خمسة قرون متتالية، وانسحاب تركيا الكمالية من المنطقة، وتوجهها نحو الغرب، وبالتالي، نشوء فراغ جيواستراتيجي لم يكن أحد يستطيع ملأه في المنطقة سوى العرب، وهذا ما دفع الغرب إلى التعاون لإنشاء جامعة الدول العربية التي ضمت 22 دولة، وهي المنظمة الإقليمية الوحيدة فيها. والثاني الوزن الديمغرافي الطاغي للناطقين بالعربية في الإقليم، والثالث مركزية الثقافة العربية في تاريخ شعوب المنطقة، لما لها من وشائج وقرابة مع الإسلام ونصوصه وتاريخه، والرابع الدور الطليعي الذي لعبته الشعوب العربية في الصراع ضد الهيمنة الاستعمارية خلال القرن العشرين بأكمله، والذي استمر، في ما بعد، في شكل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ومقاومة سياساته العدوانية والاستيطانية، والخامس الثروة النفطية التي حولت بلدان الخليج إلى أكبر مورّد لتصدير الطاقة في العالم، ودفع إلى شمولها بنوعٍ من الحماية الغربية، والأميركية بشكل خاص، ما جعلها في منأى عن المطامع الإقليمية الأخرى.
واضح لأي مراقب أن هذه العناصر لم تعد موجودة اليوم، أو أن أثرها ضعُف إلى حد كبير، بل أصبح بعضها عبئاً على العرب، بدل أن يكون رصيداً لهم في صراعهم للاحتفاظ بمكانتهم ودورهم الإقليمي ومصالح شعوبهم، فقد أدى فشلهم في تطوير جامعة الدول العربية، لتكون إطارا حقيقيا للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ومن ثم قوة قائدة في السياسات الإقليمية، إلى إحداث فراغٍ جيوستراتيجي كبير دفع إلى صعود قوى إقليمية جديدة، عازمة على لعب دور رئيسي، بل على فرض أجندتها على العرب أنفسهم، وإلحاقهم بمشروعها، سواء كان مشروعاً امبرطورياً عسكرياً شبه استعماري في طهران، أو مشروعاً رأسماليا توسعياً واقتصادياً في أنقرة. بل إن التنازع بين هاتين القوتين على إلحاق العالم العربي بمشروعهما هو أحد أهم دوافع الحرب المستمرة منذ سنوات. ومن أجله تستخدم طهران كل أسلحتها العسكرية والسياسية والمذهبية، كما تستخدم تركيا كل مغريات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتفتح صدرها للعرب الذين تحولوا اليوم إلى أكبر سوقٍ مفتوحةٍ لأي قوة إقليمية اقتصادية صاعدة. أما الكتلة البشرية الكبرى التي يمثلها العرب، فقد تحوّلت، بسبب فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى عبء ثقيل تنوء بحمله الدول، بدل أن تمثل بالنسبة لها أكبر موردٍ لتعزيز مكانتها الإقليمية، وتمكينها من فرض الاحترام لحقوق شعوبها وإرادتها ومصالحها العليا. وكما نجحت أنقرة - اسطنبول في استقطاب آمال ملايين العرب من أبناء الطبقة الوسطى ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى التعاون مع تركيا، للخروج من الركود الاقتصادي وتحقيق مزيدٍ من التنمية والأرباح لمشاريعهم واستثماراتهم، نجحت طهران في استقطاب قطاعاتٍ واسعةٍ من الرأي العام العربي التي لاتزال تستبطن مشاعر العداء للسياسات الاستعمارية الغربية، وترفض التسليم بسياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلي، وذلك بمقدار ما يبدي المسؤولون العرب قبولاً بالأمر الواقع، وتراجعاً ملحوظاً في الاستثمار في قضية فلسطين. وبانتزاعها إيران من محور التحالف الغربي الإسرائيلي الاستعماري، أدخلت الثورة الإيرانية الإسلامية لعام 1979 طهران في صميم الفضاء الجيوستراتيجي المشرقي، وفتحت لها على مصراعيها أبواب النفوذ والتدخل في شؤون العالم العربي، إن لم تمكّنها من مصادرة ورقة تمثيل الإسلام، وانتزاعها من يد العرب حماته التاريخيين، ومن استقطاب تعاطف مسلمين كثيرين في مواجهة نزعة العداء المتنامية في العالم ضد الإسلام والمسلمين، بما في ذلك داخل البلاد العربية نفسها. أما المركز المتفوق الذي كان يتمتع به العرب في سوق صادرات النفط، فلم يعد مصدراً لمزيدٍ من الحرص على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة العربية، وإنما أصبح، بالعكس، سبباً في إسالة لعاب عدد متزايد من الدول الصناعية، بعد أن زال اهتمام الولايات المتحدة به، والاعتماد الكبير عليه.
هل يمكن إنقاذ الرهان العربي في سورية؟
هكذا، فقد العالم العربي، في أقل من نصف قرن، الجزء الأكبر من رصيده الحضاري والتاريخي. فبدل أن يعمل على تثمير موارده البشرية والاقتصادية والثقافية الهائلة الموروثة، ليكون فاعلاً قوياً في إقليمه والعالم، كما يليق بكتلةٍ تضم بضع مئات ملايين إنسان، قدم موارده ومصادر قوته جميعا هدية مجانية للآخرين: الجيوسياسية والديمغرافية والاقتصادية والثقافية والدينية. حتى أصبحت الدول الإقليمية تدّعي ملكيتها وتستخدمها لصالحها، تماماً كما تستخدم شباب العرب مرتزقةً تنظمهم في مليشيات وحشود شعبية وقبلية ومذهبية، لتحقيق أهدافها على حسابه. واكتفت نخبه الحاكمة والسائدة بهدر ما وقع في يدها منها، والاشتغال بمراكمة الثروات الشخصية، أو بالبحث عن آليات تعظيمها، حتى كادت السياسة تتحوّل إلى علم التفنن في تنمية الفساد ونهب المال العام، ومع انحسار معدلات التنمية في أقطار عديدة، في مقاسمة الشعوب لقمتها وحرمانها من الحد الأدنى من شروط البقاء.
وبمقدار ما خسر العالم العربي معركة التعاون الإقليمي من داخل جامعة الدول العربية وخارجها، وفي إثرها معركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأخفق في إيجاد حل للمسألة الاستعمارية - الإسرائيلية، وتخلى أو أجبر على التخلي عن القضية الفلسطينية، وظهر خواؤه من أي مشروع اقتصادي أو سياسي أو ثقافي محفز لأجياله الشابة ومعبئ لها، ظهر ضعفه وهشاشة بنياته، وفقد وزنه في موازين القوة الإقليمية والدولية. وبموازاة تنامي حجم المشكلات والإحباطات والحسابات المعلقة في بلدانه، لم يلبث العالم العربي أن تحول بؤرة ملتهبة من التوترات والنزاعات والصراعات المتقاطعة، وفي مقدمها الصراع على السلطة. وانشغلت نخبه، ولا تزال، بجمع ثرواتها وتحرير نفسها من أي مسؤولياتٍ أو التزاماتٍ، ضاربة عرض الحائط كل ما يجري من حولها. وها هو يكتشف اليوم تهافت بنيانه في مواجهة قوى إقليميةٍ صاعدة، عرفت كيف تستفيد من العقود الماضية، لتفرض نفسها على النظام الدولي، وتتعامل معه بندية، وتطمح إلى إلحاق العالم العربي، أو أجزاء أساسية منه، بمشروعاتها والتلاعب بتناقضاته، وربما تحطيمه وحدة ثقافية.
حاولت ثورات الربيع العربي أن ترد على هذا الوضع، لوقف التدهور واستئناف دورة التقدم التاريخي، لكن موجاتها الأولى تحطمت على جدار تحالف القوى المضادة الداخلية والعربية والإقليمية والدولية. وأدى تكسّرها هذا إلى تهاوي الأوضاع العربية، وتفاقم سقوط وزن العرب في موازين القوة الإقليمية والدولية. وهكذا، يجد العالم العربي نفسه اليوم محيداً وغائباً عن نفسه ومصالحه، في أكبر معركةٍ يتقرّر فيها مصيره. بل يبدو لي أن العالم العربي صار، اليوم، بعد انفجاره الأخير، أقلّ من أي فترةٍ سابقة، حقيقة واقعة. فلم يعد يمثل كياناً متماسكاً ومتضامناً يتمتع بالحد الأدنى من التفاعل والتعاون والتنسيق الضروري للقيام بأي عمل هادف ومتسق. وربما كان وضع جامعة الدول العربية التي تحولت إلى علبة بريدٍ، لتوجيه رسائل إلى لا مكان هو أفضل تعبير أو تجسيد لحقيقة هذا الوجود الهلامي الهش. هناك نخب عربية، لكل منها قيادتها وتوجهاتها وخياراتها. لكن، بالتأكيد ليس هناك اليوم للأسف عالم عربي.
لا يعني هذا بالتاكيد أنه لن يكون هناك عالم عربي في القريب أو المستقبل، أو أن حقيقة الوجود العربي، كهوية وثقافة وديناميكية سياسية وحضارية، سوف تغيب عن الوجود، لكنه يعني أن هذه الحقيقة وتلك الهوية والثقافة والديناميكية لن تظهر قبل أن يشفى من مرضه، ويتجاوز الأزمة الوجودية التي تعصف به، والتي تجعل من حكوماته ودوله جداراً يحول دون تحقيق مطامح شعوبه وتطلعاتها وهويتها ووجودها. وعندما نفكّر بالدول العربية، كل على حدة، نكاد لا نعثر على نقطة مضيئة واحدة، نرتكز عليها أو يمكن ان نراهن عليها، من أجل تفعيل آليات التضامن والتعاون بينها، ودفعها إلى الخروج من حالة الفريسة المستسلمة لمصيرها، بانتظار ما يقرّره لها الآخرون. وباستثناء الأقطار الخليجية القليلة المنخرطة في الحرب السورية والإقليمية عامة، لا يكاد يصدر عن معظم بلدان هذا العالم العربي أي حركةٍ تشير إلى إدراكها أهمية العمل المشترك، وتنسيق الجهود والسياسات، بل إلى اهتمامها الجدّي بما يجري. وحتى جامعة الدول العربية التي حاولت أن تلعب دوراً نشطا في بداية الثورة السورية تبدو الآن وقد قبلت تهميشها وسلمت، كما فعلت معظم الدول الأعضاء فيها، قرارها للدول الأجنبية.
هكذا يبدو العالم العربي الذي يشكل أكبر كتلة بشرية في ما اعترف على تسميته الشرق الأوسط، فاقداً أي دور في المعركة الدولية الكبرى التي تجري على أراضيه، من أجل إعادة ترتيب التوازنات وتوزيع المصالح، وربما تغيير الخرائط الجيوسياسية، وصوغ الأجندة السياسية للمنطقة المشرقية لأجيال عديدة قادمة. ويجد العرب أنفسهم أكثر فأكثر اليوم مجبرين على القبول بالمشاركة في معارك مفروضة عليهم في إقليمهم، والانصياع لقراراتٍ لا تخدم مصالح دولهم وشعوبهم، والتنازل عن دورهم والكثير من حقوقهم.
ومع ذلك، لم تنته معركة تحرير العالم العربي وإعاده بنائه، بل هي، بالكاد، قد بدأت. لكن، إذا كان لا يزال هناك أمل في كسبها، فهو معقودٌ على الشعوب والرأي العام، وبشكل خاص على جيل الشباب الذي حرم من ماضيه، وهو مهدّد بالحرمان من مستقبله أيضا. أما الدول والنخب الحاكمة فأغلبيتها تتخبط اليوم، ولزمن طويل، في أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية المتفاقمة، بينما هي مضطرّة للزج بنفسها، من دون حمايةٍ ولا شراكةٍ ولا حليف، في جحيم المواجهات الضارية، للدفاع عن وجودها، وحيدةً، من دون حمايةٍ ولا صداقة ولا حلفاء.