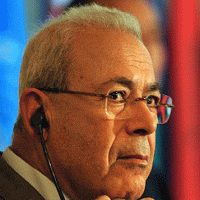11 نوفمبر 2024
سورية في قلب الحرب الحضارية... الخفية
آلاف السوريين ينتفضون في حماة ضد النظام (29 يوليو/2011/أ.ف.ب)
ما يجري في المشرق العربي، وفي سورية خصوصاً، من استهتارٍ مستمرٍ بالقيم والأعراف والمواثيق الإنسانية، وتهديمٍ منقطع النظير للمدن التاريخية على رؤوس سكّانها، وفرض حصار الجوع وتشريد ملايين البشر، مع بقاء المجتمع الدولي ومنظماته القانونية والإنسانية مكتوفة اليدين، أو عاجزةً عن القيام بأي عملٍ لوقف المجازر الشنيعة، ودفع الأطراف نحو حل سياسي، في وقتٍ تحتفظ فيه أكبرها بقواعد عسكرية وقوات وأساطيل جوية جاهزة للتدخّل، وتتدخل بالفعل في أكثر من مكان. لكن، ليس حيث ينبغي التدخل، ما يجري يشكّل حدثاً غير مسبوق في تاريخ العالم الحديث. وهو حدث لا يمكن من أجل تفسيره الاقتصار على أدوات التحليل التقليدية للصراعات السياسية أو للثورات الاجتماعية، أو حتى لحروب التوسع الإقليمي والنفوذ الدولي. ويحتاج فهمه، في نظري، إلى إطار نظري أشمل، يتعلق بتفسير أو تحليل ديناميات نشوء المدنيات المختلفة وصراعها وتوسعها واندثارها.
أفول الشرق
والمقصود، في حالتنا، المواجهة التاريخية المستمرة منذ قرون، بين عالم الغرب الصاعد وعالم المتوسط المشرقي الذي أفل نجمه، بعد أن تربّع على قمة الهيمنة القارية قروناً طويلة سابقة. وليس المقصود بالغرب، هنا، منطقة جغرافية، وإنما دائرة جيوسياسية، تطور داخله عبر الزمن نمط حياة وأسلوب في النظر والعمل والإدارة والحكم والإنتاج، يشمل بلاداً وشعوباً وثقافاتٍ عديدة. وهذا ما نعنيه أيضاً بالشرق الذي يشمل دائرة جيوسياسية متوسطية، تبلورت فيها عبر العصور علاقات خاصة، ونمط تفكير وحياة تناقلتها امبرطوريات تاريخية عديدة، وشكلت هويةً مدنيةً تتجاوز التنوعات الثقافية، هي ما نسميها المدنية الشرقية المتوسطية، والتي ورثتها آخر الامبرطوريات الإسلامية فاحتفظت بتسميتها.
كلنا نعرف أن أوروبا، قبل أن تخرج من بربريتها، وتقيم صرح حضارةٍ لامعة غيرت معالم الحضارة الإنسانية، وتتحول إلى منارة للمجتمعات الأخرى، عاشت قروناً طويلةً تحت الهيمنة الفكرية والسياسية والعسكرية للامبرطوريات التي نشأت وترعرعت في المشرق، الذي شكّل منذ أقدم العصور مهداً لحضارةٍ كونية، ومرجعاً لمدنيةٍ عظيمةٍ، تعدّدت منابعها الثقافية والسياسية، وكوّنت، مع الزمن، دائرةً مشتركةً لتداول الأفكار وتبادل السلع والبضائع، قرّبت بين توجهات أفرادها وأنماط سلوكهم وتفكيرهم، في ما وراء تعدّد الأديان والثقافات والدول أيضاً. وصبّت في هذه الدائرة الجهود التاريخية لشعوب بلاد الرافدين، ووادي النيل واليونان والرومان والسوريين القدماء وسكان فارس واليمن والجزيرة العربية والكرد، وأخيراً الترك العثمانيين الذين أنشأوا واحدةً من أكبر الامبرطوريات، متعدّدة الأقوام والمذاهب والثقافات والأديان، عابرة للقارات، بسطت سيطرتها على المتوسط وهيمنتها القارية قرابة خمسة قرون.
وفي الصراع ضد هذه المدنية "الإسلامية"، وريثة امبرطوريات المشرق التي امتدّ نفوذها من إسبانيا إلى الهند والصين، وجمعت بين قومياتٍ وثقافاتٍ وأديانٍ ونحلٍ لا تُحصى، ولدت أوروبا الحديثة، وتشكّلت في مواكبتها الديناميات الفكرية والسياسية والجيوسياسية الجديدة التي قامت عليها المدنية الغربية التي انتقل إليها مركز إنتاج الحضارة وازدهارها، العلمي والمادّي، بشكلٍ مضطرد منذ القرن السابع عشر الميلادي. ولم يُتح لهذه المدنية الغربية الجديدة أن تستقرّ وتضمن تفوقها وهيمنتها العالمية إلا على أشلاء المدنيات السابقة، التي أسدل عليها سيف الحركة الاستعمارية الستار وحطم توازناتها، في الصين والهند وإفريقيا. وكانت معركتها الأقسى والأطول تلك التي خاضتها ضد المدنية الإسلامية لتفكيك مراكز هيمنتها العالمية : في الأندلس الأوروبية، وفي آسيا المغولية، وأخيراً ضد الدولة العثمانية التي بقيت تشكّل قوة عسكرية ضاربة في أوروبا نفسها حتى القرن الثامن عشر. فقد تم طرد المسلمين العرب والبربر طرداً كاملاً من إسبانيا وقتل من قتل وأجبر من بقي منهم على الانسلاخ عن جلده ودينه منذ عام 1492. وفي آسيا، حلت الملكة فيكتوريا إمبرطورةً على الهند محل السلطان محمد بهادر شاه عام1857. وفي المتوسط، دامت معركة تفكيك الإمبرطورية العثمانية وتحطيمها القرن التاسع عشر بأكمله، قبل توزع أملاكها بين الدول الأوروبية.
وعلى الرغم من أن مخطط تقسيم تركيا لم ينجح بسبب شراسة المقاومة الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال، إلا أن الحرب الغربية لا تزال مستمرة، ليس في سبيل السيطرة على موارد المنطقة المادية واللامادية، والتحكم بطرق المواصلات الدولية التي تحتل موقع القلب منها فحسب، وإنما، أكثر من ذلك، بهدف منعها من التعاون وتوحيد جهودها أو إعادة تجميع أطراف الدائرة الجيوسياسية المتوسطية ومخاطر بناء قوة استراتيجية، عسكرية وسياسية وأيديولوجية، يمكن أن تهدّد مستقبلاً الغرب، أو تخلّ بالتوازنات الجيوستراتيجية القائمة، أو تعمل على إعادة تدوير الموارد الحضارية، أو تغير في معادلات القوة الشاملة على أعتاب المواجهة الحاسمة للغرب مع المدنية الآسيوية الصاعدة. وفي اعتقادي، من الصعب تفسير مجموعة كبيرة من التطورات التي شهدتها هذه المنطقة، والمسار الذي اتخذته نزاعات سياسية وإقليمية عديدة، وحيز الهمجية والتوحش والعنف المسموح فيه، وغياب أي جهودٍ دوليةٍ جديةٍ لدعم الحلول السياسية، خارج سياق هذه الحرب أو المواجهة الكبرى، أو بتجاهل إكراهاتها. وأقرب مثال على ذلك المصير الذي آلت إليه ثورات الربيع العربي التي شكّلت الحدث الأبرز في تاريخ تطور شعوب المنطقة، وفي مقدمها مصير الثورة السورية النازفة منذ أكثر من خمس سنوات.
إجهاض الثورات وتحطيم الدول وتقسيم الشعوب
هكذا، لم ينشئ الغرب إسرائيل، ويجعل منها قوة إقليمية رئيسية، وربما الأولى اليوم في المنطقة، حباً باليهود أو شفقة عليهم، أو تكفيراً عن المحارق النازية وسياساته اللاسامية، ولا أطلق يد السفاح بشار الأسد في شعبه، يستبيح دماءه، ويجوّع أطفاله، ويدمر حضارته، ويهجّر الملايين من أبنائه، ولم يغضّ النظر عن استخدامه الأسلحة الكيماوية وتلك المحرّمة دولياً لتدمير المدن وترويع المدنيين وإفراغ البلاد من أكثر سكانها ضماناً لحقوق الأقليات، علويين ومسيحيين ودروزاً وإسماعيليين وسريان، ولم يزوّد قوات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "البايادي" (الكردي) بأفضل الأسلحة، ويكرس أسطوله الحربي لدعم تقدمها حبّاً بالأكراد أو تعويضاً لهم عن معاناتهم التاريخية.
وبالمثل، لم يسمح لطهران الخمينية أن ترسل حرسها الثوري ومليشياتها الطائفية لتحكم العراق وتتحكّم به، وتحوله إلى خرابٍ ومرتع للحروب الطائفية وحروب التطهير العرقية والمذهبية، وهو أغنى دول المنطقة وأكثرها ثروةً، ولا غض النظر عن عبور مليشياتها المذهبية المتوحشة نهر الفرات وبادية الشام حتى حدود المتوسط لدعم نظام الأسد المسخ الذي لا يتردّد في قتل شعبه وتشريده للاحتفاظ بالحكم، حباً بالشيعة أو تأثراً باستشهاد الحسين. تماماً كما أن غض النظر عن عمليات الإبادة الجماعية المنظمة في أكبر المدن السورية، وتشريد ملايين السوريين والعراقيين، وإطلاق يد المنظمات الإرهابية الدولية في المناطق السورية والعراقية لم يأت كرهاً بالسنة، أو انتقاماً منهم. فليس لدين الضحايا ومذاهبهم أي قيمةٍ في ذاتها بمنظور هذه المواجهة، وإنما ينبع استهداف مجتمعاتهم وتفتيتها لما يمثلونه، بامتدادهم على اتساع الرقعة المتوسطية، وهيمنتهم العددية، من إمكانات واحتمالات لإعادة حبال التواصل والتفاعل وإعادة التجميع والتوحيد للشتات المتوسطي الراهن، كما أظهرت ذلك خلال العقود الطويلة الماضية حركات الصراع من أجل وحدة المنطقة، سواء أتت في شكل وحدة قومية أو دينية.
كل هذه الخطط جزء من سياسة الحفاظ على الوضع الاستثنائي الهامشي للمشرق، ومنع نشوء قوة استراتيجية في المتوسط تهدّد الأمن الأوروبي الغربي، وتعدل في التوازنات ودورات التبادل، وتعيد توجيه الموارد والمكتسبات الحضارية وتوزيعها. والسبيل الرئيسي لتحقيق ذلك هو إبقاؤه تحت المراقبة، وفي قفصٍ من حديد، وإجهاض حركاته وتحييد شعوبه والقضاء، بشكل منتظم، على أي قوةٍ ناشئةٍ، من المحتمل أن تتحوّل إلى مركز قوة استراتيجية. وهذا الضغط الاستراتيجي الهائل والمستمر عقوداً على مجتمعات المشرق، وحرمانها من أي فرصةٍ للانعتاق والتقدّم هو العامل الأكبر والأشمل، في دفعها نحو الاضطراب وعدم الاستقرار بما يثيره من التهاباتٍ وتوتراتٍ دائمةٍ واختلالاتٍ وتأزماتٍ، تقوّض أي أسسٍ ثابتةٍ وسليمةٍ لاستقرار الدولة والحياة السياسية والأمنية والثقافية، وتحول حياة شعوبه وأفراده إلى سلسلةٍ لا تنقطع من الأزمات والنزاعات.
وما من شك في أنه، بنتيجة هذه المواجهة التاريخية التي خسرتها، تحوّلت منطقة المشرق التي كانت مقر مدنيةٍ مزدهرةٍ وجامعة، وأحد مراكز الحضارة الرئيسية في العالم، قروناً طويلة، إلى مسرحٍ للخراب والدمار والفوضى. وهي لا تزال تتراجع باستمرار، وتخسر على كل الأصعدة، الداخلية والخارجية، وتكاد لا تحقق أي إنجاز، حتى فقدت شعوبها أو هي في طريقها إلى أن تفقد جميع آمالها، وتغرق في اليأس والإحباط، بينما تحولت أوروبا المجاورة التي كانت تسبح في فوضى الصراعات الدموية الدينية والقومية حتى منتصف القرن الماضي إلى مركز الثقل الرئيسي، وموطن المدنية ومنتج الحضارة.
في مواجهة سياسات العزل والتهميش والحصار
منذ تبني الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سياسة النأي بالنفس عن مشكلات المشرق والشرق الأوسط، بعد فشله المدوّي في إقناع إسرائيل بمشروع حل الدولتين الذي وعد به حلفاءه العرب، ولد اقتناع واسع في الرأي العام الدولي، الرسمي والشعبي، أن المشرق منطقةُ زلازل واضطرابات وعدم استقرار، لا أمل في علاجها. ومن الأفضل تركها لمصيرها. والحقيقة عكس ذلك تماماً، فليس هناك منطقة دمرت تدخلات الغرب أسس استقرارها وتوازناتها النفسية والدينية والسياسية والأمنية في العصر الراهن، وقضى تلاعب المؤسسات والأجهزة الأمنية الغربية بمؤسساتها وقياداتها على مستقبل تنميتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، كما حصل لهذه المنطقة المنكوبة من العالم، حتى أصبحت تحتكر اليوم أغلب الجهد الدولي الأمني والإغاثي والدبلوماسي.
وما يجري في المنطقة، اليوم، بعكس الادعاء السائد، هو أكبر تدخل دولي مشترك، حصل في بلد واحد وفي الوقت نفسه، في أي عصر، حيث تشارك 62 دولة رسمياً، بجيوشها وأساطيلها، بالإضافة إلى عشرات، وربما مئات، المليشيات من كل المذاهب والجنسيات، في عملية إخصاء استراتيجي طويل المدى، يهدف إلى استبدال الدولة والأمة والثقافة والمدنية والحضارة والفكرة الإنسانية، بزعماء مليشيات ومجالس عشائر وحشود شعبية وطوائف وقوميات ميكروسكوبية ومظالم وانتماءات وولاءات وعصبيات وعداوات أبدية. ولا يتردّد التحالف الدولي الذي سلم قيادته للثلاثي، الأميركي الروسي الإسرائيلي، غير المسبوق في العصر الحديث خارج المنطقة، في سبيل تحقيق هدفه من استخدام نار الإرهاب الكاوية التي تحولت منظماتها في أشهر قليلة، وبقدرة قادر، إلى جيوش وممالك وإمارات جبارة، تهدد المنطقة والعالم. وللهدف نفسه، يصر القادة الغربيون، كما يصر الإعلام على تسميتها بالإسلامية، حتى صار كثيرون يعتبرونها ممثلةً للمسلمين السنة عامة، وناطقة باسمهم.
وما من شك في أن اندلاع الثورات العربية في العقد الثاني من هذا القرن، ومشهد ملايين العرب المتجمعين في الساحات والمطالبين بحقوقهم، وفي مقدمها حقهم في المشاركة في القرار والحكم، قد قرع ناقوس الخطر بالنسبة لجميع القوى الخائفة من يقظة الشرق العربي. وكان القبول بمثل هذه المطالب يعني تلقائياً انهيار استراتيجية الغرب، للإبقاء على سيطرته الإقليمية، والتي كانت تعتمد، بشكل رئيسي، على تعاون النظم والنخب التابعة، وأحياناً العميلة. ولذلك، بعكس المظاهر، لم يتردّد الغرب السياسي، لحظةً، في اتخاذ قرار قيادة الثورة المضادّة لمواجهة خطر انتصار الشعوب، وعندما أبدى تفهماً وأظهر تأييده للثورة، كان هدفه الالتفاف عليها، واختراقها من الداخل، لإعادة توجيهها وضبطها. لكنه سرعان ما نظم عملية الانقضاض عليها، بالتحالف مع القوى التابعة له، وروح الانتهازية وغياب الثقة بالذات، وتغذية الأوهام عند كثيرين من أعضاء النخب المعارضة والمعارضات السياسية.
يتركّز الجهد العسكري والسياسي الغربي الراهن، من أجل إجهاض ما حققته المنطقة ومجتمعاتها من نمو في العقود الماضية، بعد حروب السبعينات، وإرجاعها قرناً إلى الوراء، كما وعد زعماء التدخل الأميركي في العراق سابقاً، على عدة أهداف: تحطيم الدولة المركزية الوطنية، أو تلك التي فشل في السيطرة عليها والتحكم بها من خلال النخب الموالية والتابعة له، وإطلاق دينامية حرب دينية شيعية سنية، ستشل المنطقة عقوداً طويلة مقبلة، وتقطع عليها، بسبب العداوات والأحقاد، أي أمل في استعادة وحدتها، والتعاون في ما بينها للوصول إلى بناء دائرة جيوسياسية واقتصادية وثقافية مستقلة ومستقرة وفاعلة، وفتح ملفات المنطقة القومية المعلقة، وفي مقدمها قضية القومية الكردية. لكن، ليس وحدها. وترميم النخبة التابعة التي فقدت سمعتها، وبان تهافتها، وإعادة الرهان على القوى الانقلابية العسكرية، والتعاون معها، وتقوية أجهزة القمع الاستخباراتية التقليدية، والتنسيق معها بشكل كامل.
في هذا السياق، يندرج أيضاً تشجيع الولايات المتحدة وحلفائها العراق، في التسعينات من القرن الماضي، على شنّ الحرب على إيران، بعد سقوط النظام الشاهنشاهي، لإطلاق دورة عنف وحروب إقليمية جديدة. وللغرض نفسه، صمم جورج بوش الابن وحلفاؤه التدخل العسكري في العراق عام 2003، لينهي وجود الدولة العراقية المركزية، ويرعى عملية تقسيم البلاد وتدمير وحدتها القومية والدينية ومؤسسات الدولة الحديثة، ويقضي على أي احتمالٍ لاستعادة العراق هويته، وولادة قوة استراتيجية وازنة فيه. وهو الغرض نفسه الذي أوحى للرئيس أوباما، ولحلفائه، بعدم التدخل لفرض الحلّ السياسي في سورية، والحيلولة دون تطوّر الصراع نحو الحرب الأهلية والحروب بالوكالة، وانتشار منظمات الإرهاب الدولية، وخطر إشعال حرب سنية شيعية إقليمية، تقضي على كل ما أنجزته المجتمعات خلال القرنين الماضيين، وتعيدها إلى القرون الوسطى. وأكبر دليل على ذلك إطلاق يد الروس والإيرانيين والأسد تقريباً من دون قيود أو حتى انتقاد، والتهاون في وقف الانتهاكات اللامسبوقة لمواثيق الحرب، وغضّ النظر عن تعميم سياسة التجويع والتشريد والقتل العشوائي، فالمقصود تمديد أجل الحرب إلى أن يقتنع السوريون، كما اقتنع العراقيون، بالطريقة نفسها، من قبل، باستحالة الحفاظ على دولتهم المركزية، ويقبلون التقسيم، على أسسٍ طائفيةٍ وإتنية، تحت غلالةٍ خادعةٍ من الفيدرالية الكاذبة. ولا يتردّد قادة روسيا، في حماسهم لانتزاع الزعامة في الحرب الحضارية ضد الإسلام والمسلمين، في الإعلان صراحةً عن استحالة القبول بهيمنةٍ سنيةٍ في سورية، وربط السلام فيها بتحقيق التوازن الطائفي. ما يعني، أحد أمرين: إما تعميم عمليات التهجير القسري للمسلمين حتى تقل نسبتهم على عدد السكان الكلي، أو تشجيع حروب التطهير المذهبي، حتى يتحقق رسم حدود آمنةٍ وقويةٍ للدول الجديدة التي تهدف، باسم حماية الأقليات الاتنية والطائفية، للحيلولة دون نشوء دول قوية.
وفي هذا السياق أيضاً، تصبّ مجموعة الأبحاث النظرية والإعلامية الغربية المتزايدة التي تريد أن تقنع العرب والمسلمين من سكان المنطقة بتناقض فكرة الدولة المركزية مع التقاليد والثقافة والبنية الاجتماعية العربية والهوية الإسلامية، وتشجعهم على رؤية الحل لمشكلاتهم السياسية في العودة إلى الدول الإتنية والطائفية الصغيرة، بدل الاستمرار في الكفاح من أجل دول مدنية ديمقراطية حرة. ومن الواضح أن مثل هذه الدول التي لم يعد لها أي حظٍ في البقاء في عالم اليوم بمواردها الذاتية، سوف تتحوّل إلى ذئابٍ على بعضها، لاحتكار الموارد المحدودة في المنطقة ووضع اليد عليها، كالنفط والغاز والماء، أو سوف تجد نفسها مضطرةً للعمل مباشرةً في خدمة الدول والاستراتيجيات الدولية الأمنية والهيمنية لتأمين مورد رزقها وحماية نفسها من الدول الأقوى القريبة والعدوة. ويجد هدف تحطيم الدولة المركزية، كما حصل في الحالة العراقية، هوىً خاصاً لدى إسرائيل التي تمثل، في معركة تقويض قدرة شعوب المنطقة على الاستقلال والتحرّر وبناء قوة استراتيجية تحفظ أمنها وحقوقها، قاعدة متقدمة عظيمة الأهمية، ورأس رمحٍ لا يعوّض بالنسبة لعموم الغرب. وتجد تل أبيب، في دورها الجديد والثمين هذا، فرصتها التاريخية لتطبيع وضعها الاستثنائي داخل هذه المدنية الغربية، والتعامل معها وداخلها كقوة مستقلة وند، بعد أن بقيت، عقوداً سابقة طويلة، عالة عليها.
التخبط في رمال متحركة
على الرغم من هذه الخسارة الاستراتيجية التاريخية التي منيت بها، والإخفاقات المتكرّرة التي عرفتها في كل الميادين، العلمية والسياسية والاقتصادية والأمنية، اتسمت استجابات شعوب المشرق لهذه التحدّيات، منذ الكارثة الاستعمارية الأولى، بردود الأفعال والمقاومات المتبعثرة والمتقطعة، وافتقرت، ولا تزال، للرؤية البعيدة العالية، وللاستراتيجية الشاملة. وتتخذ ردود أفعالها اليوم، بصورةٍ أوضح، شكل التشنجات والتهجمات الفردية والجماعية، وزيادة الرهان على العنف اللفظي والمادي الأعمى الذي يضرّ المشرقيين، أكثر مما يضرّ خصومهم، ويعمّق قطيعتهم مع العالم الذي يحتجون على عدم تعاونه وتهميشه لهم، ويزيد من استفزاز قواه العدوانية الموجهة لقهرهم.
والحال، لا يمكن لمثل هذا العنف وردود الفعل التي تسم استجاباتنا لتحدّي العزل والتهميش والإفقار، وما يرتبط به من فساد نخبة مارقة واستبدادها، أن يقدّم أي حلٍّ، أو مخرجٍ من الحصار المضروب بالفعل على المشرق، عربياً وتركياً وفارسياً معاً. لكنه يفاقم من مشكلاتنا المتراكمة، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويهدّد بخسارتنا جميع ما بقي لنا من رهاناتٍ، ويدفع بنا إلى مزيدٍ من الانحدار نحو الهاوية. وإذا ساهمت أعمال العنف الأعمى التي آلت إليها ردود أفعالنا، حتى في صراعاتنا الداخلية، بحيث لم يعد هناك أي شعورٍ بالمسؤولية تجاه المدنيين والأبرياء، حتى الأطفال والنساء والشيوخ، في "فشّ قهرنا" أو التنفيس عن كربنا، وهو تعويض عاطفي رخيص، لا جدوى منه، فلن تقدم لنا أي أمل أو عزاء. بالعكس، وظيفتها الرئيسية أن تخفي عنا بؤس نخبنا وقياداتنا وقصور تفكيرها وافتقارها رؤيةً متسقةً واستراتيجيةً فعالة لمواجهة التحدّيات التاريخية، وبالتالي، منعنا من البحث عن قيادةٍ جديدةٍ فاعلة، تستطيع أن تساعدنا على وضع حد لتاريخ التراجع والهزيمة والنكبات المتكرّرة التي أصبحت الإنجاز التاريخي الوحيد لنا. والمقصود هنا القيادة التاريخية التي تتجاوز فكرة الشخص أو الأشخاص القادرين على اتخاذ القرار، وتعني الرؤية الواضحة للواقع، وتعيين الأهداف الصحيحة والوسائل الناجعة، كما تعني العثور على الصيغة العملية القادرة على توحيد القوى، وتجميع الأفراد والجماعات في مسارٍ واحدٍ للعبور نحو الضفة الأخرى، والانتقال من العبودية إلى الحرية.
ليس رد الفعل سياسةً ناجعة، وإنما هو الضمانة للذهاب بأسرع وقت إلى الكارثة. ومن الأفضل لنا، وكما ينبغي للسجين في رمالٍ متحركة، عندما لا يكون الطريق واضحاً أمامنا، أفضل أن نتوقف عن السير، ونفكّر وننظر حولنا، ونوفر جهودنا لمرحلةٍ مقبلة، من أن نستمرّ في تقديم مزيد من التضحيات الضائعة.
أفول الشرق
والمقصود، في حالتنا، المواجهة التاريخية المستمرة منذ قرون، بين عالم الغرب الصاعد وعالم المتوسط المشرقي الذي أفل نجمه، بعد أن تربّع على قمة الهيمنة القارية قروناً طويلة سابقة. وليس المقصود بالغرب، هنا، منطقة جغرافية، وإنما دائرة جيوسياسية، تطور داخله عبر الزمن نمط حياة وأسلوب في النظر والعمل والإدارة والحكم والإنتاج، يشمل بلاداً وشعوباً وثقافاتٍ عديدة. وهذا ما نعنيه أيضاً بالشرق الذي يشمل دائرة جيوسياسية متوسطية، تبلورت فيها عبر العصور علاقات خاصة، ونمط تفكير وحياة تناقلتها امبرطوريات تاريخية عديدة، وشكلت هويةً مدنيةً تتجاوز التنوعات الثقافية، هي ما نسميها المدنية الشرقية المتوسطية، والتي ورثتها آخر الامبرطوريات الإسلامية فاحتفظت بتسميتها.
كلنا نعرف أن أوروبا، قبل أن تخرج من بربريتها، وتقيم صرح حضارةٍ لامعة غيرت معالم الحضارة الإنسانية، وتتحول إلى منارة للمجتمعات الأخرى، عاشت قروناً طويلةً تحت الهيمنة الفكرية والسياسية والعسكرية للامبرطوريات التي نشأت وترعرعت في المشرق، الذي شكّل منذ أقدم العصور مهداً لحضارةٍ كونية، ومرجعاً لمدنيةٍ عظيمةٍ، تعدّدت منابعها الثقافية والسياسية، وكوّنت، مع الزمن، دائرةً مشتركةً لتداول الأفكار وتبادل السلع والبضائع، قرّبت بين توجهات أفرادها وأنماط سلوكهم وتفكيرهم، في ما وراء تعدّد الأديان والثقافات والدول أيضاً. وصبّت في هذه الدائرة الجهود التاريخية لشعوب بلاد الرافدين، ووادي النيل واليونان والرومان والسوريين القدماء وسكان فارس واليمن والجزيرة العربية والكرد، وأخيراً الترك العثمانيين الذين أنشأوا واحدةً من أكبر الامبرطوريات، متعدّدة الأقوام والمذاهب والثقافات والأديان، عابرة للقارات، بسطت سيطرتها على المتوسط وهيمنتها القارية قرابة خمسة قرون.
وفي الصراع ضد هذه المدنية "الإسلامية"، وريثة امبرطوريات المشرق التي امتدّ نفوذها من إسبانيا إلى الهند والصين، وجمعت بين قومياتٍ وثقافاتٍ وأديانٍ ونحلٍ لا تُحصى، ولدت أوروبا الحديثة، وتشكّلت في مواكبتها الديناميات الفكرية والسياسية والجيوسياسية الجديدة التي قامت عليها المدنية الغربية التي انتقل إليها مركز إنتاج الحضارة وازدهارها، العلمي والمادّي، بشكلٍ مضطرد منذ القرن السابع عشر الميلادي. ولم يُتح لهذه المدنية الغربية الجديدة أن تستقرّ وتضمن تفوقها وهيمنتها العالمية إلا على أشلاء المدنيات السابقة، التي أسدل عليها سيف الحركة الاستعمارية الستار وحطم توازناتها، في الصين والهند وإفريقيا. وكانت معركتها الأقسى والأطول تلك التي خاضتها ضد المدنية الإسلامية لتفكيك مراكز هيمنتها العالمية : في الأندلس الأوروبية، وفي آسيا المغولية، وأخيراً ضد الدولة العثمانية التي بقيت تشكّل قوة عسكرية ضاربة في أوروبا نفسها حتى القرن الثامن عشر. فقد تم طرد المسلمين العرب والبربر طرداً كاملاً من إسبانيا وقتل من قتل وأجبر من بقي منهم على الانسلاخ عن جلده ودينه منذ عام 1492. وفي آسيا، حلت الملكة فيكتوريا إمبرطورةً على الهند محل السلطان محمد بهادر شاه عام1857. وفي المتوسط، دامت معركة تفكيك الإمبرطورية العثمانية وتحطيمها القرن التاسع عشر بأكمله، قبل توزع أملاكها بين الدول الأوروبية.
وعلى الرغم من أن مخطط تقسيم تركيا لم ينجح بسبب شراسة المقاومة الوطنية التركية بقيادة مصطفى كمال، إلا أن الحرب الغربية لا تزال مستمرة، ليس في سبيل السيطرة على موارد المنطقة المادية واللامادية، والتحكم بطرق المواصلات الدولية التي تحتل موقع القلب منها فحسب، وإنما، أكثر من ذلك، بهدف منعها من التعاون وتوحيد جهودها أو إعادة تجميع أطراف الدائرة الجيوسياسية المتوسطية ومخاطر بناء قوة استراتيجية، عسكرية وسياسية وأيديولوجية، يمكن أن تهدّد مستقبلاً الغرب، أو تخلّ بالتوازنات الجيوستراتيجية القائمة، أو تعمل على إعادة تدوير الموارد الحضارية، أو تغير في معادلات القوة الشاملة على أعتاب المواجهة الحاسمة للغرب مع المدنية الآسيوية الصاعدة. وفي اعتقادي، من الصعب تفسير مجموعة كبيرة من التطورات التي شهدتها هذه المنطقة، والمسار الذي اتخذته نزاعات سياسية وإقليمية عديدة، وحيز الهمجية والتوحش والعنف المسموح فيه، وغياب أي جهودٍ دوليةٍ جديةٍ لدعم الحلول السياسية، خارج سياق هذه الحرب أو المواجهة الكبرى، أو بتجاهل إكراهاتها. وأقرب مثال على ذلك المصير الذي آلت إليه ثورات الربيع العربي التي شكّلت الحدث الأبرز في تاريخ تطور شعوب المنطقة، وفي مقدمها مصير الثورة السورية النازفة منذ أكثر من خمس سنوات.
إجهاض الثورات وتحطيم الدول وتقسيم الشعوب
هكذا، لم ينشئ الغرب إسرائيل، ويجعل منها قوة إقليمية رئيسية، وربما الأولى اليوم في المنطقة، حباً باليهود أو شفقة عليهم، أو تكفيراً عن المحارق النازية وسياساته اللاسامية، ولا أطلق يد السفاح بشار الأسد في شعبه، يستبيح دماءه، ويجوّع أطفاله، ويدمر حضارته، ويهجّر الملايين من أبنائه، ولم يغضّ النظر عن استخدامه الأسلحة الكيماوية وتلك المحرّمة دولياً لتدمير المدن وترويع المدنيين وإفراغ البلاد من أكثر سكانها ضماناً لحقوق الأقليات، علويين ومسيحيين ودروزاً وإسماعيليين وسريان، ولم يزوّد قوات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي "البايادي" (الكردي) بأفضل الأسلحة، ويكرس أسطوله الحربي لدعم تقدمها حبّاً بالأكراد أو تعويضاً لهم عن معاناتهم التاريخية.
وبالمثل، لم يسمح لطهران الخمينية أن ترسل حرسها الثوري ومليشياتها الطائفية لتحكم العراق وتتحكّم به، وتحوله إلى خرابٍ ومرتع للحروب الطائفية وحروب التطهير العرقية والمذهبية، وهو أغنى دول المنطقة وأكثرها ثروةً، ولا غض النظر عن عبور مليشياتها المذهبية المتوحشة نهر الفرات وبادية الشام حتى حدود المتوسط لدعم نظام الأسد المسخ الذي لا يتردّد في قتل شعبه وتشريده للاحتفاظ بالحكم، حباً بالشيعة أو تأثراً باستشهاد الحسين. تماماً كما أن غض النظر عن عمليات الإبادة الجماعية المنظمة في أكبر المدن السورية، وتشريد ملايين السوريين والعراقيين، وإطلاق يد المنظمات الإرهابية الدولية في المناطق السورية والعراقية لم يأت كرهاً بالسنة، أو انتقاماً منهم. فليس لدين الضحايا ومذاهبهم أي قيمةٍ في ذاتها بمنظور هذه المواجهة، وإنما ينبع استهداف مجتمعاتهم وتفتيتها لما يمثلونه، بامتدادهم على اتساع الرقعة المتوسطية، وهيمنتهم العددية، من إمكانات واحتمالات لإعادة حبال التواصل والتفاعل وإعادة التجميع والتوحيد للشتات المتوسطي الراهن، كما أظهرت ذلك خلال العقود الطويلة الماضية حركات الصراع من أجل وحدة المنطقة، سواء أتت في شكل وحدة قومية أو دينية.
كل هذه الخطط جزء من سياسة الحفاظ على الوضع الاستثنائي الهامشي للمشرق، ومنع نشوء قوة استراتيجية في المتوسط تهدّد الأمن الأوروبي الغربي، وتعدل في التوازنات ودورات التبادل، وتعيد توجيه الموارد والمكتسبات الحضارية وتوزيعها. والسبيل الرئيسي لتحقيق ذلك هو إبقاؤه تحت المراقبة، وفي قفصٍ من حديد، وإجهاض حركاته وتحييد شعوبه والقضاء، بشكل منتظم، على أي قوةٍ ناشئةٍ، من المحتمل أن تتحوّل إلى مركز قوة استراتيجية. وهذا الضغط الاستراتيجي الهائل والمستمر عقوداً على مجتمعات المشرق، وحرمانها من أي فرصةٍ للانعتاق والتقدّم هو العامل الأكبر والأشمل، في دفعها نحو الاضطراب وعدم الاستقرار بما يثيره من التهاباتٍ وتوتراتٍ دائمةٍ واختلالاتٍ وتأزماتٍ، تقوّض أي أسسٍ ثابتةٍ وسليمةٍ لاستقرار الدولة والحياة السياسية والأمنية والثقافية، وتحول حياة شعوبه وأفراده إلى سلسلةٍ لا تنقطع من الأزمات والنزاعات.
وما من شك في أنه، بنتيجة هذه المواجهة التاريخية التي خسرتها، تحوّلت منطقة المشرق التي كانت مقر مدنيةٍ مزدهرةٍ وجامعة، وأحد مراكز الحضارة الرئيسية في العالم، قروناً طويلة، إلى مسرحٍ للخراب والدمار والفوضى. وهي لا تزال تتراجع باستمرار، وتخسر على كل الأصعدة، الداخلية والخارجية، وتكاد لا تحقق أي إنجاز، حتى فقدت شعوبها أو هي في طريقها إلى أن تفقد جميع آمالها، وتغرق في اليأس والإحباط، بينما تحولت أوروبا المجاورة التي كانت تسبح في فوضى الصراعات الدموية الدينية والقومية حتى منتصف القرن الماضي إلى مركز الثقل الرئيسي، وموطن المدنية ومنتج الحضارة.
في مواجهة سياسات العزل والتهميش والحصار
منذ تبني الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سياسة النأي بالنفس عن مشكلات المشرق والشرق الأوسط، بعد فشله المدوّي في إقناع إسرائيل بمشروع حل الدولتين الذي وعد به حلفاءه العرب، ولد اقتناع واسع في الرأي العام الدولي، الرسمي والشعبي، أن المشرق منطقةُ زلازل واضطرابات وعدم استقرار، لا أمل في علاجها. ومن الأفضل تركها لمصيرها. والحقيقة عكس ذلك تماماً، فليس هناك منطقة دمرت تدخلات الغرب أسس استقرارها وتوازناتها النفسية والدينية والسياسية والأمنية في العصر الراهن، وقضى تلاعب المؤسسات والأجهزة الأمنية الغربية بمؤسساتها وقياداتها على مستقبل تنميتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية، كما حصل لهذه المنطقة المنكوبة من العالم، حتى أصبحت تحتكر اليوم أغلب الجهد الدولي الأمني والإغاثي والدبلوماسي.
وما يجري في المنطقة، اليوم، بعكس الادعاء السائد، هو أكبر تدخل دولي مشترك، حصل في بلد واحد وفي الوقت نفسه، في أي عصر، حيث تشارك 62 دولة رسمياً، بجيوشها وأساطيلها، بالإضافة إلى عشرات، وربما مئات، المليشيات من كل المذاهب والجنسيات، في عملية إخصاء استراتيجي طويل المدى، يهدف إلى استبدال الدولة والأمة والثقافة والمدنية والحضارة والفكرة الإنسانية، بزعماء مليشيات ومجالس عشائر وحشود شعبية وطوائف وقوميات ميكروسكوبية ومظالم وانتماءات وولاءات وعصبيات وعداوات أبدية. ولا يتردّد التحالف الدولي الذي سلم قيادته للثلاثي، الأميركي الروسي الإسرائيلي، غير المسبوق في العصر الحديث خارج المنطقة، في سبيل تحقيق هدفه من استخدام نار الإرهاب الكاوية التي تحولت منظماتها في أشهر قليلة، وبقدرة قادر، إلى جيوش وممالك وإمارات جبارة، تهدد المنطقة والعالم. وللهدف نفسه، يصر القادة الغربيون، كما يصر الإعلام على تسميتها بالإسلامية، حتى صار كثيرون يعتبرونها ممثلةً للمسلمين السنة عامة، وناطقة باسمهم.
وما من شك في أن اندلاع الثورات العربية في العقد الثاني من هذا القرن، ومشهد ملايين العرب المتجمعين في الساحات والمطالبين بحقوقهم، وفي مقدمها حقهم في المشاركة في القرار والحكم، قد قرع ناقوس الخطر بالنسبة لجميع القوى الخائفة من يقظة الشرق العربي. وكان القبول بمثل هذه المطالب يعني تلقائياً انهيار استراتيجية الغرب، للإبقاء على سيطرته الإقليمية، والتي كانت تعتمد، بشكل رئيسي، على تعاون النظم والنخب التابعة، وأحياناً العميلة. ولذلك، بعكس المظاهر، لم يتردّد الغرب السياسي، لحظةً، في اتخاذ قرار قيادة الثورة المضادّة لمواجهة خطر انتصار الشعوب، وعندما أبدى تفهماً وأظهر تأييده للثورة، كان هدفه الالتفاف عليها، واختراقها من الداخل، لإعادة توجيهها وضبطها. لكنه سرعان ما نظم عملية الانقضاض عليها، بالتحالف مع القوى التابعة له، وروح الانتهازية وغياب الثقة بالذات، وتغذية الأوهام عند كثيرين من أعضاء النخب المعارضة والمعارضات السياسية.
يتركّز الجهد العسكري والسياسي الغربي الراهن، من أجل إجهاض ما حققته المنطقة ومجتمعاتها من نمو في العقود الماضية، بعد حروب السبعينات، وإرجاعها قرناً إلى الوراء، كما وعد زعماء التدخل الأميركي في العراق سابقاً، على عدة أهداف: تحطيم الدولة المركزية الوطنية، أو تلك التي فشل في السيطرة عليها والتحكم بها من خلال النخب الموالية والتابعة له، وإطلاق دينامية حرب دينية شيعية سنية، ستشل المنطقة عقوداً طويلة مقبلة، وتقطع عليها، بسبب العداوات والأحقاد، أي أمل في استعادة وحدتها، والتعاون في ما بينها للوصول إلى بناء دائرة جيوسياسية واقتصادية وثقافية مستقلة ومستقرة وفاعلة، وفتح ملفات المنطقة القومية المعلقة، وفي مقدمها قضية القومية الكردية. لكن، ليس وحدها. وترميم النخبة التابعة التي فقدت سمعتها، وبان تهافتها، وإعادة الرهان على القوى الانقلابية العسكرية، والتعاون معها، وتقوية أجهزة القمع الاستخباراتية التقليدية، والتنسيق معها بشكل كامل.
في هذا السياق، يندرج أيضاً تشجيع الولايات المتحدة وحلفائها العراق، في التسعينات من القرن الماضي، على شنّ الحرب على إيران، بعد سقوط النظام الشاهنشاهي، لإطلاق دورة عنف وحروب إقليمية جديدة. وللغرض نفسه، صمم جورج بوش الابن وحلفاؤه التدخل العسكري في العراق عام 2003، لينهي وجود الدولة العراقية المركزية، ويرعى عملية تقسيم البلاد وتدمير وحدتها القومية والدينية ومؤسسات الدولة الحديثة، ويقضي على أي احتمالٍ لاستعادة العراق هويته، وولادة قوة استراتيجية وازنة فيه. وهو الغرض نفسه الذي أوحى للرئيس أوباما، ولحلفائه، بعدم التدخل لفرض الحلّ السياسي في سورية، والحيلولة دون تطوّر الصراع نحو الحرب الأهلية والحروب بالوكالة، وانتشار منظمات الإرهاب الدولية، وخطر إشعال حرب سنية شيعية إقليمية، تقضي على كل ما أنجزته المجتمعات خلال القرنين الماضيين، وتعيدها إلى القرون الوسطى. وأكبر دليل على ذلك إطلاق يد الروس والإيرانيين والأسد تقريباً من دون قيود أو حتى انتقاد، والتهاون في وقف الانتهاكات اللامسبوقة لمواثيق الحرب، وغضّ النظر عن تعميم سياسة التجويع والتشريد والقتل العشوائي، فالمقصود تمديد أجل الحرب إلى أن يقتنع السوريون، كما اقتنع العراقيون، بالطريقة نفسها، من قبل، باستحالة الحفاظ على دولتهم المركزية، ويقبلون التقسيم، على أسسٍ طائفيةٍ وإتنية، تحت غلالةٍ خادعةٍ من الفيدرالية الكاذبة. ولا يتردّد قادة روسيا، في حماسهم لانتزاع الزعامة في الحرب الحضارية ضد الإسلام والمسلمين، في الإعلان صراحةً عن استحالة القبول بهيمنةٍ سنيةٍ في سورية، وربط السلام فيها بتحقيق التوازن الطائفي. ما يعني، أحد أمرين: إما تعميم عمليات التهجير القسري للمسلمين حتى تقل نسبتهم على عدد السكان الكلي، أو تشجيع حروب التطهير المذهبي، حتى يتحقق رسم حدود آمنةٍ وقويةٍ للدول الجديدة التي تهدف، باسم حماية الأقليات الاتنية والطائفية، للحيلولة دون نشوء دول قوية.
وفي هذا السياق أيضاً، تصبّ مجموعة الأبحاث النظرية والإعلامية الغربية المتزايدة التي تريد أن تقنع العرب والمسلمين من سكان المنطقة بتناقض فكرة الدولة المركزية مع التقاليد والثقافة والبنية الاجتماعية العربية والهوية الإسلامية، وتشجعهم على رؤية الحل لمشكلاتهم السياسية في العودة إلى الدول الإتنية والطائفية الصغيرة، بدل الاستمرار في الكفاح من أجل دول مدنية ديمقراطية حرة. ومن الواضح أن مثل هذه الدول التي لم يعد لها أي حظٍ في البقاء في عالم اليوم بمواردها الذاتية، سوف تتحوّل إلى ذئابٍ على بعضها، لاحتكار الموارد المحدودة في المنطقة ووضع اليد عليها، كالنفط والغاز والماء، أو سوف تجد نفسها مضطرةً للعمل مباشرةً في خدمة الدول والاستراتيجيات الدولية الأمنية والهيمنية لتأمين مورد رزقها وحماية نفسها من الدول الأقوى القريبة والعدوة. ويجد هدف تحطيم الدولة المركزية، كما حصل في الحالة العراقية، هوىً خاصاً لدى إسرائيل التي تمثل، في معركة تقويض قدرة شعوب المنطقة على الاستقلال والتحرّر وبناء قوة استراتيجية تحفظ أمنها وحقوقها، قاعدة متقدمة عظيمة الأهمية، ورأس رمحٍ لا يعوّض بالنسبة لعموم الغرب. وتجد تل أبيب، في دورها الجديد والثمين هذا، فرصتها التاريخية لتطبيع وضعها الاستثنائي داخل هذه المدنية الغربية، والتعامل معها وداخلها كقوة مستقلة وند، بعد أن بقيت، عقوداً سابقة طويلة، عالة عليها.
التخبط في رمال متحركة
على الرغم من هذه الخسارة الاستراتيجية التاريخية التي منيت بها، والإخفاقات المتكرّرة التي عرفتها في كل الميادين، العلمية والسياسية والاقتصادية والأمنية، اتسمت استجابات شعوب المشرق لهذه التحدّيات، منذ الكارثة الاستعمارية الأولى، بردود الأفعال والمقاومات المتبعثرة والمتقطعة، وافتقرت، ولا تزال، للرؤية البعيدة العالية، وللاستراتيجية الشاملة. وتتخذ ردود أفعالها اليوم، بصورةٍ أوضح، شكل التشنجات والتهجمات الفردية والجماعية، وزيادة الرهان على العنف اللفظي والمادي الأعمى الذي يضرّ المشرقيين، أكثر مما يضرّ خصومهم، ويعمّق قطيعتهم مع العالم الذي يحتجون على عدم تعاونه وتهميشه لهم، ويزيد من استفزاز قواه العدوانية الموجهة لقهرهم.
والحال، لا يمكن لمثل هذا العنف وردود الفعل التي تسم استجاباتنا لتحدّي العزل والتهميش والإفقار، وما يرتبط به من فساد نخبة مارقة واستبدادها، أن يقدّم أي حلٍّ، أو مخرجٍ من الحصار المضروب بالفعل على المشرق، عربياً وتركياً وفارسياً معاً. لكنه يفاقم من مشكلاتنا المتراكمة، الوطنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ويهدّد بخسارتنا جميع ما بقي لنا من رهاناتٍ، ويدفع بنا إلى مزيدٍ من الانحدار نحو الهاوية. وإذا ساهمت أعمال العنف الأعمى التي آلت إليها ردود أفعالنا، حتى في صراعاتنا الداخلية، بحيث لم يعد هناك أي شعورٍ بالمسؤولية تجاه المدنيين والأبرياء، حتى الأطفال والنساء والشيوخ، في "فشّ قهرنا" أو التنفيس عن كربنا، وهو تعويض عاطفي رخيص، لا جدوى منه، فلن تقدم لنا أي أمل أو عزاء. بالعكس، وظيفتها الرئيسية أن تخفي عنا بؤس نخبنا وقياداتنا وقصور تفكيرها وافتقارها رؤيةً متسقةً واستراتيجيةً فعالة لمواجهة التحدّيات التاريخية، وبالتالي، منعنا من البحث عن قيادةٍ جديدةٍ فاعلة، تستطيع أن تساعدنا على وضع حد لتاريخ التراجع والهزيمة والنكبات المتكرّرة التي أصبحت الإنجاز التاريخي الوحيد لنا. والمقصود هنا القيادة التاريخية التي تتجاوز فكرة الشخص أو الأشخاص القادرين على اتخاذ القرار، وتعني الرؤية الواضحة للواقع، وتعيين الأهداف الصحيحة والوسائل الناجعة، كما تعني العثور على الصيغة العملية القادرة على توحيد القوى، وتجميع الأفراد والجماعات في مسارٍ واحدٍ للعبور نحو الضفة الأخرى، والانتقال من العبودية إلى الحرية.
ليس رد الفعل سياسةً ناجعة، وإنما هو الضمانة للذهاب بأسرع وقت إلى الكارثة. ومن الأفضل لنا، وكما ينبغي للسجين في رمالٍ متحركة، عندما لا يكون الطريق واضحاً أمامنا، أفضل أن نتوقف عن السير، ونفكّر وننظر حولنا، ونوفر جهودنا لمرحلةٍ مقبلة، من أن نستمرّ في تقديم مزيد من التضحيات الضائعة.