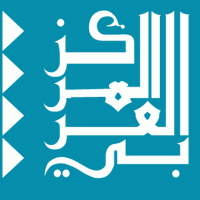الحوار الوطني في مصر ... دوافعه ومواقف القوى السياسية وفرص نجاحه
السيسي يخاطب الحاضرين في افتتاح الحوار الوطني في القاهرة (3/5/2023/فرانس برس)
أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 26 نيسان/ أبريل 2022، تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب، وهو منتدى للحوار جرى إنشاؤه في عام 2016، بإدارة حوار سياسي مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية في البلاد. وفي هذا الإطار، أعاد السيسي تفعيل عمل "لجنة العفو الرئاسي"، المنوط بها طرح قوائم السجناء السياسيين على الأجهزة الأمنية طلبًا للإفراج عنهم. وقد بدأ العمل على "الحوار الوطني المصري"، تحت شعار رئيس هو "الطريق نحو الجمهورية الجديدة"، الذي رفعه النظام قبل الدعوة إلى الحوار. لكن اللافت أن العنوان الفرعي المرافق هو "مساحات مشتركة"؛ ما يوحي ضمنًا بتشكّل إرادة سياسية لإفساح مجال للتفاعل مع قوى المعارضة، ندر وجودُه منذ صعود السيسي إلى سدّة الحكم عام 2014.
جاء الإعلان عن إطلاق حوار وطني، وفقًا لبعض المراقبين، بفعل ضغوطٍ شديدةٍ يتعرّض لها النظام، مردّها تدهور الوضع المعيشي في البلاد على نحو ملحوظ نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والمالية التي اتّبعتها الحكومة على امتداد العقد المنصرم، وتوقّف المساعدات الخليجية التي أدّت دورًا مهمًا في دعم النظام في سنوات حكمه الأولى.
وبعد عملية تحضير استغرقت ما يزيد على السنة، انطلق الحوار رسميًا في 3 أيار/ مايو 2023. من الناحية التنظيمية، شُكِّل "مجلس أمناء الحوار"، وعُيِّن ضياء رشوان منسقًا عامًا، ووُزِّعت القضايا التي سيناقشها المنتدى على ثلاثة محاور؛ سياسية واقتصادية ومجتمعية. وقُسمت المحاور على خمس لجان، اجتهدت جميعها في وضع برنامج عمل وطرح محددات لإجراء الحوار. ومنذ بدء جلساته العلنية، التي صحبتها دعاية مكثفة، وحتى آخر تلك الجلسات في 22 حزيران/ يونيو الماضي، عُقِدت 31 جلسة ناقشت قضايا مختلفة، وضمّت معارضين للنظام وموالين له وممثلين عنه.
شارك في جلسات الحوار أقطاب من النظام وممثلون عن الأحزاب السياسية وقادة النقابات المهنية وعددٌ من قيادات المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة
فرقاء حول الطاولة
بدا مشهد انطلاق الحوار في الثالث من أيار/ مايو 2023 مشهدًا غير مألوف، لم يعتده الرأي العام، منذ أن تولّى السيسي حكم البلاد؛ ففي قاعة واحدة ظهرت إلى جانب ممثلي النظام شخصيات محسوبة على المعارضة، بمن فيهم ممثلون عن قوى سياسية وأحزاب ظلت ممنوعة من ممارسة العمل السياسي على امتداد العقد الماضي، فضلًا عن شخصياتٍ مستقلة. اعتبر ضياء رشوان الذي بذل جهودًا كبيرة في التواصل مع مختلف القوى والشخصيات لإقناعهم بالمشاركة، المدعوين "شركاء في تحالف 30 يونيو"، ما يعني استبعاد جماعة الإخوان المسلمين. لكن هؤلاء "الشركاء"، كما وصفهم رشوان، وعلى الرغم من تأييدهم سياسات النظام في لحظة تأسيسه، استُبعدوا من المشهد، ليستقرّ بهم المقام في مربع الفرقاء. وبناء عليه، بدا النظام كأنه يسعى إلى إحياء تحالفاته القديمة و"إعادة اللحمة" إليها، على حد قول رشوان. وانطلق الحوار على أرضية ما يسمّيه النظام شرعية دستور 2014، وليكون الشرط المسكوت عنه استبعاد الإخوان ومناصريهم. والحقيقة أن النظام عامل "شركاء 30 يونيو" بوصفهم خصومًا، وما زال عدد من المحسوبين على هذا المعسكر في السجون على الرغم من الحوار. كما أن النظام يبدو متردّدًا بين الحاجة إلى الحوار، إذ لا يمكن الاستمرار بنهج قمع الرأي المختلف وإغلاق الفضاء العام، والخشية من أن يجرّئ الحوار معارضي النظام داخل مصر على "التطاول" وخرق المحاذير التي بذل في وضعها جهدًا كبيرًا، وكان مستعدًا لارتكاب أعمال قمع تجاوز فيها من سبقوه على حكم مصر، وتحمّل في سبيل ذلك إدانات من كل الاتجاهات.
أهداف "شركاء الحوار"
شارك في جلسات الحوار أقطاب من النظام وممثلون عن الأحزاب السياسية وقادة النقابات المهنية وعددٌ من قيادات المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة، إضافة إلى شخصياتٍ معروفة شاركت في ثورة 25 يناير 2011، وهذا طرح أسئلة متعدّدة عن أهداف "شركاء الحوار"، وعن توقّعاتهم منه، وعن وجهة التغيير المأمول وسقفه.
بالنسبة إلى النظام، فرض تأزم الأوضاع الاقتصادية وانسداد الأفق ضرورة إظهار بعض المرونة، ومحاولة البحث عن حلول بديلة، فكان فتح باب للحوار مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بمنزلة خطوة استباقية تهدف إلى احتواء التململ الشعبي المتنامي على تردّي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وخيبة الأمل التي أخذت تعتري فئاتٍ وقوى سياسية واسعة كانت أيدت سياسات النظام خلال السنوات الماضية. كما تستجيب خطوة فتح حوار وطني لضغوط تمارسها بعض الدول الغربية لتخفيف القبضة الأمنية وفتح باب المشاركة السياسية وتوسيع هامش الحريات العامة. ومن خلال الانفتاح على من يصنفهم النظام "معارضين معتدلين"، يجري إشراك هؤلاء في تحمّل مسؤولية إيجاد بدائل وحلول للخروج من الأزمة. وقد أعلن النظام نيّته التعامل مع مخرجات الحوار الوطني بجدّية، سواء في صورة مقترحات تشريعية أو مقترحات سياسية تُنفَّذ بقرارات.
يشير رافضو الحوار إلى تناقضات تمنع تفاعلهم مع النظام، وفي الاختلاف الشديد في رؤيتهم لإدارة البلاد وأسلوب الحكم وأولويات الحل
ولا ينفصل الأمر عن التحضير لإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية المقرّر عقدها في شباط/ فبراير 2024 ويبدأ الاستعداد لها في كانون الأول/ ديسمبر المقبل. في سياق كهذا، يبدو منطقيًا أن يتعجّل النظام في بثّ شعور عام بالتغيير أو بإمكانية التغيير وتجاوز أزمات البلاد الخانقة، ليكون ذلك مقدّمة لإعادة طرح السيسي نفسه قائدًا للبلاد للمرّة الثالثة. وربما من هذه الزاوية، يعتبر بعضهم أن إطلاق "الحوار الوطني" لا يعدو كونه إجراءً دعائيًا بحتًا، فالمستهدف من مشهد الحوار "الشكلي" ليس الداخل، وإنما القوى الخارجية التي خبا حماسُها لدعم النظام في ظل فشله وتفاقم أزماته.
أما قوى المعارضة التي قبلت دعوة الحوار، وفي مقدمتها تكتل "الحركة المدنية الديمقراطية"، فقد طرحت عدة شروط لتلبية الدعوة، أهمّها أن يكون الحوار جادًا وحقيقيًا، وأن ينتهي إلى نتائج عملية تشقّ طريقها إلى التنفيذ. وقد وضعت الحركة ضوابط إجرائية وموضوعية ضرورية "لإكساب الحوار الجدّية المطلوبة، وضمان أن يكون وسيلة لإنقاذ البلاد وحل مشكلاتها". وخلال الفترة التحضيرية للحوار، وفي لقاءات مع ممثلي النظام ووسطائه، وضعت الحركة في مقدّمة أولوياتها مسألة الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والتي لم يمانع النظام النقاش فيها، لكن شكوكًا جدّية تبقى قائمة حول وجود نية حقيقية للتعامل مع هذا الملف شديد الحساسية، خاصة مع استمرار نهج القمع، الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في أثناء جلسات الحوار. كما ظل عمل "لجنة العفو الرئاسية" معطلًا، حيث جرى الإفراج عن عدد محدود جدًا من السجناء السياسيين، ولم تتوقف السلطات عن شن حملات اعتقالات موسعة شملت نشطاء وسياسيين عديدين على خلفية التعبير عن الرأي؛ ما تسبّب بحرج شديد للمشاركين في الحوار أمام قواعدهم وأمام المنتقدين؛ إذ يتعذّر تحقق الإصلاح في ظل هذه الأجواء. وزاد من حالة عدم الثقة إصرار النظام على عدم حلّ ملف السجناء السياسيين، سواء بالإفراج عنهم أم بإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، الساري منذ عام 2013، الذي شكّل المظلة القانونية لحبس أشخاص قدّرت منظمات دولية ومحلية أعدادهم بعشرات الآلاف.
موقف الرافضين
يشير رافضو الحوار إلى تناقضات تمنع تفاعلهم مع النظام، وفي الاختلاف الشديد في رؤيتهم لإدارة البلاد وأسلوب الحكم وأولويات الحل. وحين انطلق الحوار وأُذيعت فعالياته، بدا أن لوجهة نظرهم وجاهتها. ففي ظل تمسّك السلطة بسياساتها، بدا الحوار أقرب إلى "مكلمة" أو "حوار طرشان"؛ إذ تقول الحكومة كلامًا، وتقول المعارضة آخر، وفي النهاية، لا تُطرح سيناريوهات لحل الأزمة، ولا تبرُز مساحة مشتركة يمكن الانطلاق منها إلى مخرجاتٍ تترجم التوقعات منه.
يبرُز تناقض الرؤى وتضارب الأولويات في خطاب السيسي، الذي نُقل عنه انزعاجه من تركيز المعارضة على ملفّ السجناء والحريات والديمقراطية خلال الحوار
يلح الرافضون أيضًا على حل ملفّ الاعتقالات السياسية، فقد عكس التمسّك بسياسات القمع والاعتقال قناعة النظام بأن استبقاء هؤلاء في السجون هو أحد مقتضيات استقراره، في حين أن المعارضة تعدّ ذلك أحد أسباب عدم الاستقرار. ويبرُز تناقض الرؤى وتضارب الأولويات في خطاب الرئيس السيسي، الذي نُقل عنه انزعاجه من تركيز المعارضة على ملفّ السجناء والحريات والديمقراطية خلال الحوار، وأنه يريد "ناس بتفهم في أزمة البلد في الأمور غير السياسية، وتدرك أن الديمقراطية والانتخابات مش هتحل المشاكل". ويبدو موقف السيسي واضحًا في هذا الشأن؛ إذ ظلّ يرد على انتقادات دوائر غربية بشأن تردّي حالة حقوق الإنسان والحريات بأن الأمر ليس من أولويات حكمه، وأنه يتبنّى مفهومًا خاصًا لتلك الحقوق، يرتكز بالأساس على أن يوفر للشعب شروط الحياة الأساسية، وهذا في تقديره عبءٌ كبير، قد يعجز عنه. ولذلك طالب الحكومات الغربية التي تحثه على احترام حقوق الإنسان بأن تساعده ماديًا بدلًا من ذلك، فهو "يحكم 100 مليون" إنسان.
يعكس وضع استقرار الدولة المصرية كنقيض لمسألة حقوق الإنسان قناعة قديمة للنظام، ووعيا بأن مصالح الدول الغربية، التي تخشى من انعكاس أزمات بلدان كبيرة كمصر عليها، تدفعها إلى خيارات "واقعية"، تؤجّل بموجبها المطالبة باحترام حقوق الإنسان. وطالما لوّح النظام بورقة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وغيرها من ملفات تبدو كفزّاعة تُوظَّف لضمان استمرار دعم الدول الغربية، أو على الأقل إسكاتها بشأن الانتهاكات الحقوقية الواسعة، وفق سياسة أن مصر كبيرة حجمًا ودورًا حتى يسمح العالم بانهيارها (too big to fail).
حوار "اللاءات الثلاث" وآفاقه
إلى جانب ملفّ الحقوق والحريات، شغلت قضايا أخرى قائمة أولويات الحوار وجدول مناقشاته، ارتبط أغلبها بأزمات قائمة وملحة. وكان واضحًا وجود قضايا غير قابلة للنقاش تمثّلت في ثلاث لاءات أعلن عنها ضياء رشوان في الجلسة الافتتاحية: أولًا: لا مساس بالدستور القائم، "بل انصياع كامل" لمواده جميعًا، وهو ما يعني بوضوح ألّا محلّ في الحوار لطرح إصلاحات دستورية من تلك النوعية التي تطمح إليها قوى المعارضة. ثانيًا، لا تطرّق إلى السياسة الخارجية، سواء تعلق الأمر بالاستراتيجية أم الأدوات، وفي أي ملفّ كان. أما ثالثًا، فهي ما أسماه رشوان "الأمن القومي الاستراتيجي"، وأشار إلى أن إدارته بيد القوات المسلحة، تلك الإدارة التي أكّد أنها محل "ثقة تامة" من المشاركين جميعًا. لم يمنع تحديده هذا من حقيقة أن مصطلح "الأمن القومي" يوظّفه النظام على نحو يستعصي على الضبط، ولطالما وسّع مظلّته لتشمل ما يشاء أن تشمله، والأمر ليس بعيدا عن أولوية الحوار المتعلقة بملفّ المعتقلين السياسيين.
حرص عديد من أقطاب المعارضة على التمسّك برهانهم على الإصلاح، على الرغم من تلك العوائق، وضعف الجدية، وتضاؤل مساحة ما يمكن المطالبة بإصلاحه
ومنذ بدء جلسات الحوار، بدا واضحًا أن قائمة المحظورات وضعت كحاجز أو إطار محدّد للجم قوى المعارضة، وظلت رقعتها تتسع منذ أول جلسة حوار، ومن ذلك عدم توجيه انتقادات لمجلس النواب، حسبما أعلن رشوان في ردّه الغاضب والحاسم على مَن انتقدوا أداء البرلمان، وشدّد على أنه يرى ذلك إساءة مرفوضة لإحدى مؤسّسات الدولة.
حرص عديد من أقطاب المعارضة على التمسّك برهانهم على الإصلاح، على الرغم من تلك العوائق، وضعف الجدية، وتضاؤل مساحة ما يمكن المطالبة بإصلاحه. واستمر أغلبهم في حضور جلسات الحوار والتفاعل مع مناقشاته، وتركّز الجهد على طرح مطالب محددة خاصة في القضايا الأكثر إلحاحًا، والمتعلقة بالإصلاح السياسي تحديدًا، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية القادمة، باعتبار أنها يمكن أن تشكل نقطة بداية لفتح المجال السياسي وإثبات جدّية السلطة في الإصلاح وبداية مرحلة جديدة، كما وعدت.
حول هذه المسألة، ثمّة ضمانات أو محدّدات رئيسة للعملية الانتخابية القادمة شدد بعض المتحاورين على ضرورتها، منها تعديل قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. وبالنسبة إلى المعارضة يبقى الأهم هو إلغاء النظام الانتخابي الحالي، القائم على القائمة المطلقة المغلقة، ليحل محله نظام انتخابي أكثر عدالة. وحول هذا الموضوع شهد الحوار خلافات حادّة، فمن جهة، أصر الموالون للسلطة على ضرورة استمرار نظام القائمة الحالي، بينما تمسكت المعارضة بالمطالبة بنظام معدل أساسه القوائم النسبية، ورأت أنه يسمح بتوسيع تمثيل القوى السياسية والأحزاب، على عكس نظام القائمة الذي يهمشها، وتتبدّى عيوبه في فرزه برلمانًا من كتل كبيرة موالية للسلطة. وبالعموم، لم تسفر النقاشات في الموضوع عن شيء ذي بال، باستثناء وعد رشوان بأن الآراء المختلفة بشأن النظام الانتخابي مثلها مثل كل قضايا المحور السياسي ستُرفع إلى رئيس الجمهورية، بمعنى أن السلطة التي يُفترض أنها طرفٌ في الحوار سوف تكون أيضًا الحكم، حيث يعود إليها أن تقبل أو ترفض ما يجري التوصل إليه من توصيات.
خاتمة
لم تنجح جولات الحوار الوطني الـ 31 التي عُقِدَت حتى الآن في إنتاج توافق على سبل الخروج من الأزمة العميقة التي تواجهها البلاد. ولم تكن هناك توقّعات كبيرة بهذا الشأن في ظل تمسّك السلطة بسياساتها ونهجها، وافتقاد المعارضة أوراق القوة التي تمكّنها من فرض أي تغيير مهما كان محدودًا، فضلًا عن انقساماتها واختلافها حول العديد من قضايا الحوار. ولا يبدو أن لدى المعارضة حاليًا أي تصوّر عن المرحلة المقبلة، وعن جدوى الاستمرار في الحوار، وحتى بهذا الشأن تبدو الانقسامات شديدة، إذ أعلن جزءٌ من المعارضة عن تعليق مشاركته حتى يجري الإفراج عن سجناء الرأي. في الوقت نفسه يحيط الغموض بمخرجات الحوار والتي هي الآن قيد الصياغة في جلساتٍ مغلقة.