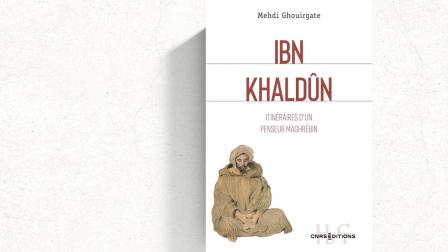هل يمكن أن نستبدل كلمة "تقاليد" بـ "ثقافة"؟ ربما تكون إحدى أهم مهام الكتابة مساءلة الثقافة، الحوار معها. ثقافة المجتمع تشمل العادات والتقاليد، تشمل المعتقدات والثوابت، حتى معارضة السلطة أو مهادنتها جزء من ثقافة المجتمع بمعناها الواسع. من هنا كانت الكتابة شوكة في ظهر السلطة، في ظهر رجال الدين والمحافظين، في ظهر المستقر والمتفق عليه، والثابت. لكل ذلك أصبح كل هؤلاء أعداء للكاتب، للكتابة، وأصبح على الكاتب أن يتخلى عن الجميع ليتخلى، ليتخلى عن الرقيب الذاتي.
لكن الكاتب لم يتخلّ عن الرقيب الذاتي. لم يتخل لأنه لم يتخل عن كل هؤلاء. البعض تخلى بالطبع، لكن الكثيرين لم يتخلوا. لم يتخلوا فكتبوا روايات بدلاً من كتابة سيرهم الذاتية، اختاروا لها بطلاً يحمل اسمهم أو اسماً آخر وقالوا إنه هو من فعل، أنا لم أفعل. بعض هؤلاء اتكأوا على أن الرواية عمل خيالي، بينما السيرة الذاتية واقع لا محالة. اختبأوا في خيالية الرواية المفترضة ليمرروا سيرتهم الواقعية. ربما كتبوا قصصاً مثيرة، تحسب لهم شجاعتهم في كتابتها، لكنها ليست إلا سيراً ذاتية، سيراً لم تبحث عن تقنية روائية ولا أسلوب روائي، بل قامت على البوح والاعترافات. أدب البوح ليس جيداً ولا سيئاً، لكنه شيء آخر بعيد عن الرواية كفن خيالي. بعيد لأنه لم يسع حتى إلى "تفنين" الوقائع؛ لم يلق بها في مجمرة الفن، لم يتركها تنضج تحت حرارة سؤال الإبداع. هنا اختلطت الأوراق. هنا اختفت كتابة السير الذاتية من اللغة العربية، أو ظهرت تحت قناع الرواية.
في المقابل، صارت السيرة الذاتية، التي تكتب تحت مسمى السيرة الذاتية صراحةً، إن كُتبت، طريقة لتمجيد الذات لحصد بطولة، وليست كتابة عما هو أكثر عمقاً في الذات الإنسانية. لم تكتسب السيرة الذاتية بالعربية صدقاً بقدر ما تميزت بالتزييف. التابوهات حاضرة، الأخلاق تفرض هيمنتها، عين المجتمع كرقيب تراجع الكلمات وتعيد صياغتها. وبعيداً عن أوراق الشجرة، الأزمة تكمن في الجذر: في الرقيب الذاتي.
الأزمة أكبر عندما تتصدى للكتابة سيدة. أولاً، ستختفي السيرة الذاتية كسيرة ذاتية من الأساس، إلا فيما ندر. أما الإبداع، من قصة ورواية، فستتحول بطلته تلقائياً للمؤلفة نفسها حتى ولو كانت تكتب بالفعل عملاً خيالياً. كاتبات يهربن من كتابة السيرة بكتابة الرواية تجنباً لنقد المجتمع، ومجتمع يطارد النساء اللاتي تكتب الروايات بذريعة أنهن يكتبن سيرة ذاتية. سيكون أي وضع جنسي هو الوضع المفضل للكاتبة. ستكون ألوان قمصان النوم، هي الألوان المفضلة للكاتبة. ستكون أي إشارة جنسية لا تحمل إلا معنى واحداً: الكاتبة هائجة تبحث عن رجل. بشكل أو بآخر، سيمارس العنف ضد المرأة بممارستها الكتابة. هنا يظهر الرقيب. الرقيب المجتمعي. العائلي. وبالتالي: الذاتي. والرقيب الذاتي سيحرم أي إشارة للجنس، رغم أنه فعل يومي مثل الأكل والشرب والنوم. ستشعر في نهاية العمل أن البطلة ليس لها حياة جنسية لأن الرقيب الذاتي أراد لها ذلك.
هنا نأتي لمصطلح أكثر قسوة لوصف ما حدث للإبداع: "الإخصاء الإبداعي". ربما تحدث نفس الأزمة مع الكاتب الرجل بدرجة أقل فداحة: لا يكتب مشهداً جنسياً عندما يصير أباً لبنات. يفكر كيف ستقرأ ابنته هذا المشهد. يفكر أنه لا يصح أن يهدي كتابه لمُدرّسة ابنته لأن مشهداً جنسياً سيؤثر على العلاقة بينهما. هل من الممكن أن يهدي جيرانه أو أقرباء زوجته رواية تحتوي على مشاهد جنسية، خصوصاً لو كانت المشاهد لعلاقة مثلية؟ أو تضم تفاصيل العملية الجنسية التي بالضرورة تخدم الإطار الدرامي للعمل؟ الأزمة أكبر مع المرأة، بالطبع، في نفس هذه المواقف.
الأدب للجميع مقولة في حاجة إلى مراجعة. لكن الذي يجب أن يراجع هذه المقولة هو الكاتب نفسه، الكاتب من داخل كتابته. وليراجع ذلك يجب أن يكتبه، وليكتبه ينبغي أن يتخلى عن رقيبه الذاتي، لندور في الدائرة نفسها: هل يجب أن يتغير المجتمع لتلقي الأدب، أم يجب أن يواجه الأدب المجتمع لإعادة صياغة مفاهيمه حول العمل الأدبي كعمل إنساني يناقش تفاصيل الإنسان في علاقته بالثقافة، بالعالم؟
هل لاحظت أن الكلام عن الرقيب الذاتي تركز على تابو الجنس؟ تابو السياسة خفت بشكل كبير. ربما يعود في الفترة القادمة إن ظهر مجدداً مقص الرقيب (ألم يظهر بعد؟). لا أظن، مع ذلك، أن مقص الرقيب سيكون شاغلاً أكبر للكاتب ليخلق لديه الرقيب الذاتي. مخالفتك السياسية والأيديولوجية للسلطة ليست عاراً. انتقاد السلطة السياسية الحاكمة لن يعرضك للسجن، ولو حدث فلن يسيء لك هذا.
سخريتك من النظام، من الاستبداد، من تفاهة حاكم، لن تكون، أبداً، مدعاة ليهجرك جيرانك أو لتغضب منك ابنتك المراهقة، لن تدفع أقاربك لمقاطعتك، رغم الانقسام الحادث الآن وسياسة الاستقطاب الحاد التي تعمل منذ سنوات. كونك كاتباً معارضاً، كل كاتب يعرف ذلك، هو واجبك، لأنك ككاتب يجب أن تكون على يسار السلطة، حتى لو كانت السلطة تمثلك أيديولوجياً. بالتالي، وجود رقيب رسمي لن يعني بالضرورة خلق رقيب ذاتي.
في المقابل، تابو الجنس، على عكس السياسة، يلحق العار بصاحبه، بحسب وجهة نظر المجتمع المتديّن الذي يتحرش بالفتيات في وضح النهار وأمام الكاميرات. ولو فلت من هذا الرقيب ساعة الكتابة، وبعد النشر، لن تتجرأ أن تهدي أعمالك لفئة معينة من الناس، من الأقارب أو الجيران والأصدقاء، الذين تعرف جيداً كيف يتلقون الأدب.
هنا تكمن المعضلة، المعضلة الممتدة: سيظل تابو الجنس يلاحقك حتى تقتنع تماماً أن الأزمة في "ثقافة المجتمع" وتلقّيه، وليس في كتابتك، وأن تغيير ذلك يحتاج لجهد وإيمان بالقضية. قضية الاعتراف. الاعتراف بأن البشر بشر وليسوا ملائكة، وأن الأخطاء البشرية، أو السلوكيات، جزء أصيل في إنسانيتنا. وأن الأدب ابتدعوه ليعبروا عن الإنسان وليس عن كائنات أخرى فوقية. هنا نتذكر "آنا كارنينا"، لصاحبها ليو تولستوي، التي أراد مؤلفها المحافظ أن يدينها، فأخذته الكتابة بعظمتها للتعاطف معها ومناصرتها، فأتبع ذلك تعاطف القارئ معها وليس اتخاذ موقف أخلاقي ضدها.
الرقيب الذاتي، وليس المجتمع، وليست العائلة، وليس الجيران، هو العدو الأول للكاتب، للكتابة، للإبداع. هو العقبة التي إن لم يتخطّها الكاتب بقناعاته، المبنية بالأساس على الشك في كل شيء والانطلاق من هذه النقطة لمساءلة الثقافة، سيُنتج عملاً باهتاً، الأفضل ألا يخرج للنور.
وفي مقابل بزوغ تابو الجنس، يتوارى قليلًا تابو الدين، رغم الحكم الصادر أخيراً على الكاتب كرم صابر بالسجن خمس سنوات لإهانة الذات الإلهية، وأزمة الروايات الثلاث التي وقعت مع بداية الألفية. ورغم قضايا الحسبة والإيمان المزيف للمجتمع، إلا أن الدين ليس عقبة كبيرة أمام الكاتب، فالمجتمع متدين، أو هكذا يصدّر، في ما يخص الجنس، لكنه يسبّ الدين بكل بساطة في الشارع والمواصلات العامة وطوابير الخبز.
فكّر أن المجتمع لن يعاقبك لو شكّك بطلك في وجود الله، أو لو سأله عن عدالته الإلهية الغائبة، في حين أن نفس المجتمع ستثار حفيظته لو قرأ مشهداً جنسياً فموياً أو ممارسة جنسية من الخلف. لا أشير إلى سلطة القضاء، بل إلى المجتمع كأفراد، كجيران وأقرباء ومعارف، وهي الكتلة التي تشكّل وتؤثر في تشكيل الرقيب الذاتي.
أخيراً، الرقيب الذاتي ابن مجتمعه ونتاج لمخاوفه، إذ أن المجتمعات التي تتمتع بالحرية الجنسية لن يمتلك كاتبها رقيباً ذاتياً لمراقبة ومراجعة المشهد الجنسي. وكلما كانت المجتمعات أكثر تحرراً، كلما كان كُتّابها أقل رقابةً لذاتهم. ولعل هذا آفة أخرى من آفات حارتنا.
* روائي من مصر