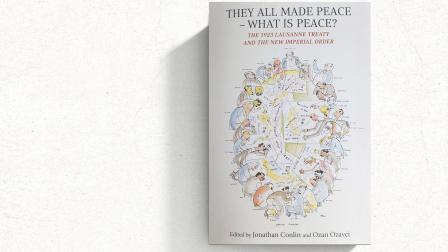بعد أيام قليلة على رحيل الشاعر الفلسطيني خالد علي مصطفى في منفاه ببغداد، في السادس والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، بدأ الحديث عنه كما لو أنه شاعرٌ عائدٌ من المستقبل، وليس ذاهباً إلى الماضي، فتحدّثت عنه هذه الصحيفة أو تلك الشاشة أو من عرفه في سنواته الأخيرة فقط، كما لو أنهم يتعرّفون عليه ولم يكن جزءاً من ذاكرة ثقافة، وبدأ الإعداد لإصدار أعماله الشعرية في وطنه فلسطين لأول مرة والتفكير بالذهاب إلى بغداد لتكريمه.
بالفعل، هو لم يكن جزءاً من ذاكرة ثقافته الفلسطينية، ناهيك عن ثقافته العربية، ولا وصلت أعماله الشعرية والنقدية إلى جمهور واسع على الرغم من إطلالته البارزة في الوسط الثقافي العراقي، حيث عاش لاجئاً منذ عام 1948، حين أصدر مع ثلاثة شعراء كان هو رابعهم بياناً شعرياً شهيراً في أيار/ مايو من عام 1969، ونشر على امتداد السنوات اللاحقة ستّ مجموعات شعرية، وثلاثة كتب نقدية تناولت الشعر الفلسطيني المعاصر، ونصوص السياب الأدبية المترجمة، وشعراء البيان الشعري، وعدداً كبيراً من المقالات والدراسات التي نُشر بعضها وظلّ بعضها الآخر حبيس الأدراج.
هذا الشاعر، مع ما رافق حضوره المغيّب وما يرافق الآن رحيله تحت الأضواء، يبدو منفياً نموذجياً من النوع الذي لم يتحدّث عنه أحد؛ أعني المنفي عن حضورين ظُلماً بالطبع: الحضور في وطنه والحضور في ذاكرة ثقافته. وإذا كان من المفهوم غياب أو تغييب اللاجئ عن وطنه بعد أن تعرّض ويتعرّض هذا الوطن لاستعمار/ استيطاني لا يتوقّف، فمن غير المفهوم غياب أو تغييب اللاجئ عن ثقافته الفلسطينية التي تتخطّى بطبيعتها غير المادية حواجز المحتلّين وحرّاس حدودهم.
هذه الثقافة التي استعادت حيويتها بعد سنوات قليلة من مرارات النكبة. أما تغييبه عن ثقافته الأكبر، أي العربية، فمسألة يتضاعف عندها عدم الفهم ويتحوّل إلى مأساة.
وضعية هذا المنفيِّ النموذجي لخّصتها وفسّرتها كلمات صديقه الشاعر العراقي سامي مهدي ذات يوم في مقالة تُعدّ من المقالات النادرة التي تحدّثت عنه تحت عنوان "في شعرية خالد علي مصطفى". قال عنه "شاعر فلسطيني مجتهد ومبدع، ولكنه مغبون على صعيد النقد والدراسة، فالنقّاد العراقيون يعدونه شاعراً فلسطينياً، على الرغم من عراقية شعره في خصائصه الفنية العامة ومن دوره المتميّز في حركة الشعر العراقي منذ ستينيات القرن العشرين، والنقّاد الفلسطينيون يعدّونه شاعراً عراقياً، على الرغم من أنه أعمق فلسطينية من كثيرين همّاً وشعراً.
وبقي حقّه مهضوماً بين هؤلاء وهؤلاء، لا ينصفه إلا نفر من زملائه الشعراء الذين يعرفون شعره ودوره وفلسطينيته وسماته العراقية. أمّا هو، فيبدو زاهداً في الأضواء، أو عازفاً عن التدافع بالأكتاف، لا يهمّه إلّا شعره".
ويضيف متحدّثاً عن طبيعة شعره: "لو بحثنا عمّا كُتب عن مجموعاته المنشورة لما وجدنا إلّا القليل، وأكثر هذا القليل عابر وسريع يقع على هامش الشعر، أو ينظر إليه من خارجه، فلا يتغوّره ويُعمل النظر والتأمّل فيه، ربما لصعوبة تلقّيه والتفاعل معه، فهو ليس شعر محافل ومنابر كأغلب الشعر الذي يُكتب عن فلسطين، بل شعر قراءة صبورة متمعّنة لا يصمد فيها إلا من يخلص لها".
خالد علي مصطفى ليس وحيداً في هذا المنفى المزدوج، فهناك فلسطينيون آخرون يشاركونه منفاه أيضاً، شعراء ونقّاد وروائيون. ولكنه، بحضوره فور رحيله وغيابه - وهذه مفارقة مدهشة - يدل على ظاهرة قلّما التفتت إليها الثقافة العربية؛ ظاهرة الذين يعودون من المستقبل.
ويكون هؤلاء العائدون عادةً ممّن تجاهلهم زمنهم لهذا السبب أو ذاك، أو اعتزلوه، وأيضا لهذا السبب أو ذاك، ولكن لأن ليس للإنسان من دليل إليه في أبدية ثقيلة الوطأة سوى عمله، يقيّض أحياناً لبعضهم أن يعود بعد غياب، ليس لأن زمنه تذكّره، فهو ذاهب معه، بل لأن هناك من نقّب في أزمان أخرى فعثر عليه مصادفة، أو بفعل يقظة على حاجة ملحّة تتخطّى أسوار الأزمان لأنها مما هو جوهري في مخيّلة ووعي الإنسانية.
مثل هذه اللحظة يصادفني الحدسُ بها الآن وأنا أحاول استعادة ما يبقى من ذكرى هذا الصديق والمعلّم والإنسان. منذ أوائل ستينيات القرن العشرين، أي منذ بداية معرفتي بهذا الشاعر، كنت ألمس لديه صرامة نقدية غير عادية في تمسّكه بالموروث الشعري إلى درجة الغرق في لججه، مفردات وصوراً واستعارات ورموزاً.. إلخ، بما في ذلك أوزانه الشعرية، سواء انتظمت على شكل باب من جناحين أو على شكل قوالب متناثرة تُدعى التفاعيل، وهو أمر كنت آخذه عليه، ولهذا كان من المفاجئ بالنسبة إليّ أن أراه يوقّع على بيان شعري يمتح من أقوال بيان السريالية الأول للفرنسي بريتون، وخاصة رؤيته للمستقبل حاملاً حلاً لمشكلة الديمومة يمزج الحلم بالواقع، يمكن أن يذوب في نمط من الواقع المطلق، ويؤكّد على أن الشاعر الجيد، حتى عندما يكون سياسياً، يحاول النظر إلى الأشياء كما لو أنه يراها لأوّل مرة.. وفي مواجهة العالم يحاول تجاوز انتمائه السياسي المرحلي إلى انتماء أوسع، إلى الأجيال كلّها.
وكانت المفاجأة الثانية مقالة له قرأتها تحت عنوان "جبرا إبراهيم جبرا شاعراً" ("الآداب"، الثالث من نيسان/ أبريل 1995) أنصف فيها شعرية لم تحظ بأي اهتمام نقدي، شعرية كما قال "أهملتها الدراسات التي تناولت الشعر الفلسطيني أو العراقي إهمالاً يكاد يكون مطلقاً".
وازدادت حدّة المفاجأة حين رأيت موضع مقالته وتحليله أبرز قصائد في مجموعة جبرا المسماة "تمّوز في المدينة"، وهي من نمط أصبح يُعرَف باسم قصيدة النثر. وسيستكمل هذا الانفتاح على الشعرية، متخلّصاً من متعلّقات الأوزان والقوافي، بل ومعتبراً أن الشكل الإيقاعي لا يمنح الشعر امتيازاً، في محاضرة لها في آب/ أغسطس 2018، تناول فيها شعر واحد من شعراء قصيدة النثر، وأكثرهم بعداً عن دوائر الاهتمام الجماهيري، سركون بولص.
في هذه المحاضرة، بدا خروجه على ماضيه الذي عرفتُه فيه كاملاً. جاء في هذه المحاضرة قوله "إن الإشارة أو الكلام عن الشكل الإيقاعي للشعر أو القصيدة لا يمنح الشعر امتيازاً، ليس ميزة بحد ذاته. يأخذ الشعر ميزته من قوة التصور الشعري في الموضوع، ومن دون هذا التصور فإن مستفعلن وفاعلن مجرد أصوات لا معنى لها".
ويمضي إلى التمييز بين ثلاثة أنواع من القصائد، الأولى "قصيدة الذاكرة"، ومثالها قصيدة الجواهري التي هي استرجاع لتاريخ القصيدة، والثانية "قصيدة العين"، ومثالها قصيدة البياتي التي يسجل فيها ما تراه عيناه، والثالثة "قصيدة التصور والخيال"، ومثالها قصيدة سركون بولص التي يرى أن شعريتها تبرز في قوّة التصور والتخيل.
وأجده يمنح "قوة التصور" من دور الصورة التي هي أيقونة كل الفنون، ويمنح الخيال سلطة تتخطّى الواقع إلى ما وراءه، إلى أن يصل إلى القول: "حين تصل قصيدة النثر إلى مرحلةٍ من قوّة التصوُّر لا يستطيع الوزن حملها يتفتّت الوزن".
وهنا رأيت ما سيكون، ولو على صعيد الموقف النقدي المضيء، طريق الشاعر خالد علي مصطفى إلى الحاضر قادماً من المستقبل. نبوءة أم مجرّد حدس؟ ربما كلا الأمرين معاً، أو تصديقاً للسطور الأولى في ذلك البيان الشعري الذي مرّ على صدوره أربعون ربيعاً، سطورٌ تقول: "تبدأ القصيدة تعاملاتها مع العالم من خلال افتراض جوهري ذي أهمية خاصة هو أن العالم ناقص وكذلك الموجودات والأشياء. وما دام كل شيء في حالة مستمرة نحو الولادة والموت، فإن من المستحيل البحث عن حقيقة ثابتة ضمن الزمان والمكان".
البصرة- حيفا
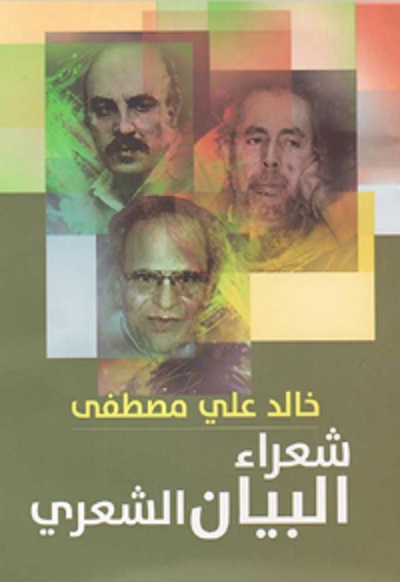
صدرت لخالد علي مصطفى (1939 - 2019) ستّ مجموعات شعرية؛ هي: "موتى على لائحة الانتظار" (1969)، و"سفر بين الينابيع" (1972)، و"البصرة - حيفا" (1974)، و"سورة الحب" (1980)، و"المعلّقة الفلسطينية" (1991)، و"غزل في الجحيم"، (1994).
ومن إصداراته الأخرى: "الشعر الفلسطيني المعاصر" (1979)، و"شاعر من فلسطين: مطلق عبد الخالق (1988)، و"من نصوص السيّاب الأدبية المترجَمة" (2011)، ويضم مجموعة من القصائد التي ترجمها السياب لعدد من الشعراء الغربيين، إضافةً إلى "شعراء البيان الشعري" (2015) الذي تناول فيه شعر زملائه الذي وقّعوا على بيان 1969 الشعري وهم سامي مهدي، وفاضل العزاوي، وفوزي كريم.