"في بلاد عسير" كتاب فريد من نوعه صدر في عام 1951 ليروي من بين ما يروي مشاهدات لصاحبه في "بلاد ما زالت أحوالها بكراً لم تكتسحها مؤثرات الحضارة الحديثة" كما يقول مؤلفه فؤاد حمزة. ويصادف القارئ ما هو أبعد غوراً من هذا، فتبدو له عبارة "أحوالها بكراً" عبارة ملطفة في وصف أحوال بلاد "مجهولة" بالنسبة للكاتب. ويضيف عن عادات قبيلة تدعى "ربيعة اليمن"، وهي بطن من بطون قبيلة عسير الكبرى أنها "همجية وغريبة وبعيدة عن أسباب الحضارة.. ما تزال في حالة البداوة، فتسكن في مغائر أو خشش بين الصخور، أو أكواخ مشيدة من الحجارة المرضومة المغطاة بالخصف أو بقطعة قماش، وقد يكون للكوخ باب صغير جداً يدخل المرء منه حابياً على ركبتيه، إذا لا أبواب ولا مزاليج ولا أقفال.. وتعيش القبيلة على تربية المواشي ولا تحسن الزراعة مطلقاً".
المؤلف صاحب بحوث في تاريخ الجزيرة العربية غير مسبوقة، وخاصة كتابه "قلب جزيرة العرب". وكان دعامة، كما يُعرّف به الناشر، من دعائم وزارة الخارجية السعودية، عرف أسرار الدولة وشارك في الكثير من أحداثها، وتعتبر كتابته من أدق المراجع التي تتحدّث عن الجزيرة العربية في النصف الأول من القرن العشرين.
جاءت رحلته إلى عسير في عام 1934 لحضور مؤتمر سياسي يماني/سعودي، إلا أنه اعتبر أن مهمته مزدوجة سياسية وأدبية. يقول "آليتُ على نفسي أن تكون رحلتي مزدوجة الفائدة من الناحيتين، السياسية بالعمل على إنجاح المؤتمر، والأدبية بتدوين مشاهداتي الجغرافية وجمع المعلومات التاريخية والاجتماعية عن أحوال ما أمرّ به من تلك البلاد البكر التي لم يكتب عنها إلا اليسير". ثم يخلص إلى أن كتابه ليس كتاباً "يبحث في السياسة، أو يشرح أسباب النزاع بين الملك ابن سعود والإمام يحيى، والحرب والمفاوضات والصلح، وما جرى خلال ذلك من أحداث جسام بين الحجاز واليمن، وإنما هو كتاب رحلة وجغرافيا وتاريخ واجتماع".
وبالفعل، نجده بعد بضعة سطور ينصرف إلى تدوين مشاهداته جامعاً بذلك بين ما شاهد من مظاهر اجتماعية وجغرافية وتاريخية وبين ما رواه له بعض من سكان هذه البلاد، ومازجاً كل هذا في ما يشبه وعاءً أنثروبولوجياً، عن أحوال أناس كانوا في نظره يعيشون في عصور تشبه عصور الإنسان الأول، حياة "بداوة" كما يقول، بطلها بدويٌّ هو حسب ما يكتب "كالبعير قد يكون أليفاً وقد يكون شروداً، وقد يكون ظريفاً حاضر البديهة خفيف الظل، أو يكون كسائر البدو جفاة عراة حفاة". ويلاحظ بعين عالم نفس أو قصّاص أثر أن البدو يشتركون "في غريزة الخوف من القوي والحذر من المجهول، والطمع الشديد، وكثرة السؤال والاستيضاح دون أن يمكّن البدوي مخاطبه من أخذ أخباره أو كشف أسراره".
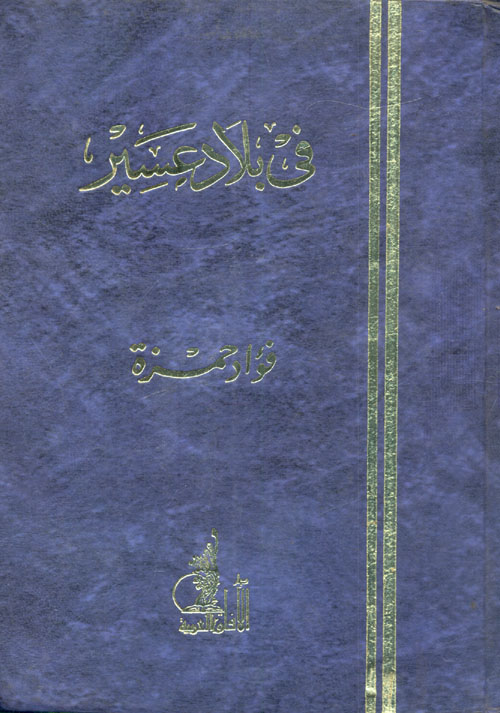 سنترك إذا جانباً أوصاف المنطقة الجغرافية وتضاريسها الجبلية ووديانها التي يُكثر منها، ونترك أسماء القرى والقبائل التي اعتنى بتدوينها، و"أسماء الأماكن والمواقع والآبار والأشجار والأخبار" التي جمعها "من الأدلاء والخبراء المرافقين أو المصادفين في الطريق"، ونكتفي بالجوانب الاجتماعية والآثار التي لاحظها ولفتت غرائبها نظره، وتخطّت أهميتها سياقها الزمني والمكاني.
سنترك إذا جانباً أوصاف المنطقة الجغرافية وتضاريسها الجبلية ووديانها التي يُكثر منها، ونترك أسماء القرى والقبائل التي اعتنى بتدوينها، و"أسماء الأماكن والمواقع والآبار والأشجار والأخبار" التي جمعها "من الأدلاء والخبراء المرافقين أو المصادفين في الطريق"، ونكتفي بالجوانب الاجتماعية والآثار التي لاحظها ولفتت غرائبها نظره، وتخطّت أهميتها سياقها الزمني والمكاني.
يبدأ ملحوظاته بوادي "رنية" وقراه، فيكتب: "حالة هذه البلاد الاجتماعية كحالة سائر البلدان المنعزلة عن العمران، لا تفكر في غير معيشتها المادية اليومية، وليست لها آمال أو أمان بعيدة، يستغلون الأرض بعد حرثها، ويزرعون النخيل، وينتظرون لقاء الله في الآخرة، ومن هنا نشأ عندهم عدم اهتمامهم بالتغيير والتجديد". وفي وادي "بيشة" يرى عند مبدئه "قرية عظيمة لم يبق منها إلا أطلال وخرائب هي بلدة "جرش" الوارد ذكرها في كثير من كتب العرب". وبالطبع لا يلفت وجود مثل هذه الخرائب ولا اسمها، سواء كان ذلك الذي يطلق على خرائب مماثلة في شرقي الأردن أو الاسم الذي ألصقه التوراتيون الصهاينة بمدينة أريحا الفلسطينية، لأن استقصاءات من هذا النوع لم يكن قد آن أوانها في ثلاثينيات القرن العشرين.
وكذلك الأمر مع سماعه بوجود خيبر في بلاد "شهران" في الطريق إلى "خميس مشيط". فيقول "عجبت من التسمية، لأنني كنت أجهل أن هناك خيبراً غير خيبر المشهورة بوقعتها التاريخية في صدر الإسلام، والواقعة إلى الشرق من المدينة المنورة". وأرض خيبر الثانية، خيبر شهران هذه، كما يقول "قد تكون أكبر من خيبر المدينة.. فيها رجوم وركام من الصخور السوداء.. وتقوم بالقرب من خيبر عدة جبال أهمها جبل شاع". وما علمه من أهل نجران عن بلادهم أعجب. يقول "يذكرون أن المعمور الآن من بلادهم يبلغ نصف ما كان في الزمن القديم.. وهناك مواقع شتى وجدوا فيها آثار فخار وآثار عملة ذهبية وتماثيل صغيرة معدنية كانوا يأخذونها ويبيعونها في صعدة، وتوجد أماكن فيها حجارة عليها كتابة قديمة لا يعلمون ما هي".
ومن وصف الآثار الداثرة، إلى وصف الأسواق الأسبوعية، ينتقل إلى ظاهرة السفور وعادات الزواج، فيلاحظ أن "من الأمور الجديرة بإمعان النظر في أهل هذه البلاد سفور نسائها واختلاطهن بالرجال، ولا فرق بين أن يكون الرجال من الأقارب أبناء البلد أو الغرباء والأجانب، وتشترك النساء في أحاديث الرجال في مجالسهم.. سواء كن أبكاراً أن ثيبات". وفي قضايا الزواج "لا يهتم أهل هذه البلاد بالكفاءة والنسب.. ويكفي أن يقع نظر الرجل على ابنة حسناء فيأتي إليها في السوق أو على البئر ويحدثها في أمر الزواج، ويمكنه أن يقول لها "أنا ميدك"، فإذا كانت راضية عنه تجيبه بأنها "ميده".. وقد تجيب أنها "ليست ميد" أي لا رغبة لها في الزواج".
ويخبر عن "الاختلاط الجنسي بين الرجال والنساء من الأبكار والثيبات" فيقول أنه "أرذل عادات ربيعة" مع أنه يستدرك ويقول: "وقد روي لي من ذلك روايات أخشى أن يكون مبالغاً فيها كثيراً بسبب التهم الشنيعة التي يوجهها بعضهم إلى هذه القبيلة وسواها من قبائل تهامة".
من ذلك هذه العادة الغريبة التي يسجلها وهو غير متأكد "فقد لا تتزوج البكر زواجاً شرعياً قبل أن تكون ولدت ولداً أو أكثر سفاحاً"، ويضيف "والظاهر أن كثيرين يرغبون في الزواج من البنت ذات الرقم القياسي في عدد أولاد السفاح.. ويسمى ولد السفاح عندهم ولد امهيجة" بلهجة أهل البلاد كما يقول في مكان آخر التي تستخدم "إم" بدل "أل" التعريف. والهيجة هي الغيضة أو الغابة في لغتهم. ويقول بعد هذه السطور "أما المتزوجات فإنهن محصنات لا يعرفن الباطل ولا السفاح.. ومجرد زواج البكر أو الثيب يلقي عليها ستاراً كثيفاً من الحصانة والحرمة والقدسية". ولا يقدّم تفسيراً لهذين السلوكين المتناقضين تناقضاً تاماً تجاه العلاقة بين الرجل والمرأة على طبق واحد.
وحين يتحدّث عن عمران عسير، يذكر غريب ما رآه بشأن زراعة البن الذي لا تزدهر أشجاره إلا على ارتفاع معين من سطح البحر، ولا تثمر أشجاره ولا تعيش إلا على السفوح الغربية لمرتفعات عسير واليمن، أما المرتفعات الشرقية فلا تنمو فيها أبداً. ويذكر أن العسل من منتجات عسير المهمة، ويعجب من "تكاثر النحل فيها تكاثراً عجيباً". ويلاحظ أن لا وجود للإبل في هذه البلاد نظراً "لصعوبة الأرض ووعورتها من جهة، ولضيق المراعي وشدة البرد من ناحية أخرى".
ويسجل أخيراً ملحوظات وقصصاً تتعلق بانتشار الخرافات في هذه البلاد، فهنا كما يقول "تنتشر عقائد وخرافات تجري في نفوس أهلها مجرى الدم". ومن أغرب ما روى له "استنطاق الموتى الذين يٌقتلون غيلة.. وزعمهم بأن في إمكانهم معرفة القاتل وتطبيق الجزاء عليه". فإذا اغتيل إنسان وأريد معرفة قاتله، قام أهله بمعونة سحرة وكهان بربطه إلى سلم عرضا "وحملوه إلى مكان بعيد بين الجبال.. وعلقوا السلم على شجرة، ثم يختبئ شخص في حفرة تحت الشجرة تغطى بصخرة إلا من فتحة صغيرة، فإذا جن الليل هبط طير يشبه النسر وحط على الشجرة مقابل الميت، وتبدأ عملية الاستجواب والاستنطاق"، وتنتهي العملية بعد ذلك بطرد الطير بعد أن يكون المختبئ عرف ما يريد، ويعود الميت إلى حاله، لا يتكلم ولا يتحرك.
الطريف أن القتلة الذين يعرفون بهذا الإجراء الذي يفشي سرهم، يعمدون إلى قطع ألسنة من يغتالون ليصبحوا عاجزين عن النطق حينما يستجوبهم النسر.
وهنالك ما يعتقد الكاتب أنها خرافات، وهي ليست كذلك في ضوء ما تكشف في النصف الثاني من القرن العشرين، ومن ذلك قوله: "من الخرافات والاعتقاد السائد بينهم بشأن الكهف المجاور لجبل "تمنية" زعمهم أن فيه ثلاث جثث كبيرة لأناس ماتوا منذ قرون، غير أن أجسادهم تجمدت وظلت على حالها، وأن كل من رأى هذه الجثث أصيب بشيء لا يستطيعون أن يقروه أهو خير أم شر".
والحديث هنا يدور كما تبين في ضوء الكشوفات الأثرية عن مومياءات في كهوف جبلية، دلت على وجود فن التحنيط الذي كان يجيده سكان هذه البلاد "المجهولة" في عرف الكاتب، التحنيط المماثل إلى حد ما لتحنيط الموتى في أرض قبط، أو مصر القديمة كما أصبحت تعرف لاحقاً، بالإضافة إلى اكتشاف أن المصريين القدماء كانوا يجلبون مواد التحنيط من اليمن، وأنهم كانوا ينظرون إلى اليمن، بلاد بونت التي يجلبون منها المر واللبان والبخور، بوصفها أرض الأسلاف المقدسة.



