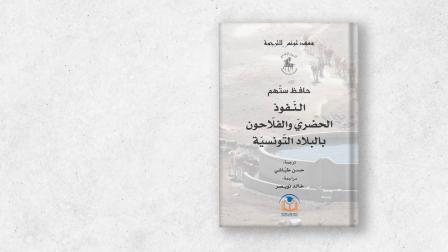يمضي المفكر المغربي محمد المصباحي في كتابه المعنون بـ"الذات في الفكر العربي الإسلامي"، (إصدارات "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، 2017) بعيداً في رحلة البحث عن هذه الذات، رغم أنه أكد منذ مقدمة كتابه النتائج التي سينتهي إليها، من أن الذات التي تحدثت عنها تلك الفلسفة لا تشير حقاً إلى الهوية الفردية، ليسجّل بذلك استحالة الحديث عن "الأنا المفكرة" بالمعنى الديكارتي في التراث الفلسفي للإسلام.
ويبدو منذ البداية أن اهتمام المصباحي بسؤال الذات في الفلسفة الإسلامية القديمة مرتبط بسؤال الذات اليوم في المجال العربي، هذه الذات التي كما يصفها في دقة "تقبل التحديث من دون الحداثة، والتحرّر من دون الحرية..". طبعاً لا بد هنا أن نسجّل أن فشل الذات العربية اليوم لا علاقة له بغيابها في الفلسفة الإسلامية، أو انحسارها في مجال المطلق، لأن من شأن الاعتقاد بمثل هكذا علاقة أن يجعلنا نظلم ذلك التراث من جهة، ونخطئ الطريق لبحث الأسباب الحقيقية لفشل الذات العربية اليوم، حتى وإن كان نسياننا لذلك التراث، ليس من باب النسيان الخلاق، الذي يربطنا بالحياة، كما تحدث عنه نيتشه في الاعتبار الثاني من "اعتبارات في غير أوانها".
ولكن إذا طلبنا تلخيص نتائج كتاب محمد المصباحي ورحلته المضنية والممتعة في آن، فإنه يمكننا أن نقول عن ثقافة الإسلام الأمر نفسه الذي قاله نيتشه في "ما وراء الخير والشر" عن المسيحية: إنها أفلاطونية للشعب. ولربما كان أحرى به أن يقول بأنها أفلاطونية ضد الشعب، هذا إذ صح الحديث عن شعب في سياق الثقافات الوسيطة. وتتجلى هذه الأفلاطونية على مستويات وفي مواقف أساسية، الموقف من الجسد، من الغريب والمختلف ومن المرأة.
فمنذ ابن سينا، نقف على أنه لا يمكن إثبات وجود الذات إلا عبر نفي الجسم والعالم المادي، وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه أفلاطون في الجمهورية مطالباً بعدم الاهتمام بالجسد لأنه معرّض للفناء، والاهتمام فقط بما لا يفنى. وقد سجّل المصباحي منذ بداية كتابه بأن "كبار مفكرينا كانوا يطرحون سؤال الذات الإنسانية (سواء أخذت بمعنى الجسم أم العقل أم القلب) بقصد التحايل عليها لربطها بالذات المطلقة"، وقد ترتّب عن ذلك برأيه "تأجيل النظر في الذات السياسية، وبالتالي في موضوع الحرية" الفردية.
ومن أجل توضيح ذلك، يسلّط المؤلف الضوء على نظرة الحداثة للذات، هي التي اعتبرت أولاً بأن "الجسد، بلغة ديفيد لوبروتون، "بيت الذاتية"، أو هي التي فصلت -في لغته دائماً- "لحم الذات عن لحم الكوسموس"، ثم هي التي ربطت العقل بـ "الأنا أفكر"، وقطعت الطريق على "معرفة ميتافيزيقية مطلقة"، وعلى ما كان يسميه روجيه غارودي ساخراً: "إله الثقوب"، ونادت بالمرجعية الذاتية للعقل، أو ما سمي في الحداثة الفلسفية بمبدأ العقل المكتف بذاته، وفصلت في النهاية مجال الشريعة الإنسانية عن مجال الشريعة الإلهية.
سيتحدّث المصباحي في كتابه عن آليات التفكير الثلاث في الثقافة الإسلامية: البرهان والعرفان والعمران، وسيؤكد من خلال دراسته للتصوّف الإسلامي، بأنه يمثل نفياً مزدوجاً للعالم وللذات، بل وسيرى أنه رغم اختلاف الرؤى بين الفلسفة والتصوّف، فموضوعهما لم يكن الطبيعة ولكن ما بعد الطبيعة، وسنكتشف مع ابن باجة فيلسوفاً يطلب اعتزال المجتمع، فمتوحّده يعيش من أجل ذاته، وعكس الفارابي، يطلب السعادة خارج المدينة، في حين سيحتقر ابن طفيل الجسد، ويرى أن تحقيق الذات مرادف لفنائها في ذات الحق.
ولربما تكون أهم فصول الكتاب، هي تلك التي أفردها المصباحي لابن خلدون ورؤيته العمرانية، وقد نقول بدون مبالغة، بأن التفكير الواقعي في الإسلام والذي وُلد مع الفقه، سيبلغ ذروته مع ابن خلدون، الذي فهم الإنسان باعتباره كائناً تاريخياً، حتى وإن كان أشبه برجل يقدم رجلاً ويؤخر ثانية، ولهذا كان الجابري لا ريب على حق، وهو يكتب في نهاية "نحن والتراث" بأن "الخلدونية ليست ما أنجزناه ولكن ما يجب أن ننجزه"، أو لربما ما لا يجب أن ننجزه!
فتشكيك ابن خلدون بالعقل لن يسمح له باكتشاف الذات، بل سيعمد للمطالبة بإخضاعها للشرع، هذا "العقل الكبير" للثقافة الإسلامية، والذي تتبدى سيطرته المطلقة من خلال العمل الفكري لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي، وخصوصاً لمعاني الحق لديه، ولكن المصباحي يحذرنا منذ البداية من أنه "في البيئة الثقافية والفكرية والعقدية التي يكون فيها حق الله أولى من حق الإنسان، وحق الجماعة أجدر من حق الفرد، وحق الدولة أحق من حق الفرد، لا يمكن أن تنبثق وتزدهر فيها فكرة حق أو حقوق الإنسان، بل أن الثقافة التي تعتبر العبودية، بأشكالها ومقاصدها المختلفة، ودلالاتها الحقيقية والمجازية، قيمة إيجابية، وحقاً مشروعاً، ينظمه الفقه الإسلامي بعناية بالغة، الثقافة التي تفضّل أن تسمي الإنسان عبداً، لا صورة لله أو خليفة في أرضه، لا يمكن أن تنتظر منها شيئاً كثيراً في ما يخص الدفاع والتنظير لمبادئ حقوق الإنسان".
وقد تحدث الغزالي أيضاً، ولا عجب، عن قهر الجسد كطريق إلى الحرية، كما سيكرر الموقف الأفلاطوني من أصحاب الآراء المعارضة أو المختلفة، فيكتب بأن "المبتدع مستحق للهجر والمقاطعة". إنه كلام أفلاطون في "القوانين" عن المسافر الذي عاد بعد رحلة طويلة إلى أرضه وناسه، ولكنه عاد محملاً بعادات أجنبية، مما جعل أفلاطون يطالب بهجره وإبعاده عن الناس، بل وبقتله إن لم يلتزم بذلك.
وحتى في حديثه عن الصحبة والأخوّة، وفي انسجام مع سياجه الدوغمائي المغلق، لا يفهمهما الغزالي إلا وفقاً لمنطق الشبيه، وهو هنا كان أبعد ما يكون عن التوحيدي في "رسالة الصداقة والصديق" وأستاذه أرسطو في "أخلاق نيقوما"، كما كان أبعد عن الموقف المنفتح لابن عربي من أتباع الديانات الأخرى.
 إن الحق عند الغزالي ديني وكذلك الصحبة والأخوة، ولكن يتوجب لربما هنا تأكيد أمر، وهو أنه لا يجب أن نعني بالديني هنا القرآن والسنة، ولكن الطريقة التي فهمت بها الأورثذوكسية السنية هذه المصادر المؤسسة. وقد يكون من سبل وشروط التأسيس لذات عربية مستقلة، قراءة هذه المصادر الدينية انطلاقاً من الحداثة وإنجازاتها الإيتيقية، وليس انطلاقاً من التراث، فالموقف التراثي، ودون مبالغة، لا أخلاق له، وهو ما يلخصه بوضوح موقف الغزالي من المختلف، من الجسد ومن المرأة. ولقد كان ابن رشد واعياً بذلك، كما أوضح المصباحي، وواعياً بأننا نقف أمام أزمة تديّن وليس أمام أزمة دين، وعلى الرغم من أنه لم ينظر إلى الدين في حدود العقل.
إن الحق عند الغزالي ديني وكذلك الصحبة والأخوة، ولكن يتوجب لربما هنا تأكيد أمر، وهو أنه لا يجب أن نعني بالديني هنا القرآن والسنة، ولكن الطريقة التي فهمت بها الأورثذوكسية السنية هذه المصادر المؤسسة. وقد يكون من سبل وشروط التأسيس لذات عربية مستقلة، قراءة هذه المصادر الدينية انطلاقاً من الحداثة وإنجازاتها الإيتيقية، وليس انطلاقاً من التراث، فالموقف التراثي، ودون مبالغة، لا أخلاق له، وهو ما يلخصه بوضوح موقف الغزالي من المختلف، من الجسد ومن المرأة. ولقد كان ابن رشد واعياً بذلك، كما أوضح المصباحي، وواعياً بأننا نقف أمام أزمة تديّن وليس أمام أزمة دين، وعلى الرغم من أنه لم ينظر إلى الدين في حدود العقل.
لكن قد يكون استغناؤه عن القيام بذلك أهم بالنسبة لنا اليوم من الموقف الكانطي، شرط أن نترجمه سوسيولوجياً، فننظر إلى التديّن، وليس إلى الدين، في حدود العقل، فالسؤال الذي يلح علينا اليوم، إيتيقي وليس معرفيا، ومشكلة دار الإسلام: سياسية وليست لاهوتية.
في آخر فصل من فصول كتابه، يتحدّث المصباحي عن حضور الفلسفة الأندلسية في الثقافة العربية المعاصرة، وخصوصاً محاولات استعمال ابن رشد في المعركة من أجل الحداثة، وهي قضية كانت المستشرقة الألمانية آنكه فون كيكلغن قد أفردت لها كتاباً كاملاً، يتتبع في دقة تفاصيل هذا الاستعمال الأيديولوجي لفيلسوف من القرون الوسطى في الفكر العربي المعاصر، لكن ما يتثير الانتباه في هذا السياق هو موقف طه عبد الرحمن، الذي يرى أن ابن رشد لم يسع إلى تكييف لغته مع لغة القرآن، وهو حين يقول ذلك، ينصّب نفسه قيّماً على لغة القرآن من جهة، ويختزل القرآن في لغة واحدة، كما لو أنه لا يدرك بأننا نقف في القرآن على لغات متعددة، أننا أمام نص بوليفوني، هو نتاج حوار مع السياق التاريخي والثقافي للعصور القديمة المتأخرة، كما أوضحت ذلك الباحثة القديرة أنغيليكا نويفيرت.
لكن طه عبد الرحمن، مثل سلفه الغزالي، يغلق ولا يفتح، في حين كان ابن رشد واعياً، كما ذكر المصباحي في كتاب آخر، بأن الثقافة الإسلامية وحدها ليست كافية البتة، حتى لفهم الإسلام نفسه، لهذا احتجنا إلى أرسطو، واليوم إلى الحداثة. بقي أن ننبّه إلى أمر: حتى إذا لمسنا تعاطفاً لدى المصباحي مع فلاسفة مثل ابن باجة وابن طفيل وابن رشد، هو "المتوحد المعاصر"، فيجب أن نعي، بأنه تعاطف لا يختلف كثيراً عن ذلك الذي عبَّر عنه فيلسوف معاصر تجاه الميتافيزيقا في لحظة سقوطها الأخيرة.