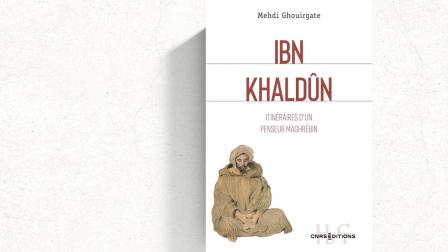في نيسان/ أبريل الماضي، ومع نشر "دار أزمنة" الأردنية بنشر الأعمال القصصية للروائي غالب هلسا (1932 - 1989)، بعد مرور ثلاثة عقود على رحيله المفاجئ، عادت إلى الذاكرة سيرة حياةٍ أكثر ممّا عادت كتابات راحل توزّعت بين الرواية والقصّة والدراسات النقدية.
الغيابُ هو السمة الأبرز لما هو أثمن من مجرّد حياة من ورق؛ حياة خرجت على الأمكنة، على هذه العاصمة أو تلك، وتحصّنت في الأعماق من قلب إنسان. في هذه الأعماق كانت العاصمة الحقيقية، عاصمة يشغلها أناسٌ يعايشهم، ويتأمّل ملامحهم ويصغي إلى أصواتهم، صامتاً في أغلب الأحيان كمن يدير حواراً بين ذاته وذاته، موضوعه العالم من حوله من دون أدنى شك، ولكن ليس بالطرق المعتادة.
وحين يخاطب شخصاً عابراً، أو جالساً في زاوية أو منتدى، أو شجرة على جانب الطريق، لم يكن هو موضوع الخطاب؛ لا أخبار المعتقلات التي أُخذ إليها، ولا ليالي الإبعاد التي طوّحت به من بلد إلى آخر، بل هذا الذي يُدهشه أن يجده قادراً على السهر، أو شجيرة السيسبان التي يكتشفها على جانب الطريق، أو هذه الطفلة التي نبّهته عفويتها إلى خاصية فنية لم يدركها إلا كبار الفنانين.
لم تكن قصصه القصيرة، ونماذجها، "زنوج وبدو وفلاحون" و"البشْعة" و"وديع والقدّيسة ميلادة وآخرون"، التي جُمعت أخيراً في كتاب، هي الأكثر تركيزاً من رواياته فقط، بل والأكثر حيوية، بما يذكّر بمنح الأمكنة والناس هوية بصرية. لغتها هي لغة تجمع كلماتها بين الصورة والحركة، كما في الكتابة التصويرية الصينية، حيث لا كلمات مجرّدة، ولا صفات، ولا أسماء، بل أفعال تتحوّل إليها حتى الصفات والأسماء والمعاني. كل شيء في الطبيعة حركة تؤدّي إلى أخرى، فأخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا هو الفن حين يتحوّل إلى أسلوب حياة.
وأظن أن غالب كان يعيش أسطورة خاصّة به، لم يصرّح إلّا بالقليل عنها، وبكلمات كانت تبدو أشبه بمكتشفات يظل يتأمل فيها بعمق. كأن يفاجئك بملاحظة أن الإنسان العربي في القصص القديم كان يمتلك بيتاً دائماً، مع أنه لم يكن يجد قوت يومه. فيقول: "تصوّر أنه يخرج من بيته باحثاً طيلة النهار عن طعام فلا يجد، ولكنه يعود في النهاية إلى بيته.. كان لديه بيت دائماً".
والبيت أوّل شرط من شروط الحياة، وهاجسه الذي لم يفارقه، كما سيتجلّى في ذهابه إلى كتاب غاستون باشلار؛ "جماليات المكان" وترجمته، كما سيتجلّى في ذهابه إلى رواية "الحارس في حقل الشوفان" لـ جيروم سالنجر وترجمتها.
 في "جماليات المكان"، وجد غالب مسألة كانت تلح عليه كما كتب في مقدّمة هذا العمل: "مسألة المكانية في الرواية والقصة العربيتين. النص الأدبي حين يفتقد المكانية فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته". وفي "حارس حقل الشوفان" يرى أن حلم الصبي هولدن كولفيلد كان أن "يعيش في كوخ على طرف غابة حيث لا يلقى أحداً من البشر". ويبدو أن السؤال الذي سأله كولفيلد وشغل ذهنه عن "المكان" الذي يذهب إليه بطّ بحيرة المتنزّه حين تتجمّد مياه البحيرة، هو الأكثر جاذبية في هذه الرواية من حيث أنه رمز لحالته هو بالذات، وحالة غالب في سؤاله عن "بيت" بدا وجوده أمراً محالاً في الوضعية العربية الراهنة.
في "جماليات المكان"، وجد غالب مسألة كانت تلح عليه كما كتب في مقدّمة هذا العمل: "مسألة المكانية في الرواية والقصة العربيتين. النص الأدبي حين يفتقد المكانية فهو يفقد خصوصيته وبالتالي أصالته". وفي "حارس حقل الشوفان" يرى أن حلم الصبي هولدن كولفيلد كان أن "يعيش في كوخ على طرف غابة حيث لا يلقى أحداً من البشر". ويبدو أن السؤال الذي سأله كولفيلد وشغل ذهنه عن "المكان" الذي يذهب إليه بطّ بحيرة المتنزّه حين تتجمّد مياه البحيرة، هو الأكثر جاذبية في هذه الرواية من حيث أنه رمز لحالته هو بالذات، وحالة غالب في سؤاله عن "بيت" بدا وجوده أمراً محالاً في الوضعية العربية الراهنة.
ويبدو أنه كان هارباً مثل كولفيلد، باحثاً عمّا يمنحه "خصوصية" و"أصالة" يتوق إليهما، واعياً بأنه حرٌّ بالفعل، ويعي لماذا وكيف حقّق حريته، من دون اللجوء إلى النظريات. كان حرّاً في فكره وانتمائه بمجرّد تخلّيه عن الأماكن التي تستعبد المثقّفين عادةً، وقد تصل بهم إلى الانحدار إلى مستوى قضاء أيامهم في مراقبة أرصدتهم في المصارف، والتباهي بعدد المهرجانات الباذخة التي فتحت لهم أبوابها.
هل يمكن لأي عاصمة أن تسلب إنساناً من هذا النوع أثمنَ ما فيه؛ كرامته؟
في هذه الوضعية، لم يكن غالب ذاهباً إلى منفى أو قادماً من منفى. هذه كلمة تجرّدتْ من معانيها لديه، كانت لديه خريطته، وحين يتحدّث عن مرابع طفولته مثلاً، يؤشّر فيها إلى أماكن غير موجودة على الخريطة المعروفة، كانت له مرابعه الأخرى التي لا يتطرّق إليها الخراب الماثل؛ الناس الذين أحبّهم وعايشهم في سنوات الطفولة والدراسة والحياة الحزبية، والذين يجتهد لاستنقاذهم من العدم.
خريطة تمنحه أمكنتها خصوصيته وأصالته، ولا تبدو علامات الحاضر عليها إلّا أطيافاً أو أشباحاً عابرة. أعتقد من بضع كلمات تحضرني، أنه كان يرى في الأمكنة الزائفة والملفّقة سجوناً تخلّص منها، وما عاد يطيق التفكير لحظة واحدة في أنه يمكن أن يعود إلى أي واحد منها.
لقد تكوّن خارج هذه الأمكنة، ليس في القاهرة تحديداً حيث درس وعاش زمناً، وليس في بغداد التي رأى لها ثلاثة وجوه، ولا في بيروت حيث حاول أن ينتمي فلم يجد مكاناً، ولا في دمشق التي راودته فيها وحدته، بل في عاصمة ما في أعماقه، وظل ينظر إلى ما حوله مثلما ينظر الطائر المائي إلى مياه البحيرة المتجمّدة، ويتساءل عن المكان الذي يمكن أن يمضي إليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصص تصل متأخّرة
تضمّن كتاب "القصص الكاملة" مجموعتَي "وديع والقدّيسة ميلاه وآخرون" و"زنوج وبدو وفلّاحون". ألّف الكاتب الأردني المجموعة الأولى بعد انتقاله إلى مصر سنة 1955، لكنها ستصدر بعد حوالي ثلاثة عشر عاماً، وانتهى من الثانية سنة 1957، ولم تُنشَر حتى سنة 1976. عن ذلك يقول: "أخجل من التعبير عن نفسي بوضوح، والأغلب أن هذا هو السبب في أنني لم أنشر أعمالي إلّا بعد كتابتها بفترة طويلة جدّاً".