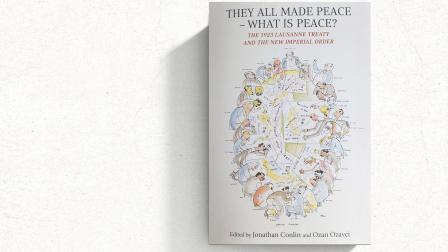في فترة تبدو أنها تفتقر إلى الرغبة بمعناها الأوسع، تنادت كل المشاهد دُفعة واحدة، من فيلّليني إلى جحيم دانتي، سيرة من الفجائع الطويلة التي حلّت بإيطاليا، إلّا أنَّ هذه المرّة كانت وطأة الألم أكبرَ ممّا يمكن أن يتحمّله شعب واحد، فاتحدت الشرفات في كثير من بقاع العالم، تتعاطف، تغنّي، وتشارك في الليل الطويل الذي أسدل ستاره فجأة على كل مكان، حتى في وضح النهار.
ربما لم يحظ شعب بمثل هذه المحبّة التي حظي بها الشعب الإيطالي في هذه اللحظات العصيبة، فالإرث الذي يحمله، منذ الإمبراطورية الرومانية وحتى اليوم، لم يقتصر على هذه البقعة الجميلة فحسب، بل انتشر بين كافة شعوب العالم، من الأطعمة والأزياء والفنون والآداب، وفوق كل شيء "الكالتشو"(الدوري الإيطالي).
حتى أن طريقتهم في تجاوز الأزمات، رغم ما يتخلّلها من فضائح وسوء إدارة، تبعث على الحيرة في معظم الأحيان. هم يطلقون على ذلك "العبقرية الإيطالية"، إنما نرى فيها نحن نوعاً من التقاليد السياسية والثقافية العريقة التي تراكمت على مرّ السنين، لتكون في النهاية أسوة بميناء آمن، يعرف الجميع أنه مهما اشتدّت العاصفة، فسوف يصلونه بسلام.
وفي هذه الفترة، نقرأ الشِّعر ليس كشهادة فحسب، إنما كوسيلة لدعم ركائز الأنفاق التي تؤدّي إلى متعة العيش. نقرأ الشِّعر أيضاً كوسيلة للارتقاء إلى ما وراء الألم والصرخات والسحب والبحار. ولكن متى يمكن للإنسان أن يصل إلى الملاذ الصامت؟ أهي الفاجعة التي تحدّد مدى ارتقائه، أم أنّ الغريزة، مهما تشبّعت عقولنا بمستجدّات الحضارة والتأقلم مع عادات جديدة، تفرض نفسها علينا لنرجع ونكون كما كنّا، أن نتحمّل أهوال البرد والصقيع وهجوم الحيوانات المفترسة ومختلف أنواع الكوارث، لأن كل هذا يشكل جزءاً لا يتجزّأ من حياتنا؟ وإذا كانت هذه السفينة في طريقها إلى الغرق، فلماذا لا نعرف كيف ننقذها؟
إنها الأسئلة التي تراودنا الآن، في عزلتنا المباغتة، ولا نجد جواباً لها، فكلّ واحد منّا يعيش عزلته الخاصة، والأفكار ليست استثناء. تتوارد الأخبار تباعاً، مخيفة وتدعو إلى الهلع، كما حدث في العشرين من آذار/ مارس الماضي، عندما نقلت الشاحنات العسكرية، ولمدة ثلاثة أيام على التوالي، مئات من ضحايا فيروس كورونا من مستشفيات بيرغامو وكريمونا في مقاطعة لومبارديا لتتحوّل إلى رماد في أفران الجنوب الإيطالي، أمام ذهول العالم بأسره. حتى أن الناس هنا لم يمتلكوا الوقت ليعبّروا عن دهشتهم، ولم يستطع المقرّبون والأصدقاء إلقاء نظرة أخيرة على أحبائهم.
يوم حالك سيبقى طويلاً في ذاكرتنا الجمعية. مأساة قلّما يمكن وصفها مهما اتّسعت آفاق وتشعّبات اللغة.
سيموني سيبيليو، الشاعر والبروفيسور المساعد في اللغة العربية وآدابها، أمسك تلك اللحظات في هذه القصيدة التي ألقاها ضمن فعاليات "يوم الشعر العالمي" على وسائل التواصل الاجتماعي.
حتى التوابيت
على الطرق الترابية، مذهولة ومضطربة، ينقلونها
عبر الحقول والغابات،
فقد باتوا أقلَّ تسامحاً الآن، الحطّابون والفلّاحون،
حتى أنها تسلك سهولاً من الرمل والحصى،
منسيّة، تهوي في طيّ النواقيس الصمّاء.
ضاعت التوابيت، من الجسد الذي يحتضنها انْتُزِعَتْ
ومن دموع الأحبّاء.
حتى التكريم لكل مغيب يصانُ،
لن ينالوا،
فينحسر عند ذلك القلق من صمت الإنسان،
وتخبو النداءات اليائسة لمن كانوا ذويهم.
وعوداً أبدية تَهِبُ،
فاربطوا وحلّوا بأيّ ثمن كان.
لن تجد مأوى لها التوابيتُ.
* كاتب ومترجم سوري مقيم في ميلانو