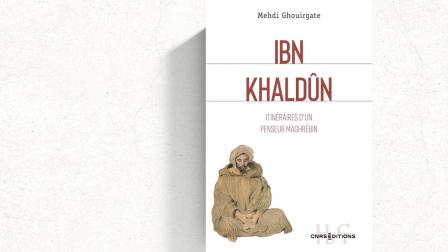لعل المنعطفات التي تتخذها مسالك التاريخ هي التي حفّزت على ظهور علم المستقبليات. هذا البناء الفكري الجديد الذي يتكئ على معطيات عدد من العلوم كالجغرافيا والاقتصاد والإحصاء وعلم الاجتماع والعلاقات الدولية، ليقدّم في ما بعد مجموعة من السيناريوهات لما سيحدث في المستقبل.
ورغم أن العالم العربي يشهد اليوم منعطفاً تاريخياً حاسماً، أتى برهانات المستقبل إلى واجهة التفكير، إلا أن الحديث عن المستقبل يبدو خافتاً اليوم في مقابل ظهور نزعة الكتابة في المستقبليات قبل ذلك بسنوات.
هذه المفارقة تجعلنا نخمّن بأن هذا العلم لم يهضم فكرياً عندنا بعد، بل وصل العالم العربي بادئ الأمر مثل عدوى فكرية انتقلت كالنار عبر هشيم العولمة. لذلك قد نتحدث عن مستقبليين عرب، ولكن يصعب الحديث عن علم مستقبليات عربي.
طويلة هي قصة علم المستقبليات إذا بدأناها منذ أن بدأ الفلاسفة (والكهنة قبلهم) يتوقّعون. في غياب الوسائل، كانت المحاولات عبارة عن رؤية كما لدى فرانسيس بيكون، أو استنتاجاً فوقياً كما لدى هيغل، أو تطبيقاً لقانون صيغ لتوّه كما لدى ماركس. مع هؤلاء، أصبح التنبؤ بالمستقبل هاجساً فلسفياً، بقي أن يصبح علمياً.
ظهرت تسمية "علم المستقبليات" في ألمانيا في بداية ثلاثينيات القرن العشرين، مع جيل من العلماء تأثر بعمل "تدهور الغرب" (1917) لـ أرنولد شبينغلر، أول من تجرأ على الحديث في المستقبل بناء على سيناريوهات تنطلق من الحاضر، فحاول جيل الثلاثينيات تطوير منهجه في الاتجاه العلمي.
وافق ذلك الخطط التوسّعية التي رسمها النازيون. خطط كانت تحتاج لعلم يكشف "الغيب" لهم. وكانت العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة علم الجغرافيا السياسية قد تطوّرت إلى درجة مكنت من ظهور هذا العلم بيسر في تلك الظرفية. غير أن أحلام الألمان سرعان ما تهاوت بسقوط الرايخ الثالث، فتناثرت هذه المحاولة الأولى في إثرها، ولم يبق سوى نظرياتهم التي سيتلقفها عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية ويستند إليها لتطوير هذا العلم المثير.
في أميركا، ستترعرع المستقبليات مرة أخرى، وكأن هذا العلم يحتاج إلى روح توسعية كي يزدهر. وبعد أن انشغل الروائيون ثم السينمائيون بالمستقبل، ظهرت في السبعينيات موجة من العلماء يتصدون لأسئلة المستقبل، حتى أن نهايات الحرب الباردة بدت مثل مزرعة تفريخ لنظريات المستقبل.
ظهرت أفكار النهايات المثيرة؛ "نهاية التاريخ والإنسان الأخير" لـ فرانسيس فوكوياما و"نهاية العمل" لـ جيريمي ريفكين، وتكرّست "نظرية حضارة الموجة الثالثة" لألفين توفلر، فيما بلور صامويل هيتنغتون نظرية "صدام الحضارات" التي صارت أداة رئيسة في تفسير الكثير من مسائل العلاقات الدولية وعلى رأسها الإرهاب. حصل جميع هؤلاء المستقبليين على نجومية شبيهة بنجومية أبطال السينما أو رواد التنمية البشرية.
في العالم العربي، سرعان ما تهافتت الترجمات على هذه الظواهر الأميركية، بل تحوّلت القضايا المطروحة إلى أهم ما يشغل العالم العربي وأصبح الحديث عن العولمة وما بعد نهاية التاريخ أمراً دارجاً في المقالات الفكرية، وهو أمر يقع ضمن وضع عالمي عام، وكأن الأميركان أخذوا بفضل هذا العلم زمامَ التفكير عن العالم.
بعد موجة الترجمة والمقالات، بدأت عدة مؤلفات في مجال المستقبليات في الظهور عربياً. تحوّل الكثير من المفكرين العرب من اختصاصاتهم الأصلية إلى هذا العلم أو تقاطعوا معه مثل المغربي مهدي المنجرة واللبناني جورج قرم. لم تكن منطلقات المواضيع عربية، بل كان العالم العربي أرض تطبيق لا غير، وكأن دافع هذا الشغل هو إرادة ملء فراغ، أو محاولة التبشير بعلم جديد.
لا يمكننا سوى قراءة هذه الأعمال في سياقها، لقد كان العالم العربي منقوصاً من مناخ عام وبيئة مشجعة لبلورة فكر مستقبلي يقدّم ما يُنتظر منه، فعلم المستقبليات علم توليفي، يحتاج إلى معطيات من عدة علوم أخرى. فإذا كانت البحوث الاقتصادية قاصرة في وضعيات العالم العربي، كيف يمكن تطبيقها؟ وإذا كانت الأرقام الإحصائية غير متوفرة أو منقوصة أو مغالطة، فهذا يعني أنه قد تم قطع الطريق على الباحث العربي في المستقبليات.
أكثر من ذلك، هل نستغرب من الأنظمة العربية إذا وضعت يدها على "خبراء" في هذا العلم أن لا توظفه لمصالحها؟ وهل يمكننا أن نفترض أن لا يكون هذا التوظيف باتجاه تمرير مستقبليات مُغالطة. هذا التعامل الانتهازي مع العلوم هو ما يجعل علوماً فعالة في أماكن معينة مثل الاقتصادي السياسي أو العلوم الاستراتيجية لا تكون سوى أدوات مرحلية وانتهازية في بيئة أخرى.
هذا الميل نحو عدم القول بوجود علم مستقبليات عربي في الوقت الحاضر، هو الوجه الثاني من عملة الحديث عن حاجتنا لعلم سبّاق وحيوي مثله، وبالتالي ضرورة الدخول في مرحلة بنائه على مقاس حاجياتنا، ولا يغيب عنا أنه لا بد وأن لا ينطلق من أرضية أخرى غير الواقع. إنه علم نحتاجه ونخاف، في الوقت نفسه، أن يستخدم لمصادرة المستقبل. إنه حقل معرفي واعد، ولكنه أيضاً علم خطير.