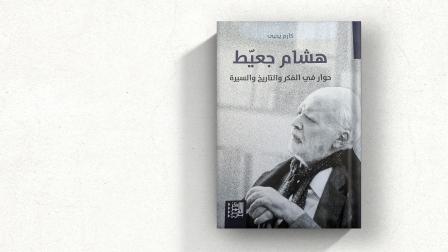ساعتها لم أكن أحمل في الجيب الدّاخليّ لمعطفي الشّتويّ سوى محفظةٍ وضعتُ فيها بطاقةَ هويّتي وورقةً نقديّةً واحدةً وبنسًا إيرلنديًّا ـ أحمله من باب الخرافة، منذ زيارتي الأولى لدبلن قبل عشر سنوات ـ وجواز سفر ابنتي الصّغيرة الأميركيّ منتهي الصّلاحيّة.
كنت قد وضعت الجواز الأزرق في جيبي منذ يومين، معتقدًا أنّ التّلويح به في وجه أحد الجنود قد يساعدني عند اقتحامهم المكان. على فرض أن تساعدني يدي أوّلًا في هكذا أمر. فعلت هذا بعد أن سجّلت أرقام هواتفٍ مباشرةٍ للقنصل الأميركيّ في القدس، أُعلن عنها بسبب حالة الطّوارئ على موقعٍ إلكترونيٍّ خاصٍّ بتسجيل معلومات الرّعايا الأميركيّين.
في أوقات ما قبل الموت تُختزل الذّاكرة ومضاتٍ متداخلةً طويلةً/ قصيرةً كحلم، كذكرى موظّفة الأمن السّوداء البدينة تلك في مطار دنفر، عندما نصحتني قبل خمس سنوات أن أحافظ على ابنتي؛ فمن أجل أطفالٍ كهؤلاء ـ أخبرتني ـ هم يذهبون إلى الحرب.
قلّبتُ ذاكرة هاتفي وقمت بإيقاظ القنصل الأميركيّ من نومه. الحقّ أنّ الرّجل المتلعثم بدا أكثر من عطوفٍ عندما أخبرته إنّ المسألة تتعلّق بحياة أحد مواطنيه. كان حديثي مختلطًا ببكاءٍ، و نفْسٍ مكسورةٍ، وانسلاخٍ من الجلد، وثلاث قذائف تهزّ المبنى، وأشياء أخرى. كنت أستجدي حياتي وحياة ابنتي، فيما أراقب الآخرين من حولي وهم يراقبونني بدورهم.
سألني أسئلةً لا يستطيع إجابتها مراسل إذاعة الجيش مثل: أيّ المعابر أقرب إليك، معبر إيرز أم معبر رفح؟ فيما رحت أتخيّل إحدى المجنّدات تلاطف ابنتي، والجيش يحملني وعائلتي على دبّابةٍ مغادرةٍ فيما تحصد أخرى العشرين الباقين من خلفي. بعد أن قام بتسجيل معلوماتنا، طلب منّي رقم أقرب هاتفٍ أرضيٍّ، ووعدني أن يعاود الشّخص (المناسب) الاتّصال بي في الحال. وهكذا كان.
ـ "سيّد نعيم، أرجوك أن تهدأ. لقد وصلتَ للشّخص المناسب؛ أنا القائم على هكذا أمور هنا. وكما ترى أنا ابن بلدك وأتحدّث لغتك. لديّ معلوماتك كاملةً وسنعمل على إخلائكم في أقرب فرصة".
ـ "أرجوك أن تفعل شيئًا، فنحن نتعرّض للقصف الآن. ربّما تستطيعون أن تخبروا قيادة الجيش بمكان تواجدنا".
ـ "أعوذ بالله! [قالها مقاطعًا ومستهجنًا، وأظنّه قد أساء فهم (النّدب) كحكمٍ للاستعاذة في هكذا مقام] نحن لا نستطيع أن نخبر الجيش الإسرائيليّ بما يجب أن يفعله... ثمّ من أين أتت كلّ هذه اللّزوجة؟... هل لديك طلب آخر؟".
ـ "نعم، ولتعتبرها أمنيةً أخيرةً. هل لديكم استمارة لاستطلاع رأي المراجعين؟ أرغب في تعبئة واحدة".
ـ "لا أعرف ماذا تقصد. كما أنّني لم أعد أسمعك بوضوح بسبب هذه اللّزوجة".
ـ "دعني أقترح عليك واحدة، مثلًا... هل تفضّل أن يقوم دافعو الضّرائب الأميركيّون بتمويل أسلحة لقتل: أ) المدنيّين العزّل بشكل عامّ، ب) المسنّين والعجزة، جـ) الأطفال دون العاشرة؟".
ـ "بالكاد أسمعك...".
ـ "إليك إجابتي: د) أخرى ـ الأطفال العرب حاملي الجنسيّة الأمريكيّة؛ لكي لا تضطرّ الحكومة للذّهاب إلى الحرب من أجلهم".
ـ "... سنعاود الاتّصال بك ثانيةً من أجل الإجراءات".
بعد ـ انسحاب الجيش ـ يومين، بدأ موسم هجرتي شمالًا إلى منزل أقاربٍ لي؛ لا لسبب سوى أنّ القذائف التي هزّت المبنى سابقًا كانت قد انسلّت بدقّةٍ من النّافذة الجنوبيّة لغرفة نومي، فاستهدفت مكتبتي، وذكريات أبي، وحَلْي زوجتي، وألبوم صور بناتي، وأجمل أوقاتي مسجّلةً على أشرطةٍ لم أشاهدها، وجهاز حاسوبي في وضع (سبات) متوقّفًا عند مشهدٍ في فيلمٍ أجنبي لم أكمله، وسرير مولودٍ لن أراه، وقميص عرسٍ كانت قد عاتبتني فيه زوجتي قبل أشهرٍ قليلةٍ [اضطررت لغسله مرّةً يتيمةً بعد أربعة عشر عامًا، فأضعتُ أحمر شفتيها عن ياقته البيضاء]، وأعادت انتشار (تحويشة) عمري، ورماد شهاداتي ومذكّراتي، وبضع ليراتٍ عثمانيّةٍ ورثتها جدّتي لأمّي عن أمّها، في الشّوارع والحدائق المجاورة.
جاءني الاتّصال الموعود بلغة الضّاد ثانيةً وبصوتٍ نسائيٍّ محايدٍ هذه المرّة.
ـ "سيّد نعيم، أنت وأسرتك مسجّلون لدينا من أجل الإخلاء من البلد".
ـ "عفوًا! أنا كنتُ قد طلبتُ فقط الإخلاء من أحد مواقع القصف/ الموت في حينه".
ـ "عذرًا! لم أسمعك جيّدًا؛ السّماعة لزجة بعض الشّيء. هل مازلت راغبًا في الإخلاء؟ هناك إجراءات يجب استيفاؤها".
ـ "لا عليكِ من الإخلاء، يبدو أنّ جميعكم يلثغ في حرف الرّاء".
ـ "عفوًا! السّماعة صارت أكثر لزوجةً".
ـ "لا عليكِ".
ـ "عفوًا...".
ـ "لا عليكِ، هذا مجرّد بصاق".