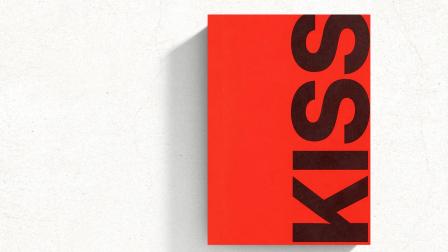في واحد من الأسئلة التي انشغل بها المثقّفون عن مكان الثقافة أمام مشهد الدم والركام، تمحورت جلّ الإجابات في عدّة صحف عربية حول دعم السردية الفلسطينية وتسخير الأبحاث والإنتاج الأدبي والفنّي والمقاطعة الثقافية للاحتلال، وهذا كلّه مُفيد وجيّد، في حال استمرّت المجازر وبقي إنسانٌ فلسطيني على قيد الحياة. يحاول المثقّفون استدراك دورهم، إلّا أنّ تأخّراً عميقاً في الأدوات يظهر عند كلّ لحظة فِعْل ومواجهة.
السرد والبحث والتوثيق ومخاطبة الآخَر من المهام المُهمّة المنوطة بالمثقّف، إلّا أنّ أغلب المشتغلين في هذه الجبهة اقتصروا على المهمّة نفسها. وتتجلّى الفجوة التي تشكّلت في غيابهم عن عالم السياسة والانخراط الجماهيري، في أوّل محاولة استدراك للحظة مصيرية، مثل السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، وشبيهاتها.
يُعدّ الشهيدان غسّان كنفاني وناجي العلي أكثر الأمثلة حضوراً في طرح الكتّاب عن أهمّية فعالية الثقافة، مع التحفّظ أصلاً على طرح موضوع "أهمية الثقافة" في وقت لا تفوح فيه سوى رائحة الدم والبارود. إلّا أنّ ذِكْر هذين الاسمين يخلو غالباً من سياقهما كفنّانَين. الأوّل انخرط في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وكان فاعلاً وعلى صِلة مباشرة مع الناس وقضاياهم بمن فيهم المُقاتلون. والثاني كان ناشطاً وفاعلاً شعبياً يحذو حذو الناس، إن لم يسبقهم في المواجهة السياسية. والخلاصة أنّ الاثنين كانا فاعلَين مُستعدَّين لدفع فاتورة الموقف والفعل.
تأخُّرٌ عميقٌ في الأدوات يظهر عند كلّ لحظة فعل ومواجهة
وهذا ما يُفسّر سبب تقدّم أدوات المثقّفين الفلسطينيّين داخل الأسْر أكثر من الساكنين خارجه، ذلك أنّ ثمن الوعي الحُرّ كان في ممارسة الممنوع لدى الاحتلال وأذرعه، فكانت بدايتهم بالتحرّر في القول والعمل، والتحرّر من أعباء نظرة الآخر، والتصالح مع التاريخ ومكوّنات الانتماء للمكان وثقافته. والمحصّلة أن تصبح الثقافة قولاً وممارسة طيّعة بيد العامل بها.
وهنا يمكن أن نتبيّن لماذا لا يحظى أغلب المثقّفين بآذان صاغية هذه الأيام. ببساطة، لأنّ المُلتهبة قلوبهم في الشارع أسئلتهم وجودية ومصيرهم جماعي، فيما يقطف "مثقّفون" ثِمار فرديّتهم المُقدَّسة، بأجْوبة وانشغالات لا تُقدّم أفكاراً عملية أو أدوات مُبْتَكَرَة، أو حتّى أيّ استلهام من أيّ تاريخ يمكن أن يوظَّف في حالة المواجهة الجماعية.
فيما يخوض المنتجون في مجال الثقافة مثل هذا الخوض، يخطر في البال حوار أقرب في طرحه للواقع، حين سُئلت مختصّة فلسطينية في العلاج النفسي، خلال مقابلة على منصّة إلكترونية، عن مكان العلاج النفسي وسْط مشهد الدم والركام في غزّة، فأجابت: "هذا ليس وقت علاج النفسيّة، هذا وقت إنقاذ الأرواح، ثمّة أطراف تُبتَر وعائلات تُشطَب من السجلّ المدني".
وعلى الرغم من حالة التيه التي تشهدها (المثقّفة/ المثقّف) في لحظات تستدعي المواجهة، إلّا أنّ ثمّة أقلاماً لا تزال تحتفظ بوظيفتها الفريدة، في تحويل ما يجري إلى مادة مَقولة يمكن لمسها وتطويعها، والتعامل معها، وهذا مهمّ، كخطوة يُؤمَل أنْ تلهم الجماهير الممُتدّة على طول خريطة فلسطين الكاملة، في حماية وجودها على أرض الواقع وبشكل جماعي.
على المثقَّف أن ينخرط في مواجهة الواقع من "المسافة صِفر"، أسْوَةً بالمُقاتل الفلسطيني الذي واجه "الميركافا" الإسرائيلية في غزّة وأطاح بها، بقدمين حافيتين، ومن "المسافة صِفر".
* كاتب وصانع بودكاست من فلسطين