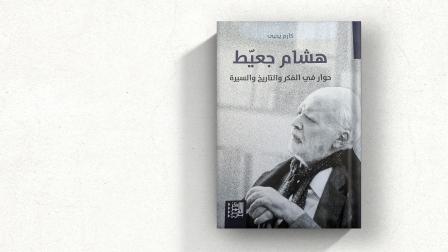أجيدُ التّحكم بمُخيلتي، أُسخّرُها من حين إلى آخر لتجسيد التفاصيل حولي. أبثُ بعضها الحياة وبعضها أقتصُّ منها بعدم أنيق .. ذات يوم طلبتُ منْ صديقتي قنينة ماء، أخبرتُها بأن رائحة السمكة الفضية جميلة..ردت عليّ بحاجب معقود، صحيح هي تنامُ في الثّلاجة كل يوم!
*
البارحة كنتُ أتأمل آثار البعوض على صدري... بقعٌ حمراء ومتورمة. لعنتُ تلك الكائنات الشرسة في سري. كنتُ أدرك تماماً أن خلف كل ذلك وسوماً تملأ القلب، وأنه ليس بوسعي أبداً أن ألعنه هُو... في الحقيقة خططتُ له رسالة قبل شهر أرددٌ فيها: "أكرهك... لم تعد لزرقة البحر بعدك رائحةٌ مميزة، ولا لمطر الصيف القادم عطرُ الياسمين، أنتَ تمسكُ قلبي من أذينه.. أطلق سراحهُ عليكَ ال ... "
لا زالتْ ترقدُ تحت وسادتي .. وتلك اللعنة لا تزال معلقةً على أبواب القلْب.
*
الاثنين صباحاً، باكراً جداً..
بينما المجمع خاشعٌ في النوم سمعت صوت استغاثة وبكاء، قفزت إلى النافذة. صبي لا يزيد عن عمر الخامسة عشرة؛ نحيل وعدة شبان ينهالون عليه. امرأة تمسك بعصا وهي أيضا تقضم منه طرفاً، بثلاث لغات كان يستغيث وعرفتُ أنه من أطفال المهجر، وأن أهله أعادوه ليتعلم الدّين بين ذويه ..!
قيدوه على الرّصيف البارد. أحدهم ضغط على فمه حتى صمت وقذفوا به إلى المقعد الخلفي من سيارة جيب صغير، سجلت المشهد كاملاً بكاميرتي. لم ينصفه أحدٌ من الناظرين. وأنا إلى الآن أتردد في إبلاغ السفارة الأميركية!
صوته لا يخفتُ في ذاكرتي .. يذهب ويأتي مع الهواء الثقيل.
يرتفع حتى يصبح له دويّ في رأسي، أسد أذني وأغني، أقول لنفسي بأن الصوت ينعس في الليل ... لكن صوت ذاك الصبي لا ينام أبداً!
*
يقف لحنٌ حادٌ في حلقي هذه الأيام. قلبي محاط بالثلج الملوّن. وأنا أتسلّى بحبات من حلوى "سكيتليس" أنتقي الليموني والأخضر والبرتقالي.. والباقي أرميه للطير من نافذتي وأتخلى عن هوسي بالنظافة وعدم إلقاء الأشياء من النافذة.
هل أمارس عنصرية لونية هنا ؟
لم لا.. العالم كله يفعل هذا.. (هو جت عليّ أنا يعني!)
أذكر أني قبل أشهر وأنا أحزم حقائبي كنت أردد بفرح طاووسي:
"I'm going Africa ..I'm going home"
تملأ مخيلتي بحيرات الربيع، وطائر الفلامينجو الذي حدثتني عنه مذكرات أمي وتلك السحنات الودودة..
كنت ملأى بالحكايات التي لم تحدث بعد. تخيلت حتى منحنيات الطرق، ودقيقة القطرة الأولى من مطر الصباح.. حتى لون الندى على الزهر أمام بيت جدي.
حين وضعت قدمي على الشارع أمام مطار "جومو كينياتا" وعلى الفور غيّرت العبارة الشخصية في جهاز "البلاك بيري":
"waka waka, This time for Africa"
غنيت أيضا مع شاكيرا في لحظتها، كانت صباحاً، ومطر نيروبي لم يخذل يومي الأول.. فالشوارع كانت بلون الماء الداكن!
*
كنتُ في داري وكذا كنتُ غريبة، طاردتني الأعين منذ ابتدأت رحلتي. لاحقتني حتى بعد أن عبرنا النهر وكاد أن يسقطنا تمساح في الماء العكر.
بمناسبة الماء العكر، أعرف يا عمي أني قد قدتكَ لجنون مريع في تلك الأيام. لكني حقاً لم أتخيل أن ماءً كهذا هو عصب الحياة في قريتنا، وأن ذكريات الأجداد مكتوبة على صفحة ذاك النهر.. فاعذر جهلي. كنتُ غريبة كما لم أكنْ برغم أني كنتُ أذرع الطرقات بين بيوتات عشيرتي. كنتُ وحيدة كما لم أكن حتى في أشد كوابيسي عتمة.
لحظتها تذكرتُ والدي، لم أعرف هل أعتبُ عليه لأنه ألقاني إلى اغتراب أعطبني تماماً ولم أعدْ بعده أصلح لأي من الأوطان؟ لم أعدْ أعرف كيف أنتمي ولا كيف أكون جزءاً من آخرين يحملون نفس ملامحي.. لكن أرواحنا تباعدت منذ أن كنتُ وكان قدري. بالمناسبة صاحبتني في تلك القرية ألقابٌ كثيرة (الفتاة الصبي/ التي تلبس لبس الكفار/ تمشي ك...) كانوا يتهامسون كلما مررت بجانبهم. وحتى النساء لم يترفقن بي رغم أن قلبي تألم كثيراً لمشهد النار التي يوقدنها في الهجير وهنّ ملفحات بالخُمر الثقيلة.
الرجال هم أشرار القرية دائماً. لا خلاف على هذا. لذا لم أستغرق وقتاً للحزن عليهم. الأطفال والنساء هم من طاردوني في المنام.
*
في بداية هذا النّهار أخذتُ ألمع عيني وقررتُ أن أصمت وألا أتحدث عن الشوق المبهم ولا عن الحنين الذي (ما بعرف لمين) ولا عن أحلامي الصغيرة التي أغرقها بالنسيان، لكن الذاكرة كلها أتتني تتهادى هذا المساء على شكل رواية طويلة، حارقة.. شقية.. ولا حول لي بها.
أنا الرّوح التي تعرفُ الله جيداً، وتجيدُ اقتراف الأخطاء.
تلك التي تستغفرُ حين قُبلة.
تقفُ أمام الرّب مطلع كل شهر وساعات الهزيم.. تسأله إشارة.. علامة ما تعطي معنى لكل الذي يحدث.. شيئاً مقدساً ينزع العبث بعيداً، وتعجز أن تبقى على دين الحب طويلاً..
أنا تلك الرّوح، والبندقية الأخيرة المشْحونة ببارود الجنة.
* كاتبة صومالية مقيمة في نيروبي