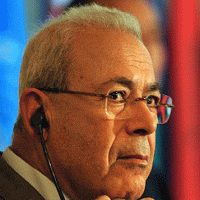11 نوفمبر 2024
مشاريع موسكو الفاشلة في سورية
قصف النظام وروسيا خان شيخون شمال سورية (10/5/2019/فرانس برس)
يتحمّل الروس المسؤولية الكبرى في تعطيل التوصل إلى حل سياسي في سورية، وفي تحويل الصراع السياسي الذي أثارته حركات الاحتجاج التحرّري في أكثر من دولة عربية إلى حرب إبادة جماعية، وتدمير منهجي للدولة في بنياتها الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية في سورية، فقد ترك المجتمع الدولي، والمحور الغربي خصوصا، المبادرة، منذ البداية، في يد الروس. من جهةٍ بسبب تراجع اهتمام الغرب عموما بمصير المشرق، بعد حروب فاشلة في العراق وأفغانستان، ومن جهة ثانيةٍ، بسبب عدم وجود مصالح كبيرة له في سورية، ومن جهة ثالثة تفهما لمصالح إسرائيل، ومجاراة لاستراتيجيتها الهادفة إلى إجهاض أي تحرّك شعبيٍ يُفضي إلى تغيير في طبيعة الأنظمة الأقلوية المعزولة عن شعوبها، ويهدّد بتغيير الحسابات والتوازنات الإقليمية، وإضعاف حزام الأمن الذي تحيط به إسرائيل نفسها، من خلال التفاهم مع النظم الاستبدادية، وتعميق قطيعتها عن شعوبها واعتمادها على الدعم الخارجي.
ولكن المحور الغربي لم يكن الوحيد الذي راهن على موسكو للتخلص من عبء ما سوف يظهر بمثابة "معضلةٍ سورية"، والذي سلم لفلاديمير بوتين وحلفائه الإيرانيين جميع الأوراق في المواجهة السورية، السياسية والعسكرية، وإنما حذا حذوه العرب أيضا. كما أظهرت ذلك المبادرة العربية التي حكمت بمضمونها جميع المبادرات الدولية التالية، والتي نصّت على مخرج سياسي يقوم أساسا على تشكيل حكومة انتقالية مكونةٍ من طرفي النزاع، أي من السلطة والمعارضة، تقوم بالإعداد لانتخاباتٍ تحت إشراف دولي، تفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية الحديثة. وقد قبلت المعارضة، الممثلة بالمجلس الوطني آنذاك، وكذلك المعارضات الخارجة عنه، هذه المبادرة العربية في فبراير/ شباط 2011، وسعت إلى تعميق الاتصالات بموسكو من أجل تأكيد قبولها بهذا الحل الذي كان يهدف إلى تطمين قطاع واسع من الرأي العام السوري، الخائف من التغيير أو الموالي للأسد، على أن الانتقال السياسي لا يعني قلب الطاولة على أحد، لا طائفيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، وإنما إعطاء الشعب، بجميع فئاته، الحقّ في اختيار ممثليه، والعودة بسورية من عصر الحكم بالقوة والإكراه والعنف إلى عصر الحكم الطبيعي والسلمي، كما هو قائم في الأغلبية الساحقة من بلدان العالم اليوم. ولم تترك المعارضة، فيما بعد، وسيلةً لم تستخدمها لإغراء موسكو، وتطمينها على أسبقية مصالحها في سورية، فيما لو قبلت بقيادة عملية التحوّل السياسي، وتفكيك القنبلة التي يمثلها نظام الأسد نفسه، قبل أن تنفجر في البلاد وتحرق الزرع والضرع فيها.
ولكن جميع من راهنوا على موسكو للخروج بحلول سلمية تسووية، تجنب سورية الدمار والقتل الجماعي والتهجير القسري، وفي مقدمتهم المعارضة السورية، وأنا في المقدمة، باء رهانهم
بالفشل. ولا نزال، لم نخرج جميعا من هذه الحلقة المفرغة التي وضعنا أنفسنا فيها، أو سلمنا بوضع الأمل الوحيد في الخروج من المواجهة، بأقل الخسائر، على إرضاء روسيا أو التعاون معها. وقد تفاقم حجم هذا الرهان بعد سنوات الحرب الثماني الطويلة، عندما قرّر الغرب، ونحن في إزاره، أن روسيا ربما كانت الطرف الوحيد الذي يملك اليوم إمكانية إخراج إيران من سورية، وتفكيك قنبلة أخرى، هي حرب إقليمية طويلة ومدمرة، يمكن أن تندلع بالوكالة على أرضنا بين مليشيات إيران المتعدّدة الجنسيات، والتي لا يهمها مصير الأرض التي تحارب عليها، ولا مصير شعبها، وإسرائيل التي لا تقل استهتارا بالأرواح البشرية، ونزوعا لتحويل البلاد المشرقية إلى صحراء قاحلة، وساحة حرب "دفاعية ووقائية".
شلّ الروس، منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الاحتجاجات السلمية، مجلس الأمن، بذريعة الحيلولة دون تدخل غربي يعيد تجربة ما حصل في العراق وليبيا من قبل. وزوّدوا جيش الأسد بالأسلحة والمستشارين العسكريين، ودافعوا عن التدخل العسكري والسياسي الواسع النطاق لإيران في تسيير آلة الحرب والسياسة في دمشق، ودعموا تغلغل مليشياتها الطائفية في الأجهزة والدوائر العسكرية والإدارية. وأجهضت الخارجية الروسية جميع المساعي والمبادرات الدولية لدفع الأمور في اتجاه البحث عن حل سياسي، وفي مقدمها مبادرة جامعة الدول العربية للتسوية السياسية (أواسط شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011)، ومعها بعثة المراقبين العرب إلى سورية· كما أجهضت موسكو المبادرة العربية الدولية التي أوكل إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي أنان، مهمة العمل على تطبيقها (فبراير/ شباط 2012 ) والتي افترضت إيقاف إطلاق النار في 10 إبريل/ نيسان 2012، وكذلك المبادرة التي ناقشتها الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 مع مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأخضر الإبراهيمي، وكانت تشمل وقف إطلاق النار على مراحل، وتشكيل هيئة حكم انتقالية.
هكذا أفرغت موسكو جميع المساعي الدولية بشأن سورية من مضمونها، وقوّضت جميع المبادرات الأممية للتوصل إلى حل سياسي، بما في ذلك مؤتمرات جنيف جميعا، واختلقت تجمعا باسم تجمع أستانة، ضمت إليه طهران، الشريك الأشرس والأول في الحرب على السوريين، للالتفاف على القرارات الدولية، وتعطيل مفاوضات جنيف، وتحييد تجمع أصدقاء سورية، والانفراد بالحل الذي تبين فيما بعد أنه لا يعدو أن يكون إعادة تأهيل نظام الإبادة والتهجير القسري، وتحويل سورية إلى مزرعة عبودية لآل الأسد وأتباعهم. ولم تترك وسيلة من الحرب، والكذب والخداع، لم تستخدمها، من أجل الإيقاع بقوى الثورة والمعارضة، وقطع الطريق على أي مشاركةٍ لها في اي حل سياسي أو تغيير قادم، فبذلت جهودا مستمرة وهائلة، لتقسيم هذه القوى المقسّمة أصلا وتفتيتها، وإثارة الفتن والخلافات في ما بينها، ومنها دعمها
أكبر عدد ممكن من المنصّات السياسية المصطنعة، ومراكز القوى التابعة لها، حتى لم يعد للمعارضة أي مركز جدّي أو قرار. وضاق صدرها بشكل أكبر بجميع تلك القوى والمؤسسات والشخصيات التي تقدم العون للمدنيين المشرّدين، أو الذين قوضت شروط حياتهم، وجعلت من الهجوم على القبعات البيضاء التي اتهمتها بالإرهاب هدفا حربيا أسمى من بين أهدافها. وغطت على جميع الأعمال والخطط اللاإنسانية التي مارسها النظام، لتحطيم المجتمعات المحلية، وإخلاء المدن والقرى من سكانها، قصفا أعمى وحصارا وتجويعا، من أجل استعادة السيطرة على المناطق المحرّرة. وبرّرت جميع انتهاكات نظام الأسد لحقوق المدنيين واتفاقية جنيف الخاصة بالحرب، قبل أن تتبنّاها هي نفسها، وتجعل من تدمير المدن والقرى سلاحها الأمضى لهزيمة الثورة السورية. فبعد أن ظهر فشل المليشيات الإيرانية وجيش الأسد الطائفي أمام القوى الثورية، لم تتردّد موسكو في التدخل العسكري المباشر بسلاحها الجوي وعدتها الصاروخية، للقضاء على مقاومة الشعب السوري، بذريعة القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي لم تواجهه في أي معركة حقيقية.
على الرغم من خيبة أمل الأطراف الدولية والعربية والمعارضة السورية من سلوك موسكو، وافق الجميع على ما سميت خطة روسيا لوقف إطلاق النار، بدءا بتطبيق ما سميت مناطق خفض التصعيد، قبل التوصل إلى وقف نار شامل، ومدخلا للحل السياسي القائم على قرار مجلس الأمن 2254. وقد تبيّن بسرعة بعد ذلك أن هذه الخطة لم تكن سوى غلالة لإخفاء الخطة الحقيقية الهادفة إلى تقويض قاعدة سيطرة المعارضة والانفراد بها، منطقة منطقة، قبل القضاء عليها وفرض الحل الروسي القاضي بالإبقاء على نظام الأسد وتأهيله دوليا. وهكذا لم تتردّد في خيانتها وعودها، والانقلاب على القوى التي محضتها ثقتها من بين فصائل المعارضة، فسلمتها مكتوفة اليدين إلى جلاديها من مليشيات الأسد الذين لم يوفّروا وسيلة أيضا للتنكيل بمعارضيهم السابقين، وزجّهم في الصفوف الأولى في معاركهم المستمرة، وعلى جبهات القتال الذي لم يتوقف يوما منذ ثماني سنوات. واكتشف هؤلاء أن ضمانة موسكو التي ركنوا إليها لم تكن سوى خدعة وقع فيها البسطاء من المقاتلين، وأصبحوا بسببها طعاما سائغا لحروب الانتقام الجديدة.
ليس هناك أي شك في أن هذا التسليم من العرب، ومن المحور الغربي، ومن المعارضة السورية نفسها، بعدم وجود خيار آخر سوى "الحل الروسي" هو الذي طمّع الروس بالجميع، وأطاش صواب قادتهم، ودفعهم إلى رفع ثمن "مساهمتهم" الموعودة في إيجاد حل للنزاع وإطفاء النار السورية، إلى درجةٍ جعلتهم يعتقدون أنه أصبح في إمكانهم أن يطمحوا، في ما وراء سيطرتهم على سورية ذاتها، وانتزاع ما يشبه الوصاية الدولية الشرعية عليها، وجعلها جزءا من أملاكهم ومناطق نفوذهم المباشرة والأساسية في منطقة متوسطية حساسة استراتيجيا، طالما طمحوا إلى احتلال موقع فيها، وطمحوا إلى تنازلات أكبر من الغرب وجوائز ترضية إضافية في الملفات الاستراتيجية والسياسية والعقوبات الاقتصادية المعلقة بين روسيا والغرب منذ عقود.
بالغ الروس في أطماعهم، وناوروا كثيرا في سعيهم إلى تأجيل العمل من أجل حل سياسي، على أمل أن يرضخ الغرب، ويقبل شراكتهم الدولية، لا في سورية وحدها. وخدعت موسكو نفسها بالأمل في أن تنتزع تركيا أيضا من المحور الغربي، لتراكم مكاسب جيوستراتيجية إضافية، وتغير التوازنات الدولية في المنطقة، كما استهانت بأطماع طهران وتمسّكها بحلم الخلافة الشيعية المشرقية، أو بمشروع الإمبرطورية الفارسية المجدّدة، لا فرق، فوجدت نفسها، بعد تعديل السياسة الأميركية، وتناحة القيادة الإيرانية، في وضع أقل ثباتا وتماسكا، وربما مهدّدة بانفلات الأمور التي أمسكت بها بقوة منذ بداية الأزمة السورية، وهي في طريقها إلى فقدان المبادرة الدبلوماسية والعسكرية.
لاستعادة المبادرة، والضغط على جميع الأطراف الأخرى المستعدة لتجاوز "العهدة الروسية"، لم يجد بوتين وسيلة أخرى سوى التي اعتمدها قبل استلامه الحكم في الشيشان، والتي مهّدت لهذا الاستلام أيضا، والتي بوأت روسيا المكان الأول في سورية أيضا، وفرضت أسبقية
مصالحها على مصالح الدول الأخرى كافة، بما فيها السورية، وهي وضع آلة الحرب الكبرى التي يملكها في خدمة أهدافه الجديدة، والبدء بالتدمير المنهجي لمنطقة خفض التصعيد الوحيدة المتبقية في شمال غرب سورية في منطقة غرب الفرات، في إدلب وريف حماة الشمالي.
لن يستطيع الروس أن يربحوا رهاناتهم المهدّدة بالخسران عن طريق تجديد سياسة الأرض المحروقة، والقصف على المدنيين، وتهجيرهم للضغط على الأطراف الأخرى، فقد فشل الروس، في السنوات الثماني الماضية التي انفردوا فيها بما يشبه التفويض السياسي، في الاستجابة الصحيحة للثقة التي وضعها المجتمع الدولي، وسوريون كثيرون، بمن فيهم فئات من موالي نظام الإبادة، بهم. وهم مضطرون، بسبب ذلك منذ الآن، إلى أن يستبدلوا الثلاثية الجديدة التي تجمعهم مع إسرائيل والولايات المتحدة، والمنتظر أن تجتمع قريبا في القدس المحتلة بثلاثية أستانة التي لم يبق من ذاكرتها سوى رائحة الخدعة والخيانة التي تفوح من اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي رعتها، والتي راهنت عليها من أجل سحق تطلعات الشعب السوري وآماله.
والدرس الرئيس الذي علينا أن نأخذه من هذه المراهنة الخائبة على موسكو، نحن السوريين، بعد المراهنة الفاشلة، في بدايات الحرب المفروضة على السوريين، على التدخل الغربي، والذي قسم صفوفنا على لا شيء، هو أن لا ننتظر الخير ممن يسعى لنا بالشر، وأنه لا بديل لأي شعبٍ من أجل تحقيق أهدافه المشروعة سوى الاعتماد على نفسه وتنمية قواه الذاتية. وقد كان مصير الصراع بأكمله سيختلف جذريا، لو أننا نجحنا، منذ بداية الصراع المسلح، وبعد أخذ العبرة من درس بابا عمرو في حمص، وهي أول الأحياء الثائرة التي سقطت تحت وابلٍ من القصف والدمار، في قلب الطاولة، وتحويل المواجهة الساكنة في الأحياء والقرى إلى مقاومة شعبية متحرّكة، طويلة المدى ومتعدّدة الأشكال، تعتمد على ذاتها وتطور قواها تدريجيا، ومن خلال المواجهة ذاتها. وربما لن يبقى لنا خيار آخر اليوم بديل عن هذه المقاومة، إذا ما فشلت الدول المتنازعة على مناطق النفوذ والسيطرة، كما هو جليّ اليوم للجميع، في تخفيض سقف تطلعاتها، لإعطاء جرعة أمل للسوريين، لتحقيق تطلعاتهم التي أصبحت، بعد القتل والتدمير الإجراميين، واجبة، وليس شرعية أو مشروعة فحسب.
ولكن المحور الغربي لم يكن الوحيد الذي راهن على موسكو للتخلص من عبء ما سوف يظهر بمثابة "معضلةٍ سورية"، والذي سلم لفلاديمير بوتين وحلفائه الإيرانيين جميع الأوراق في المواجهة السورية، السياسية والعسكرية، وإنما حذا حذوه العرب أيضا. كما أظهرت ذلك المبادرة العربية التي حكمت بمضمونها جميع المبادرات الدولية التالية، والتي نصّت على مخرج سياسي يقوم أساسا على تشكيل حكومة انتقالية مكونةٍ من طرفي النزاع، أي من السلطة والمعارضة، تقوم بالإعداد لانتخاباتٍ تحت إشراف دولي، تفتح صفحة جديدة في تاريخ سورية الحديثة. وقد قبلت المعارضة، الممثلة بالمجلس الوطني آنذاك، وكذلك المعارضات الخارجة عنه، هذه المبادرة العربية في فبراير/ شباط 2011، وسعت إلى تعميق الاتصالات بموسكو من أجل تأكيد قبولها بهذا الحل الذي كان يهدف إلى تطمين قطاع واسع من الرأي العام السوري، الخائف من التغيير أو الموالي للأسد، على أن الانتقال السياسي لا يعني قلب الطاولة على أحد، لا طائفيا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، وإنما إعطاء الشعب، بجميع فئاته، الحقّ في اختيار ممثليه، والعودة بسورية من عصر الحكم بالقوة والإكراه والعنف إلى عصر الحكم الطبيعي والسلمي، كما هو قائم في الأغلبية الساحقة من بلدان العالم اليوم. ولم تترك المعارضة، فيما بعد، وسيلةً لم تستخدمها لإغراء موسكو، وتطمينها على أسبقية مصالحها في سورية، فيما لو قبلت بقيادة عملية التحوّل السياسي، وتفكيك القنبلة التي يمثلها نظام الأسد نفسه، قبل أن تنفجر في البلاد وتحرق الزرع والضرع فيها.
ولكن جميع من راهنوا على موسكو للخروج بحلول سلمية تسووية، تجنب سورية الدمار والقتل الجماعي والتهجير القسري، وفي مقدمتهم المعارضة السورية، وأنا في المقدمة، باء رهانهم
شلّ الروس، منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الاحتجاجات السلمية، مجلس الأمن، بذريعة الحيلولة دون تدخل غربي يعيد تجربة ما حصل في العراق وليبيا من قبل. وزوّدوا جيش الأسد بالأسلحة والمستشارين العسكريين، ودافعوا عن التدخل العسكري والسياسي الواسع النطاق لإيران في تسيير آلة الحرب والسياسة في دمشق، ودعموا تغلغل مليشياتها الطائفية في الأجهزة والدوائر العسكرية والإدارية. وأجهضت الخارجية الروسية جميع المساعي والمبادرات الدولية لدفع الأمور في اتجاه البحث عن حل سياسي، وفي مقدمها مبادرة جامعة الدول العربية للتسوية السياسية (أواسط شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011)، ومعها بعثة المراقبين العرب إلى سورية· كما أجهضت موسكو المبادرة العربية الدولية التي أوكل إلى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي أنان، مهمة العمل على تطبيقها (فبراير/ شباط 2012 ) والتي افترضت إيقاف إطلاق النار في 10 إبريل/ نيسان 2012، وكذلك المبادرة التي ناقشتها الصين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 مع مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، الأخضر الإبراهيمي، وكانت تشمل وقف إطلاق النار على مراحل، وتشكيل هيئة حكم انتقالية.
هكذا أفرغت موسكو جميع المساعي الدولية بشأن سورية من مضمونها، وقوّضت جميع المبادرات الأممية للتوصل إلى حل سياسي، بما في ذلك مؤتمرات جنيف جميعا، واختلقت تجمعا باسم تجمع أستانة، ضمت إليه طهران، الشريك الأشرس والأول في الحرب على السوريين، للالتفاف على القرارات الدولية، وتعطيل مفاوضات جنيف، وتحييد تجمع أصدقاء سورية، والانفراد بالحل الذي تبين فيما بعد أنه لا يعدو أن يكون إعادة تأهيل نظام الإبادة والتهجير القسري، وتحويل سورية إلى مزرعة عبودية لآل الأسد وأتباعهم. ولم تترك وسيلة من الحرب، والكذب والخداع، لم تستخدمها، من أجل الإيقاع بقوى الثورة والمعارضة، وقطع الطريق على أي مشاركةٍ لها في اي حل سياسي أو تغيير قادم، فبذلت جهودا مستمرة وهائلة، لتقسيم هذه القوى المقسّمة أصلا وتفتيتها، وإثارة الفتن والخلافات في ما بينها، ومنها دعمها
على الرغم من خيبة أمل الأطراف الدولية والعربية والمعارضة السورية من سلوك موسكو، وافق الجميع على ما سميت خطة روسيا لوقف إطلاق النار، بدءا بتطبيق ما سميت مناطق خفض التصعيد، قبل التوصل إلى وقف نار شامل، ومدخلا للحل السياسي القائم على قرار مجلس الأمن 2254. وقد تبيّن بسرعة بعد ذلك أن هذه الخطة لم تكن سوى غلالة لإخفاء الخطة الحقيقية الهادفة إلى تقويض قاعدة سيطرة المعارضة والانفراد بها، منطقة منطقة، قبل القضاء عليها وفرض الحل الروسي القاضي بالإبقاء على نظام الأسد وتأهيله دوليا. وهكذا لم تتردّد في خيانتها وعودها، والانقلاب على القوى التي محضتها ثقتها من بين فصائل المعارضة، فسلمتها مكتوفة اليدين إلى جلاديها من مليشيات الأسد الذين لم يوفّروا وسيلة أيضا للتنكيل بمعارضيهم السابقين، وزجّهم في الصفوف الأولى في معاركهم المستمرة، وعلى جبهات القتال الذي لم يتوقف يوما منذ ثماني سنوات. واكتشف هؤلاء أن ضمانة موسكو التي ركنوا إليها لم تكن سوى خدعة وقع فيها البسطاء من المقاتلين، وأصبحوا بسببها طعاما سائغا لحروب الانتقام الجديدة.
ليس هناك أي شك في أن هذا التسليم من العرب، ومن المحور الغربي، ومن المعارضة السورية نفسها، بعدم وجود خيار آخر سوى "الحل الروسي" هو الذي طمّع الروس بالجميع، وأطاش صواب قادتهم، ودفعهم إلى رفع ثمن "مساهمتهم" الموعودة في إيجاد حل للنزاع وإطفاء النار السورية، إلى درجةٍ جعلتهم يعتقدون أنه أصبح في إمكانهم أن يطمحوا، في ما وراء سيطرتهم على سورية ذاتها، وانتزاع ما يشبه الوصاية الدولية الشرعية عليها، وجعلها جزءا من أملاكهم ومناطق نفوذهم المباشرة والأساسية في منطقة متوسطية حساسة استراتيجيا، طالما طمحوا إلى احتلال موقع فيها، وطمحوا إلى تنازلات أكبر من الغرب وجوائز ترضية إضافية في الملفات الاستراتيجية والسياسية والعقوبات الاقتصادية المعلقة بين روسيا والغرب منذ عقود.
بالغ الروس في أطماعهم، وناوروا كثيرا في سعيهم إلى تأجيل العمل من أجل حل سياسي، على أمل أن يرضخ الغرب، ويقبل شراكتهم الدولية، لا في سورية وحدها. وخدعت موسكو نفسها بالأمل في أن تنتزع تركيا أيضا من المحور الغربي، لتراكم مكاسب جيوستراتيجية إضافية، وتغير التوازنات الدولية في المنطقة، كما استهانت بأطماع طهران وتمسّكها بحلم الخلافة الشيعية المشرقية، أو بمشروع الإمبرطورية الفارسية المجدّدة، لا فرق، فوجدت نفسها، بعد تعديل السياسة الأميركية، وتناحة القيادة الإيرانية، في وضع أقل ثباتا وتماسكا، وربما مهدّدة بانفلات الأمور التي أمسكت بها بقوة منذ بداية الأزمة السورية، وهي في طريقها إلى فقدان المبادرة الدبلوماسية والعسكرية.
لاستعادة المبادرة، والضغط على جميع الأطراف الأخرى المستعدة لتجاوز "العهدة الروسية"، لم يجد بوتين وسيلة أخرى سوى التي اعتمدها قبل استلامه الحكم في الشيشان، والتي مهّدت لهذا الاستلام أيضا، والتي بوأت روسيا المكان الأول في سورية أيضا، وفرضت أسبقية
لن يستطيع الروس أن يربحوا رهاناتهم المهدّدة بالخسران عن طريق تجديد سياسة الأرض المحروقة، والقصف على المدنيين، وتهجيرهم للضغط على الأطراف الأخرى، فقد فشل الروس، في السنوات الثماني الماضية التي انفردوا فيها بما يشبه التفويض السياسي، في الاستجابة الصحيحة للثقة التي وضعها المجتمع الدولي، وسوريون كثيرون، بمن فيهم فئات من موالي نظام الإبادة، بهم. وهم مضطرون، بسبب ذلك منذ الآن، إلى أن يستبدلوا الثلاثية الجديدة التي تجمعهم مع إسرائيل والولايات المتحدة، والمنتظر أن تجتمع قريبا في القدس المحتلة بثلاثية أستانة التي لم يبق من ذاكرتها سوى رائحة الخدعة والخيانة التي تفوح من اتفاقيات خفض التصعيد والمصالحات التي رعتها، والتي راهنت عليها من أجل سحق تطلعات الشعب السوري وآماله.
والدرس الرئيس الذي علينا أن نأخذه من هذه المراهنة الخائبة على موسكو، نحن السوريين، بعد المراهنة الفاشلة، في بدايات الحرب المفروضة على السوريين، على التدخل الغربي، والذي قسم صفوفنا على لا شيء، هو أن لا ننتظر الخير ممن يسعى لنا بالشر، وأنه لا بديل لأي شعبٍ من أجل تحقيق أهدافه المشروعة سوى الاعتماد على نفسه وتنمية قواه الذاتية. وقد كان مصير الصراع بأكمله سيختلف جذريا، لو أننا نجحنا، منذ بداية الصراع المسلح، وبعد أخذ العبرة من درس بابا عمرو في حمص، وهي أول الأحياء الثائرة التي سقطت تحت وابلٍ من القصف والدمار، في قلب الطاولة، وتحويل المواجهة الساكنة في الأحياء والقرى إلى مقاومة شعبية متحرّكة، طويلة المدى ومتعدّدة الأشكال، تعتمد على ذاتها وتطور قواها تدريجيا، ومن خلال المواجهة ذاتها. وربما لن يبقى لنا خيار آخر اليوم بديل عن هذه المقاومة، إذا ما فشلت الدول المتنازعة على مناطق النفوذ والسيطرة، كما هو جليّ اليوم للجميع، في تخفيض سقف تطلعاتها، لإعطاء جرعة أمل للسوريين، لتحقيق تطلعاتهم التي أصبحت، بعد القتل والتدمير الإجراميين، واجبة، وليس شرعية أو مشروعة فحسب.