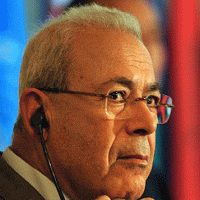11 نوفمبر 2024
ما بعد حلب... أو النصر الأسوأ من هزيمة
مدنيون يفرون من النظام ومليشياته في حي العامرية بحلب(16/12/2016/الأناضول)
يعتقد الأسد الذي لم يعرف السياسة، ولا تعامل بها في أي وقت، أن سقوط حلب يعني استعادة السيطرة على سورية، وفرض هيبته على الشعب، وتأكيد منطق القوة أو التفوق بالقوة الذي أقامت عليه جماعة الأسد حكمها منذ بداية تشكيل النظام. لا يهم مصدر القوة التي أسقط بها المدينة والشعب، ولا بأي ثمنٍ جاء. والحال أن إسقاط حلب، وهذا ما لن يتأخّر ظهوره، هو إعلانٌ عن نهايته المحتمة في الوقت ذاته. فبإصراره على تأكيد الغلبة العسكرية قطع على نفسه أي طريقٍ للتصالح مع الشعب الذي قوّض شروط وجوده، ونكل بأبنائه من دون حساب. وبمقدار ما حكم على نفسه بالبقاء في أسر القوى التي مكّنته من الانتصار، سيفقد بموازاة ترسيخ هذه القوى قواعد سيطرتها مبرّر بقائه، ويتحول إلى ورقة مساومةٍ سياسية. فلا يمكن لحاكمٍ أن يربح ضد شعبه الذي يفترض أن يستمد منه القوة والشرعية، وإذا حصل فسيكون ثمن ربحه أعلى من الخسارة، ونتيجته تسليم مفتاح ملكه لغيره. ولعل ما جعله ينسى ذلك، هو ومن كان وراءه ممن سيجلون عن السلطة بسرعة أكبر مما يتوقعونها، هو تخلفهم السياسي المذهل الذي جعلهم يتصوّرون أنفسهم ويتصرّفون كما لو كانوا ملاك عبيد، لهم على شعبهم حق الحياة والموت. وربما خدعتهم بعض مظاهر الاحتفاء التي تبديها قطاعاتٌ من الرأي العام التي تحاول، بالرقص على جثث الضحايا من أشقائها ومواطنيها، أن تكبح مشاعر القلق والخوف التي تجتاحها وتتقي بالتعبير الكاذب عن الفرح والانتصار المصير المشؤوم الذي تدرك بالحدس أنه ينتظرها.
ثمن الحسم العسكري ومضمونه
في ما وراء تعبيره عن الارتهان للاستراتيجيات الاجنبية التي وقع أسيرها، يعكس الإصرار على إسقاط حلب التمسك، حتى النهاية، بمبدأ الحل العسكري، أي إبادة الخصم، والاستسلام النهائي لسياسة الهرب إلى الأمام التي أوصلته إلى قبول سياسة الإبادة الجماعية والمقامرة بمصير البلد نفسه.
وهذه السياسة ذاتها التي مكّنت الأسد، ومن حوله، من تحقيق وعده بالانتقام من السوريين، وتكبيدهم خسائر غير مسبوقة، ثمن رفضهم التمديد له، كما كان ينتظر أو ينتظره المستفيدون من نظامه، هي نفسها الفخ الذي نصبه لنفسه، ونصبه له الإيرانيون الطامعون في السيطرة على بلده، مستغلين مشاعر الحقد والانتقام هذه. ولا يمكن إلا للجاهل والأحمق أن لا يدرك أن التهرب من الاستجابة لتطلعات السوريين السياسية والانسانية، والرد عليها بالعنف، أو الاعتقاد بإمكانية الإعدام السياسي المستمر للشعب السوري، لم يساهما في إيجاد الحل للأزمة المستمرة منذ عقود، وإنما بالعكس عملا على تفجيرها في سياق الثورات العربية، وعمّقا الشرخ بين الحكم والشعب، حتى لم يعد هناك خيار لأي طرف غير السلاح والعنف. كما أن هذه السياسة التي أوصلت البلاد إلى أكبر كارثة إنسانية هي نفسها التي دفعت إلى الارتماء على الأجنبي، وتعميق التدخلات الخارجية بطلب من الأطراف السورية، وقادت إلى تغيير طبيعة الدولة والمجتمع معاً، ودمرت عرى التواصل والتفاهم بين أبناء المجتمع الواحد، وهي تهدد اليوم بالتحول إلى حرب إبادةٍ متبادلةٍ على مستوى المنطقة بأكملها.
يخطئ من يعتقد أنه سيكون هناك حل بعد الآن بالانتصار العسكري. بالعكس، تستخدم بعض
الدول وهم الانتصار العسكري هذا، خصوصاً إيران، من أجل إطالة أمد الحرب، حتى تستطيع أن تكسب الوقت، لتحقيق التغيير الديمغرافي المنشود، وإقامة منطقة حروبٍ ونزاعاتٍ وفوضى دائمة، تمتد من بغداد حتى بيروت، تمكّنها من الحفاظ على نفوذها، وتحقيق هلال السيطرة الإيرانية الدائم.. فبمقدار ما عنى الرفض المبدئي للحل السياسي إدانة الشعب المطالب بالحرية بانعدام أي خيار آخر، سوى الخنوع وإعلان الاستسلام وقبول العبودية، قطع كل جسور التواصل، ودان الجميع، بالتصعيد المستمر واللامتناهي في العنف، وحول الصراع السياسي إلى حرب دفاعٍ عن الوجود، حتى لم يعد من الممكن لأي طرفٍ، النظام والشعب الثائر، أن يقبل التراجع، من دون أن يعلن نهايته ويشهد هلاكه. هذا الطريق المسدود الذي وضع فيه النظام الأزمة هو تماما ما يعبّر عنه شعار حماية الشعب والدولة ضد الاٍرهاب والمؤامرة الأجنبية الذي رفعه النظام، وشعار "الموت ولا المذلة" الذي يعبر عن الاستعداد للموت وعدم التسليم ثانية بالعبودية أو التفاهم أو التصالح معها الذي رفعه الشعب. لذلك، ما كان من الممكن إلا أن نسير في الصراع السوري نحو تصعيدٍ من دون حدود في العنف، على مستوى الخطاب والممارسة والحرب، حتى انتهينا إلى حرب التدمير المتبادل، فالطغيان كالحرية لا يتجزّآن. ولا يمكن أن يكون هناك نصف طغيان، ولا أن تكون هناك نصف عبودية، فالسلطة إما أن تكون تمثيليةً أو أن تكون مفروضة بالقوة، والفرد إما أن يكون حرّا أو مسلوب الإرادة، ولا يمكن أن يكون هناك فرد نصف حر ونصف عبد.
في هذه الحرب الذي حوّلها النظام إلى حرب وجود له كنظام، ومن ثم حرب وجود للشعب الثائر عليه، ما كان من الممكن للعنف إلا أن يتجه نحو حدوده القصوى، وأن يتحوّل الدمار والقتل بالجملة، وأعمال الإبادة المادية والسياسية للجماعات والطوائف والقوميات إلى حالةٍ عاديةٍ، تكاد تكون اليوم مقبولةً من الجميع، وتتم تحت إشراف ونظر الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي الإنسانية والحقوقية وبرعايتها. وكان من المنطقي أيضاً أن نفقد الخيارات جميعاً، كما لم يكن هناك مجال أن لا تتحول إلى حروب بالوكالة، وأن يُسلَّم القرار فيها للدول والقوى الخارجية، على مستوى النظام الذي أصبح كالخاتم في يد الدول المنتدبة والوصية عليه. وعلى مستوى المعارضات التي تتنازع على الحمايات الخارجية، بينما تفتح الفوضى والخراب السياسي والقانوني الباب على مصراعيه، لنمو المنظمات الإرهابية، الخارجة على القانون والنظام والمجتمع الدوليين، حتى توهمت أنها قادرة على بناء دولتها الخاصة، بل لبس عباءة الخلافة الإسلامية كاملة أو استعادتها.
لن يمكن لأي حكم أو نظام أو سلطة أن تستقر وتنجح في امتصاص النتائج المدمرة لهذه الحرب الظالمة الطويلة ضد الشعب السوري، بالاستمرار في إنكار حقيقة الثورة التي قام بها الشعب، ومن دون الرد الواضح والمباشر على مطالبها السياسية والأخلاقية والقانونية المتعلقة بالعدالة. لذلك، بعكس ما يتصوّره مهندسوه الروس والإيرانيون، قد يساعد سقوط حلب أو إسقاطها على تعزيز سيطرتهما المشتركة في سورية، وتحكمهما بالنظام، لكنه لن يفضي إلى أي حل. بالعكس، يعلن هذا النصر الذي تحقق على يد المليشيات الطائفية العراقية، وفي مقدمها مليشيا النجباء التي تخوض في وعيها حرباً دينيةً وطائفيةً وإحلاليةً في الوقت نفسه، نهاية
الحلول السياسية وبدء مرحلةٍ جديدة من الحروب والصراعات والفوضى التي لن تقتصر على القوى المتنازعة اليوم وحدها، وتطرح أسئلةً كبيرةً على أسياد سورية الممزقة والمدمرة اليوم، لا يمكن لهم، ولن يستطيعوا الإجابة عنها، بتغييب السوريين واغتيالهم السياسي وتشريد الجزء الأكبر منهم. فلا يعرف أحد اليوم إلى من ستؤول ملكية حلب من بين المليشيات المذهبية، ومن سيرفع راياته، ويثأر فيها للحسين، ومن سيعلن دولة الخلافة ونصرتها، وأي صورةٍ ستعلق على جدران أوابدها، من بين صور قادة المسيرة الخلاصية والكارثية، الخميني وخامنئي أو بوتين أو الأسد أو البغدادي أم غيرهم من المرشحين الكثيرين. كما لن تطمئن السوريين أكثر على مصيرهم ومستقبل بلدهم وتمكنهم من معرفة ما إذا كانوا سيظفرون، في النهاية، بوطنٍ أم سيبقون مشرّدين، بمن فيهم من يعيشون داخل أسوار معازلهم وجدران الإمارات الحربية السورية والأجنبية المتوالدة في ارضهم.
باختصار. لا يمكن للسياسة التي قادت إلى تفجير أكبر كارثة إنسانية في العصر، وجعلت من احتجاجات شعبية عادية حرباً متعدّدة الأطراف والأبعاد والرهانات، داخلية وإقليمية ودولية، في الوقت نفسه، أن تكون هي ذاتها الأساس لإعادة بناء سورية الواحدة والآمنة والمتضامنة والحرة والمستقلة.
لماذا لا يمكن للأسد أن يربح الحرب؟
سقوط حلب هو الإعلان عن نهاية سورية القديمة، معارضةً وحكومةً ونظاما وشعبا ودولةً، بمقدار ما هو نهاية الحلول السياسية، فسورية اليوم ركام من الأنقاض تنتظر من يزيلها، سورية الأسد وما بعده، سورية الحرب وتدخلات الدول الأجنبية وإرهاب الدولة وإرهاب الدين. وَمِمَّا إنه لن يكون من الممكن إعادة بناء الدولة بتكريس منطق الانحراف والجريمة، ولا إعمارها بسحق شعبها وإخراجه منها، لا يمكن كذلك إعادة جمعها وبنائها على شذرات أفكار وتجمعات وروابط محلولة. وتستهزئ الطغمة السورية ورعاتها من الصحفيين والمثقفين والسياسيين بأنفسهم، عندما يعتقدون أنهم يستطيعون فرض الخنوع على الشعب، وإعادة احتوائه بتوزيع بعض المناصب السياسية على المعارضة. أولاً، لأن السوريين جميعا، معارضين وموالين، فقدوا في مخاض الثورة العنيف والقاسي روح العبودية التي شلتهم في الماضي. وثانياً، لأن أحداً من غير المتورطين في الجريمة لن يقبل أن يكون شريكاً في المسؤولية عنها، وهي جريمة اغتيال شعب وتدمير شروط وجوده ورهن وطنه للأجنبي، لا يمكن غفرانها أو تجاوزها. وثالثاً، لأن أي سوري يحترم نفسه لن يقبل أن يكون عميلاً لسلطة الوصاية الأجنبية الذي يفخر بالإعلان عنها كل يوم المسؤولون الإيرانيون.
بالعكس، سيكتشف النظام بشكل أكبر في المستقبل أن إسقاط حلب كان نصراً فارغاً ربما أسوأ بكثير في مآلاته من الهزيمة، وأنه جاء ليؤكد تهافت النظام، وعجزه الولادي عن ممارسة السياسة أو دخولها. وبالتالي، عن التطبع والتطبيع، والخروج من صفة الاستثناء وحالة الطوارئ والحرب الدائمة. وهو يعبر أكثر عن إصراره على الانتحار مما يشير إلى انبعاثه. وبدل أن يساعده كما يعتقد على الرد على تحدي وجوده، سوف يدفعه بشكل أكبر إلى الموت تحت ركام المشكلات والنزاعات والتناقضات العميقة التي تنخر وجوده، والرد على التحديات الهائلة التي تواجهه، وفي مقدمها تغوّل الدول الأجنبية التي أصبحت حاميته، وتعدّد المليشيات المذهبية والقومية المنظمة والمدربة والممولة من الخارج، واستباحة الدولة من مختلف القوى والشبكات. لن يسمح مثل هذا الوضع ببناء دولةٍ ولا جيش، وليس من مصلحة أحد فيه أن يعود إلى فكرة الجيش الوطني، ولا حتى إصلاح الإدارة المدنية. فمن دون تسويةٍ سياسيةٍ، لن يكون أمامه خيار آخر سوى الاستمرار في استباحة الدولة ومؤسساتها، والمراهنة على تعبئة المليشيات الطائفية الأجنبية والمحلية، للحفاظ على السيطرة، وبالتالي، خيار الحرب الدائمة، كما هو العراق اليوم.
وبالمثل، لن يكون من الممكن إعادة بناء الدولة، وتحقيق الحد الأدنى من الأمن والاستقرار من
دون مصالحة وطنية، وإحياء روح العدالة التي يحتاج إليها تطمين الناس على حياتها وحقوقها، وتجنب ما حصل في العراق، ولا يزال يحصل منذ حرب عام 2003. ثم كيف يمكن، من دون تسوية سياسية وتفاهمات دولية وإقليمية، معالجة مسائل كبرى، مثل مسألة المليشيات الأجنبية التي يزيد عدد من يعمل منها مع النظام وحده عن 66 مليشيا، وتتنازع على اقتسام الغنائم في حلب وغيرها، إضافة إلى المليشيات الجهادية الدولية وفصائل المعارضة المسلحة؟ وكيف يمكن من دونها أيضا مواجهة مشكلة ملايين اللاجئين وإعادة توطينهم في بلدهم، بينما يعتقد بشار الأسد أن رحيلهم قد حسّن من النسيج الاجتماعي السوري؟
لن يكون هناك أي أملٍ في إعادة الإعمار، الذي تقدر تكاليفه بـ 300 مليار دولار، من دون تعبئة رجال الأعمال السوريين، وتعاون الدول الإقليمية والعالمية، وتغيير قواعد العمل السياسية وضمان الاستقرار والأمن والسلام وإمكانية استعادة رأس المال. وحتى أكثر الدول تساهلاً، لن تقبل المساهمة في استثمار مئات ملايين الدولارات خدمة للأسد وحلفائه، ودعماً لنظام يقوم على العنف وحكم المليشيات، ويفتقر لكل مقومات النظام السياسي والحكم القانوني والعدالة، عدا عن أنه متهم، وربما ملاحقٌ دوليا غداً، بقتل مئات الألوف من شعبه، وتشريد نصف سكان بلده، والتسبب في إعاقة دائمة أو شبه دائمة لأكثر من مليوني إنسان. ويحلم أنصار النظام ومشجعوه على القتل والاستمرار في الجريمة وإنكار وجود الشعب، عندما يعتقدون أنه من الممكن له أن يستعيد علاقاته الدولية، ويكسب ثقة الحكومات وتعاونها، لمجرد تلويحه، كما بدأ يفعل مجدّدا، بخطر المنظمات الإرهابية، بعد أن ثبتت عليه تهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
تحرّر الثورة من أوهامها وقيودها
لولا الخوف من سقوط المزيد من الضحايا، بسبب استمرار الحرب، لقلت إنه من حسن الحظ أن النظام رفض التسوية، وتبع نصائح طهران التي لا تهتم بمصيره، لا فرداً ولا نظاماً، إلا
بمقدار ما يمكّنها من الاستمرار في تحقيق مشروعها الإمبرطوري، فقد كان من شأن التسوية أن تريحه، وربما تمدّد في أجل بقائه أكثر، نظراً لضعف المعارضة التي نشأت في حضن نظام الموت والتعقيم الفكري والسياسي والأخلاقي، والتي لا تزال، منذ أربع سنوات متواصلة، في موقف الدفاع البسيط عن نفسها ووجودها، ولم يعد لديها أي قدرة على التقدم، لا على المستوى السياسي لتوحيد المزيد من السوريين وتنظيمهم، لاجتراح معجزة إسقاط النظام بالقوة وبناء نظام جديد مكانه، ولا على المستوى العسكري الذي أغلق أفقه تغوّل التيارات الجهادية الأصولية المتطرّفة عليه، ومصادرتها ثورة الشعب، ووضعها في طريق مسدود على الصعيدين، الوطني والدولي معا.
ولذلك، بمقدار ما يشكل سقوط حلب نكسةً للمعارضة، يمكن أن يكون فرصةً لإعادة تأسيسها. وهو يوجه، بهذا المعنى، تحدياتٍ لا تقل خطورة للمعارضة التي أضاعت هويتها، قبل أن تصادرها القوى الأجنبية والدولية. ولن تستطيع أن ترد عليها، وتخرج من عجزها وضعفها، من دون ثورة داخل الثورة، أي ثورة على نفسها. والواقع أن جزءاً كبيرا من أسباب تعقد الأزمة السورية هو أن إنهاك النظام وسقوطه الفعلي أواخر 2012 لم يجد جوابه في معارضةٍ قادرةٍ على تشكيل البديل المقنع للشعب، أو للقوى الدولية المعنية بالشأنين، السوري والإقليمي. ولذلك، قبل الإعمار العمراني والمادي، يحتاج الخروج من المأزق والحرب الدائمة التي فرضها النظام وحماته إلى ثورةٍ، محورها إعادة البناء السياسي والفكري والأخلاقي داخل صفوف المعارضة وقوى الثورة والشعب معا، وهو ما يستدعي تشكيل أو ولادة نخبةٍ جديدةٍ من قلب الشعب، لا في سوق السياسة الزائفة، أي من قلب المعاناة ومن خلالها، نخبة لم تتعوّد الكذب والغش والبحث عن المنافع الفردية والمصالح الخاصة، ولم تترعرع في حجر نظام المحسوبية والزبونية والمراءاة، نظام الأسد الأب والابن وإمارته الشخصية أو مزرعته التي أصبحت تسمى دولة الأسد.
ونحن نشهد اليوم بالفعل، في موازاة موت قوى الثورة والمعارضة القديمة التي أضاعت هويتها، واختلطت أوراقها بالإرهاب والتطرف الديني والمذهبي، من بين ثنايا القوى المتهاوية في "الائتلاف" والفصائل المتعبة، وغيرها، وعلى أنقاضها، ولادة معارضةٍ جديدةٍ مختلفةٍ تماما، تخرج من تحت الأنقاض، ومن شقوقها وفي فراغاتها. هكذا نشهد بداية حواراتٍ جادة بين السوريين، لم يكن من الممكن سماعها من قبل أبدا، وانبثاق روح محركةٍ لوطنية جامحة، تركز على محبة البلد والأرض والتمسك بوحدتها وتنوعها وتاريخها.
على الرغم من الكارثة الإنسانية التي رافقته، يمكن لسقوط حلب الذي يخشى أن يكون مقدمة لحسم مصير ثورة الحرية والكرامة أن يكون بالعكس مناسبةً وشرطاً للخروج من الحصار الذي ضربته الثورة على نفسها في حلب، وفي سورية كلها، حصار عسكري بالتأكيد، ولكن أهم من ذلك سياسي وفكري وأخلاقي. والفرصة الأخيرة لتحرير الثورة من الاختناق وإخراجها من الأنفاق والطرق المسدودة التي سيقت إليها، وتحريرها من القيود والأنشوطات التي وضعتها معارضاتٌ ضعيفةٌ وعاجزة في عنقها، وكبلت بها يديها وأقدامها، وجعلتها تراوح في مكانها.
ثمن الحسم العسكري ومضمونه
في ما وراء تعبيره عن الارتهان للاستراتيجيات الاجنبية التي وقع أسيرها، يعكس الإصرار على إسقاط حلب التمسك، حتى النهاية، بمبدأ الحل العسكري، أي إبادة الخصم، والاستسلام النهائي لسياسة الهرب إلى الأمام التي أوصلته إلى قبول سياسة الإبادة الجماعية والمقامرة بمصير البلد نفسه.
وهذه السياسة ذاتها التي مكّنت الأسد، ومن حوله، من تحقيق وعده بالانتقام من السوريين، وتكبيدهم خسائر غير مسبوقة، ثمن رفضهم التمديد له، كما كان ينتظر أو ينتظره المستفيدون من نظامه، هي نفسها الفخ الذي نصبه لنفسه، ونصبه له الإيرانيون الطامعون في السيطرة على بلده، مستغلين مشاعر الحقد والانتقام هذه. ولا يمكن إلا للجاهل والأحمق أن لا يدرك أن التهرب من الاستجابة لتطلعات السوريين السياسية والانسانية، والرد عليها بالعنف، أو الاعتقاد بإمكانية الإعدام السياسي المستمر للشعب السوري، لم يساهما في إيجاد الحل للأزمة المستمرة منذ عقود، وإنما بالعكس عملا على تفجيرها في سياق الثورات العربية، وعمّقا الشرخ بين الحكم والشعب، حتى لم يعد هناك خيار لأي طرف غير السلاح والعنف. كما أن هذه السياسة التي أوصلت البلاد إلى أكبر كارثة إنسانية هي نفسها التي دفعت إلى الارتماء على الأجنبي، وتعميق التدخلات الخارجية بطلب من الأطراف السورية، وقادت إلى تغيير طبيعة الدولة والمجتمع معاً، ودمرت عرى التواصل والتفاهم بين أبناء المجتمع الواحد، وهي تهدد اليوم بالتحول إلى حرب إبادةٍ متبادلةٍ على مستوى المنطقة بأكملها.
يخطئ من يعتقد أنه سيكون هناك حل بعد الآن بالانتصار العسكري. بالعكس، تستخدم بعض
في هذه الحرب الذي حوّلها النظام إلى حرب وجود له كنظام، ومن ثم حرب وجود للشعب الثائر عليه، ما كان من الممكن للعنف إلا أن يتجه نحو حدوده القصوى، وأن يتحوّل الدمار والقتل بالجملة، وأعمال الإبادة المادية والسياسية للجماعات والطوائف والقوميات إلى حالةٍ عاديةٍ، تكاد تكون اليوم مقبولةً من الجميع، وتتم تحت إشراف ونظر الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي الإنسانية والحقوقية وبرعايتها. وكان من المنطقي أيضاً أن نفقد الخيارات جميعاً، كما لم يكن هناك مجال أن لا تتحول إلى حروب بالوكالة، وأن يُسلَّم القرار فيها للدول والقوى الخارجية، على مستوى النظام الذي أصبح كالخاتم في يد الدول المنتدبة والوصية عليه. وعلى مستوى المعارضات التي تتنازع على الحمايات الخارجية، بينما تفتح الفوضى والخراب السياسي والقانوني الباب على مصراعيه، لنمو المنظمات الإرهابية، الخارجة على القانون والنظام والمجتمع الدوليين، حتى توهمت أنها قادرة على بناء دولتها الخاصة، بل لبس عباءة الخلافة الإسلامية كاملة أو استعادتها.
لن يمكن لأي حكم أو نظام أو سلطة أن تستقر وتنجح في امتصاص النتائج المدمرة لهذه الحرب الظالمة الطويلة ضد الشعب السوري، بالاستمرار في إنكار حقيقة الثورة التي قام بها الشعب، ومن دون الرد الواضح والمباشر على مطالبها السياسية والأخلاقية والقانونية المتعلقة بالعدالة. لذلك، بعكس ما يتصوّره مهندسوه الروس والإيرانيون، قد يساعد سقوط حلب أو إسقاطها على تعزيز سيطرتهما المشتركة في سورية، وتحكمهما بالنظام، لكنه لن يفضي إلى أي حل. بالعكس، يعلن هذا النصر الذي تحقق على يد المليشيات الطائفية العراقية، وفي مقدمها مليشيا النجباء التي تخوض في وعيها حرباً دينيةً وطائفيةً وإحلاليةً في الوقت نفسه، نهاية
باختصار. لا يمكن للسياسة التي قادت إلى تفجير أكبر كارثة إنسانية في العصر، وجعلت من احتجاجات شعبية عادية حرباً متعدّدة الأطراف والأبعاد والرهانات، داخلية وإقليمية ودولية، في الوقت نفسه، أن تكون هي ذاتها الأساس لإعادة بناء سورية الواحدة والآمنة والمتضامنة والحرة والمستقلة.
لماذا لا يمكن للأسد أن يربح الحرب؟
سقوط حلب هو الإعلان عن نهاية سورية القديمة، معارضةً وحكومةً ونظاما وشعبا ودولةً، بمقدار ما هو نهاية الحلول السياسية، فسورية اليوم ركام من الأنقاض تنتظر من يزيلها، سورية الأسد وما بعده، سورية الحرب وتدخلات الدول الأجنبية وإرهاب الدولة وإرهاب الدين. وَمِمَّا إنه لن يكون من الممكن إعادة بناء الدولة بتكريس منطق الانحراف والجريمة، ولا إعمارها بسحق شعبها وإخراجه منها، لا يمكن كذلك إعادة جمعها وبنائها على شذرات أفكار وتجمعات وروابط محلولة. وتستهزئ الطغمة السورية ورعاتها من الصحفيين والمثقفين والسياسيين بأنفسهم، عندما يعتقدون أنهم يستطيعون فرض الخنوع على الشعب، وإعادة احتوائه بتوزيع بعض المناصب السياسية على المعارضة. أولاً، لأن السوريين جميعا، معارضين وموالين، فقدوا في مخاض الثورة العنيف والقاسي روح العبودية التي شلتهم في الماضي. وثانياً، لأن أحداً من غير المتورطين في الجريمة لن يقبل أن يكون شريكاً في المسؤولية عنها، وهي جريمة اغتيال شعب وتدمير شروط وجوده ورهن وطنه للأجنبي، لا يمكن غفرانها أو تجاوزها. وثالثاً، لأن أي سوري يحترم نفسه لن يقبل أن يكون عميلاً لسلطة الوصاية الأجنبية الذي يفخر بالإعلان عنها كل يوم المسؤولون الإيرانيون.
بالعكس، سيكتشف النظام بشكل أكبر في المستقبل أن إسقاط حلب كان نصراً فارغاً ربما أسوأ بكثير في مآلاته من الهزيمة، وأنه جاء ليؤكد تهافت النظام، وعجزه الولادي عن ممارسة السياسة أو دخولها. وبالتالي، عن التطبع والتطبيع، والخروج من صفة الاستثناء وحالة الطوارئ والحرب الدائمة. وهو يعبر أكثر عن إصراره على الانتحار مما يشير إلى انبعاثه. وبدل أن يساعده كما يعتقد على الرد على تحدي وجوده، سوف يدفعه بشكل أكبر إلى الموت تحت ركام المشكلات والنزاعات والتناقضات العميقة التي تنخر وجوده، والرد على التحديات الهائلة التي تواجهه، وفي مقدمها تغوّل الدول الأجنبية التي أصبحت حاميته، وتعدّد المليشيات المذهبية والقومية المنظمة والمدربة والممولة من الخارج، واستباحة الدولة من مختلف القوى والشبكات. لن يسمح مثل هذا الوضع ببناء دولةٍ ولا جيش، وليس من مصلحة أحد فيه أن يعود إلى فكرة الجيش الوطني، ولا حتى إصلاح الإدارة المدنية. فمن دون تسويةٍ سياسيةٍ، لن يكون أمامه خيار آخر سوى الاستمرار في استباحة الدولة ومؤسساتها، والمراهنة على تعبئة المليشيات الطائفية الأجنبية والمحلية، للحفاظ على السيطرة، وبالتالي، خيار الحرب الدائمة، كما هو العراق اليوم.
وبالمثل، لن يكون من الممكن إعادة بناء الدولة، وتحقيق الحد الأدنى من الأمن والاستقرار من
لن يكون هناك أي أملٍ في إعادة الإعمار، الذي تقدر تكاليفه بـ 300 مليار دولار، من دون تعبئة رجال الأعمال السوريين، وتعاون الدول الإقليمية والعالمية، وتغيير قواعد العمل السياسية وضمان الاستقرار والأمن والسلام وإمكانية استعادة رأس المال. وحتى أكثر الدول تساهلاً، لن تقبل المساهمة في استثمار مئات ملايين الدولارات خدمة للأسد وحلفائه، ودعماً لنظام يقوم على العنف وحكم المليشيات، ويفتقر لكل مقومات النظام السياسي والحكم القانوني والعدالة، عدا عن أنه متهم، وربما ملاحقٌ دوليا غداً، بقتل مئات الألوف من شعبه، وتشريد نصف سكان بلده، والتسبب في إعاقة دائمة أو شبه دائمة لأكثر من مليوني إنسان. ويحلم أنصار النظام ومشجعوه على القتل والاستمرار في الجريمة وإنكار وجود الشعب، عندما يعتقدون أنه من الممكن له أن يستعيد علاقاته الدولية، ويكسب ثقة الحكومات وتعاونها، لمجرد تلويحه، كما بدأ يفعل مجدّدا، بخطر المنظمات الإرهابية، بعد أن ثبتت عليه تهم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
تحرّر الثورة من أوهامها وقيودها
لولا الخوف من سقوط المزيد من الضحايا، بسبب استمرار الحرب، لقلت إنه من حسن الحظ أن النظام رفض التسوية، وتبع نصائح طهران التي لا تهتم بمصيره، لا فرداً ولا نظاماً، إلا
ولذلك، بمقدار ما يشكل سقوط حلب نكسةً للمعارضة، يمكن أن يكون فرصةً لإعادة تأسيسها. وهو يوجه، بهذا المعنى، تحدياتٍ لا تقل خطورة للمعارضة التي أضاعت هويتها، قبل أن تصادرها القوى الأجنبية والدولية. ولن تستطيع أن ترد عليها، وتخرج من عجزها وضعفها، من دون ثورة داخل الثورة، أي ثورة على نفسها. والواقع أن جزءاً كبيرا من أسباب تعقد الأزمة السورية هو أن إنهاك النظام وسقوطه الفعلي أواخر 2012 لم يجد جوابه في معارضةٍ قادرةٍ على تشكيل البديل المقنع للشعب، أو للقوى الدولية المعنية بالشأنين، السوري والإقليمي. ولذلك، قبل الإعمار العمراني والمادي، يحتاج الخروج من المأزق والحرب الدائمة التي فرضها النظام وحماته إلى ثورةٍ، محورها إعادة البناء السياسي والفكري والأخلاقي داخل صفوف المعارضة وقوى الثورة والشعب معا، وهو ما يستدعي تشكيل أو ولادة نخبةٍ جديدةٍ من قلب الشعب، لا في سوق السياسة الزائفة، أي من قلب المعاناة ومن خلالها، نخبة لم تتعوّد الكذب والغش والبحث عن المنافع الفردية والمصالح الخاصة، ولم تترعرع في حجر نظام المحسوبية والزبونية والمراءاة، نظام الأسد الأب والابن وإمارته الشخصية أو مزرعته التي أصبحت تسمى دولة الأسد.
ونحن نشهد اليوم بالفعل، في موازاة موت قوى الثورة والمعارضة القديمة التي أضاعت هويتها، واختلطت أوراقها بالإرهاب والتطرف الديني والمذهبي، من بين ثنايا القوى المتهاوية في "الائتلاف" والفصائل المتعبة، وغيرها، وعلى أنقاضها، ولادة معارضةٍ جديدةٍ مختلفةٍ تماما، تخرج من تحت الأنقاض، ومن شقوقها وفي فراغاتها. هكذا نشهد بداية حواراتٍ جادة بين السوريين، لم يكن من الممكن سماعها من قبل أبدا، وانبثاق روح محركةٍ لوطنية جامحة، تركز على محبة البلد والأرض والتمسك بوحدتها وتنوعها وتاريخها.
على الرغم من الكارثة الإنسانية التي رافقته، يمكن لسقوط حلب الذي يخشى أن يكون مقدمة لحسم مصير ثورة الحرية والكرامة أن يكون بالعكس مناسبةً وشرطاً للخروج من الحصار الذي ضربته الثورة على نفسها في حلب، وفي سورية كلها، حصار عسكري بالتأكيد، ولكن أهم من ذلك سياسي وفكري وأخلاقي. والفرصة الأخيرة لتحرير الثورة من الاختناق وإخراجها من الأنفاق والطرق المسدودة التي سيقت إليها، وتحريرها من القيود والأنشوطات التي وضعتها معارضاتٌ ضعيفةٌ وعاجزة في عنقها، وكبلت بها يديها وأقدامها، وجعلتها تراوح في مكانها.