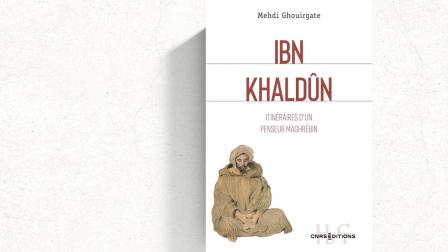(دار الآداب، بيروت، 2014)
منذ البداية يغوينا السرد بمتابعة القراءة، فنحن أمام صورة دراميّة، مغلّفة بالشعر والموسيقى، تلوذ بالماضي من موقع اليقظة من منام.
كتلة من المشاعر تتسرّب إلى قلب القارئ، وتغويه بمتابعة القراءة. إنّه أمام المشهد في ذروته: طفلة ترى خيالات نسوة يجمعن عظامها، وتسمع عظامها تتكسّر فوق التراب الجاف، وجدّتها تصرخ: "ماتت البنيّة ماتت".
من ذروةٍ للحدث تبدأ الراوية حكايتها، من حالةٍ تقارب الموت تبدأ رحلتها إلى الحياة. هذه الرحلة التي هي، وعلى مدى الرواية، رحلة التحوّل، تحوّل الأنثى الراوية، المنبوذة، المهانة، والمضاف إلى مكانتها الدونيّة في قريتها، قبحُها، وبدرجةٍ أكثر دراميّة، كره أمّها لها وكرهها هي لأمّها. لا تشير الراوية إلى أمّها، أو تذكرها، إلاّ بالاسم "عيْشة".
يضاعف القبح عبء الأنوثة على الأمّ، فتكره طفلتها. وتحاصَر الطفلة الأنثى، من قبل أقرانها بسبب دمامتها، فتكره منْ جاءتْ بها إلى الحياة، أمّها، وتتمنّى لو ماتت عند ولادتها. هكذا تقول: " أتمنّى لو أنّني لم أنج حين ولدت، ولم أنج حين وقعتُ من هنا" (ص104).
تبدو الأنوثة هنا، وفي أجمل معانيها وأكثرها عمقاً، ضدَّ الأنوثة. فالعلاقة بين الأمّ وابنتها منسوجة، وعلى مدى الرواية، بالحقد والكراهيّة المتبادلة. وتبدو الرواية، وعلى مدى صفحاتها، هي حكايةٌ لهذه الأنوثة ولطفولةٍ كان يمكن ألا تكون. حكاية لولادةٍ من رحم الموت: "كان يمكن أن تنتهي الحكاية باكراً، وأموت خفيفة وبريئة.." (ص 10).
الراوية القادمة إلى الحياة من رحم الموت، أنثى تنشد الحب، وتغرق في أسرار الطبخ، في لعبة تحويل مواده الأوليّة، في إبداع جماليّات هذا التحويل وسحر مذاقاته، وفي عبق تلك الروائح، روائح "صعتر ومردقوش وسمّاق وطيّون ومريميّة وزوفا، وطبعا زهور نارنج ". تحمل هذه الروائح دلالات الانتماء إلى القرية، إلى جمال طبيعتها ونقاوة هوائها، إلى التربة، إلى الجدّة، الجذر الطيب، المختلف... فالجدّة هي الوحيدة التي لم تقل لها يوماً أنت دميمة، بل كانت تحتضنها، ترعاها، تحكي لها الحكايات.. كأنّها ترسِّخ انتماءها إلى تلك الطبيعة وإلى جذورها الطيّبة.
تتبنّى الراوية فعل التحويل على مستوى حياتها وذاتها، كأنّها بذلك ترفض التخلّي عن أنوثتها، كما التماثل مع الذكر. أو كأنّها تودُّ أن تعيد صياغة المعادل القيمي، الجمالي، للأنوثة، وتمنحه معنى الحب والعطاء. تسعى لإتقان ما تطبخ، وكأنّها بذلك تحقِّق وجوداً متميّزاً لذاتها، يعوّضُها، ربّما، عن دمامتها، ويشعرها، في الآن نفسه، بالسعادة. "أحب أن تحتاج النسوة إليّ ويطلبن أن أصنع لهنّ حلاوة". تقول فخورةً بذاتها. (ص 60).
تربط الراوية (بسمة الخطيب) بين عشقها للشاب الذي كان يودّ الزواج من خالتها، الجميلة، فاطمة وبين عشقها للطبخ. أو، وبمعنى أعمّ وأعمق، تربط بين الحبّ وبين تحضير الطعام، فـ "الطبخ والحبّ ليسا شيئيْن مختلفيْن، لأنّ نتيجتهما واحدة وباعثهما واحد. حين تطبخ تقوم بفعل حب، وحين تحب تفكّر في أن تطبخ لحبيبك." (ص١٩٣). إنَّ الطبخ كما الحبّ فعلُ عطاءٍ يتبادله طرفان، ويعبّر عن رقيّ لمعنى العلاقة بين الذكر والأنثى. رقيّ نجد له، حسب الراوية، مثالاً في المسلسلات الأميركيّة حين يدعو الحبيب حبيبته للعشاء في منزله، ويعدّ لها أكثر ما يبرع فيه.
تعيد الكاتبة الاعتبار للجهد المادي الذي تبذله الأنثى في تحضير الطعام، ترفعه إلى مقام المشاعر التي تؤرّق العاشقين. كأنّها بذلك تسلّط ضوءاً يرينا، بالمقارنة، مأساة الأنثى في المجتمع الذي تعيش فيه، فلا قيمة لما تقدّمه، ولا حبّ ينعم به جسدُها وروحها. مجرّد جسد هي الأنثى، وللذكر، بصفته هذه، حقٌّ عليها بأن تلبّي حاجته الجنسيّةٍ.
تقدّم الروايةُ صوراً متعدّدة ومتنوّعة عن موقع الأنثى الدوني، الأنثى المحكومة بسلطة الذكورة وهيمنتها. تتساوى المرأة الجميلة والقبيحة في هذه المعاناة لمجرّد أنها أنثى، فتعاني الراوية القبيحة كما تعاني فاطمة الجميلة (خالة الراوية). كلّ نساء القرية يعشن هيمنة الزوج الذكر عليهن. هيمنة تتنوّع وتختلف. يقبل بها بعضهن كأنّها قدر، أو كأنّها حق للذكورة "هيدا حقو، دافعو من جيبتو" (ص209). حقّ مدفوع الثمن: كسوة وطعام وإيواء في بيت يسترها. ولا يقبل بها بعضهن الآخر، ولكن تبقى من تشكو بلا حول ولا قوة، شأن فاطمة أجمل جميلات القرية. المرأة في "برتقال مر"، أنثى مهملة، متروكة للعناء والحرمان. لا يشفع الجمال لها. أما الذكر، فلا يبخسه فقره أو دمامته، أو جهله شيئاً من حقّه فيها.
وحدها الراوية، الدميمة، صاحبة الندبة، ومن خلفها الكاتبة، تعيد صياغة معاني الأنوثة. تقف من جديد فوق الشرفة التي سقطت منها ولم تمت، تقف عاشقةً لمستقبلٍ تسعى إليه، لعشقٍ تُجمِّل نفسها كي تعيشه، لشابٍ هو صاحب القميص الأزرق "الذي يشبه آخر البحر، آخر ما يصل إليه نظري" (ص 24)، شاب له في هذا التشبيه (آخر البحر) دلالة الحلم. هو الحكيم الذي خطب خالتها الجميلة فاطمة وتركها ليسافر إلى موسكو.. والذي راحت في غيابه، تتذرّع بخدمة أمّه كي تدخل غرفته، تقرأه وكأنّها تتشرّبه، فيما هي تبثّ في حاجياته روائح نبتات تربة ضيعتها، و"ما زهر" البرتقال المر، كأنّما ليتشرّب من روائحها.
كلّ ما ترويه الراوية تجعله الكاتبة يحمل أكثر من معناه.. يتألقّ السرد بدلالاته الثريّة، يجنح إلى الإيحاء بحلم، حلم تصبو إلى تحقيقه الراوية، وتحكي عن سبل وصولها إليه، بدءاً من قبولها لذاتها الأنثويّة انتهاءً بالعمل على إعادة صياغتها.
تتذرّع الراوية بإقامة ندوة كي تعيده إليها.. تتجمّل، تُعِدُّ له أطباقاً من الطعام.. أطباقاً "فارقها للتو طعمُ طفولته ومراهقته..روائحها تأتي من زقاقٍ كانت تلعب فيه طفلة بشعرٍ قصير مشعّث، وعينيْن مذعورتيْن (ص 293). تعيش لحظات قدومه بارتباك، يرتبك السرد ليؤرجح دلالات المسرود بين الحلم والحقيقة.. فلا نعود نعرف إن كان الحبيب المدعو قد لبّى دعوة الحبيبة أم لا، قد حضر في مخيّلها أم في واقعها.. ولكن، يبقى أن ليس هذا المهم في الرواية، أو بالنسبة للكاتبة، المهم هو التحوّل، تحوّله هو إلى عاشق حقيقي مضمَّخ بروائح جذوره.
في الصفحات الأخيرة من الرواية، نقرأ أنّه لم يعد يتابع اختصاصه في الطب، بل انتقل إلى العمل "مخرجاً لأفلام تسجيليّة"، وأنّ "الفيلم الذي طالما انتظر أن تلهمه السماءُ بفكرته هو عن شجرة النارنج". شجرة المازهر، شجرة القرية، الشجرة التي عملت مع جدّتها على قطف أزهارها وتقطيرها، فكان المازهر... الذي ضمّخت به رسالة الحبّ الوحيدة التي أرسلتها إليه بلا توقيع.
تنتهي الرواية لتتركنا، نحن القراء، مضمّخين بعطر شجرة النارنج، وبسحر ما روته الراوية عن تحوّلاتها.
(كاتبة وروائية لبنانية)
كتلة من المشاعر تتسرّب إلى قلب القارئ، وتغويه بمتابعة القراءة. إنّه أمام المشهد في ذروته: طفلة ترى خيالات نسوة يجمعن عظامها، وتسمع عظامها تتكسّر فوق التراب الجاف، وجدّتها تصرخ: "ماتت البنيّة ماتت".
من ذروةٍ للحدث تبدأ الراوية حكايتها، من حالةٍ تقارب الموت تبدأ رحلتها إلى الحياة. هذه الرحلة التي هي، وعلى مدى الرواية، رحلة التحوّل، تحوّل الأنثى الراوية، المنبوذة، المهانة، والمضاف إلى مكانتها الدونيّة في قريتها، قبحُها، وبدرجةٍ أكثر دراميّة، كره أمّها لها وكرهها هي لأمّها. لا تشير الراوية إلى أمّها، أو تذكرها، إلاّ بالاسم "عيْشة".
يضاعف القبح عبء الأنوثة على الأمّ، فتكره طفلتها. وتحاصَر الطفلة الأنثى، من قبل أقرانها بسبب دمامتها، فتكره منْ جاءتْ بها إلى الحياة، أمّها، وتتمنّى لو ماتت عند ولادتها. هكذا تقول: " أتمنّى لو أنّني لم أنج حين ولدت، ولم أنج حين وقعتُ من هنا" (ص104).
تبدو الأنوثة هنا، وفي أجمل معانيها وأكثرها عمقاً، ضدَّ الأنوثة. فالعلاقة بين الأمّ وابنتها منسوجة، وعلى مدى الرواية، بالحقد والكراهيّة المتبادلة. وتبدو الرواية، وعلى مدى صفحاتها، هي حكايةٌ لهذه الأنوثة ولطفولةٍ كان يمكن ألا تكون. حكاية لولادةٍ من رحم الموت: "كان يمكن أن تنتهي الحكاية باكراً، وأموت خفيفة وبريئة.." (ص 10).
الراوية القادمة إلى الحياة من رحم الموت، أنثى تنشد الحب، وتغرق في أسرار الطبخ، في لعبة تحويل مواده الأوليّة، في إبداع جماليّات هذا التحويل وسحر مذاقاته، وفي عبق تلك الروائح، روائح "صعتر ومردقوش وسمّاق وطيّون ومريميّة وزوفا، وطبعا زهور نارنج ". تحمل هذه الروائح دلالات الانتماء إلى القرية، إلى جمال طبيعتها ونقاوة هوائها، إلى التربة، إلى الجدّة، الجذر الطيب، المختلف... فالجدّة هي الوحيدة التي لم تقل لها يوماً أنت دميمة، بل كانت تحتضنها، ترعاها، تحكي لها الحكايات.. كأنّها ترسِّخ انتماءها إلى تلك الطبيعة وإلى جذورها الطيّبة.
تتبنّى الراوية فعل التحويل على مستوى حياتها وذاتها، كأنّها بذلك ترفض التخلّي عن أنوثتها، كما التماثل مع الذكر. أو كأنّها تودُّ أن تعيد صياغة المعادل القيمي، الجمالي، للأنوثة، وتمنحه معنى الحب والعطاء. تسعى لإتقان ما تطبخ، وكأنّها بذلك تحقِّق وجوداً متميّزاً لذاتها، يعوّضُها، ربّما، عن دمامتها، ويشعرها، في الآن نفسه، بالسعادة. "أحب أن تحتاج النسوة إليّ ويطلبن أن أصنع لهنّ حلاوة". تقول فخورةً بذاتها. (ص 60).
تربط الراوية (بسمة الخطيب) بين عشقها للشاب الذي كان يودّ الزواج من خالتها، الجميلة، فاطمة وبين عشقها للطبخ. أو، وبمعنى أعمّ وأعمق، تربط بين الحبّ وبين تحضير الطعام، فـ "الطبخ والحبّ ليسا شيئيْن مختلفيْن، لأنّ نتيجتهما واحدة وباعثهما واحد. حين تطبخ تقوم بفعل حب، وحين تحب تفكّر في أن تطبخ لحبيبك." (ص١٩٣). إنَّ الطبخ كما الحبّ فعلُ عطاءٍ يتبادله طرفان، ويعبّر عن رقيّ لمعنى العلاقة بين الذكر والأنثى. رقيّ نجد له، حسب الراوية، مثالاً في المسلسلات الأميركيّة حين يدعو الحبيب حبيبته للعشاء في منزله، ويعدّ لها أكثر ما يبرع فيه.
تعيد الكاتبة الاعتبار للجهد المادي الذي تبذله الأنثى في تحضير الطعام، ترفعه إلى مقام المشاعر التي تؤرّق العاشقين. كأنّها بذلك تسلّط ضوءاً يرينا، بالمقارنة، مأساة الأنثى في المجتمع الذي تعيش فيه، فلا قيمة لما تقدّمه، ولا حبّ ينعم به جسدُها وروحها. مجرّد جسد هي الأنثى، وللذكر، بصفته هذه، حقٌّ عليها بأن تلبّي حاجته الجنسيّةٍ.
تقدّم الروايةُ صوراً متعدّدة ومتنوّعة عن موقع الأنثى الدوني، الأنثى المحكومة بسلطة الذكورة وهيمنتها. تتساوى المرأة الجميلة والقبيحة في هذه المعاناة لمجرّد أنها أنثى، فتعاني الراوية القبيحة كما تعاني فاطمة الجميلة (خالة الراوية). كلّ نساء القرية يعشن هيمنة الزوج الذكر عليهن. هيمنة تتنوّع وتختلف. يقبل بها بعضهن كأنّها قدر، أو كأنّها حق للذكورة "هيدا حقو، دافعو من جيبتو" (ص209). حقّ مدفوع الثمن: كسوة وطعام وإيواء في بيت يسترها. ولا يقبل بها بعضهن الآخر، ولكن تبقى من تشكو بلا حول ولا قوة، شأن فاطمة أجمل جميلات القرية. المرأة في "برتقال مر"، أنثى مهملة، متروكة للعناء والحرمان. لا يشفع الجمال لها. أما الذكر، فلا يبخسه فقره أو دمامته، أو جهله شيئاً من حقّه فيها.
وحدها الراوية، الدميمة، صاحبة الندبة، ومن خلفها الكاتبة، تعيد صياغة معاني الأنوثة. تقف من جديد فوق الشرفة التي سقطت منها ولم تمت، تقف عاشقةً لمستقبلٍ تسعى إليه، لعشقٍ تُجمِّل نفسها كي تعيشه، لشابٍ هو صاحب القميص الأزرق "الذي يشبه آخر البحر، آخر ما يصل إليه نظري" (ص 24)، شاب له في هذا التشبيه (آخر البحر) دلالة الحلم. هو الحكيم الذي خطب خالتها الجميلة فاطمة وتركها ليسافر إلى موسكو.. والذي راحت في غيابه، تتذرّع بخدمة أمّه كي تدخل غرفته، تقرأه وكأنّها تتشرّبه، فيما هي تبثّ في حاجياته روائح نبتات تربة ضيعتها، و"ما زهر" البرتقال المر، كأنّما ليتشرّب من روائحها.
كلّ ما ترويه الراوية تجعله الكاتبة يحمل أكثر من معناه.. يتألقّ السرد بدلالاته الثريّة، يجنح إلى الإيحاء بحلم، حلم تصبو إلى تحقيقه الراوية، وتحكي عن سبل وصولها إليه، بدءاً من قبولها لذاتها الأنثويّة انتهاءً بالعمل على إعادة صياغتها.
تتذرّع الراوية بإقامة ندوة كي تعيده إليها.. تتجمّل، تُعِدُّ له أطباقاً من الطعام.. أطباقاً "فارقها للتو طعمُ طفولته ومراهقته..روائحها تأتي من زقاقٍ كانت تلعب فيه طفلة بشعرٍ قصير مشعّث، وعينيْن مذعورتيْن (ص 293). تعيش لحظات قدومه بارتباك، يرتبك السرد ليؤرجح دلالات المسرود بين الحلم والحقيقة.. فلا نعود نعرف إن كان الحبيب المدعو قد لبّى دعوة الحبيبة أم لا، قد حضر في مخيّلها أم في واقعها.. ولكن، يبقى أن ليس هذا المهم في الرواية، أو بالنسبة للكاتبة، المهم هو التحوّل، تحوّله هو إلى عاشق حقيقي مضمَّخ بروائح جذوره.
في الصفحات الأخيرة من الرواية، نقرأ أنّه لم يعد يتابع اختصاصه في الطب، بل انتقل إلى العمل "مخرجاً لأفلام تسجيليّة"، وأنّ "الفيلم الذي طالما انتظر أن تلهمه السماءُ بفكرته هو عن شجرة النارنج". شجرة المازهر، شجرة القرية، الشجرة التي عملت مع جدّتها على قطف أزهارها وتقطيرها، فكان المازهر... الذي ضمّخت به رسالة الحبّ الوحيدة التي أرسلتها إليه بلا توقيع.
تنتهي الرواية لتتركنا، نحن القراء، مضمّخين بعطر شجرة النارنج، وبسحر ما روته الراوية عن تحوّلاتها.
(كاتبة وروائية لبنانية)