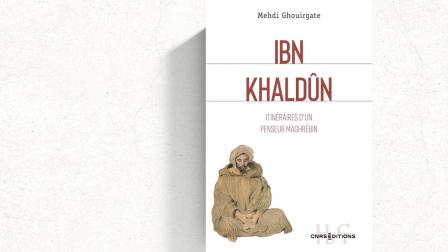لم تكن ضحى متدينة، على عكس إخوتها. وكانت بذلك أقربهم إلى والدهم ياسين. لكنها لم تكن ملحدة أيضاً، بل اكتفت باستبدال الدين في مرحلة مبكرة بمجموعة من السلوكيات الاجتماعية المفيدة عموماً. لم يقتصر شبهها بوالدها على ذلك فحسب، وإنما كان لاحقاً لما طاوله من مظهرها، فقد ورثت عنه بياض البشرة، وشُقرة الشعر، وتباين لون العينين بين الزُرقة والرمادية، وكانت بذلك ابنته المفضلة وبمثابة تحقق أمنية بالنسبة له.
كان ياسين من إحدى عائلات إقطاعيّي جسر الشغور السابقين، الذين حتّم ارتباطهم بالانتداب ترسخ مَثل الصفاء العرقيّ لديهم. كما كان ممن تحدثوا بالفرنسية وهذروا كلما سنحت لهم الفرصة عن تقدم الفرنساويين علينا في مختلف مجالات الحياة. وبسبب إصراره على استخدام مدفأة الفحم، حتى بعد انتشار المدفأة الكهربائية في المنازل، كونها كانت جزءاً من الماضي الأصيل، فقد توفي نائماً ذات يوم مسموماً بأول أكسيد الكربون.
كانت أعمار الإخوة عمر وبشرى وضحى بالترتيب وقتها: الثامنة عشرة، والسادسة عشرة، والرابعة عشرة.
بعد وفاة ياسين، أصبحت ملامح الأم أكثر قسوة وتعباً، وصارت كلماتها متفرقة، طافحة بالحزم، ومحاطة بصمت شفيف. وجلست مع عمر في غرفة الضيوف الغارقة بالظلال على الدوام، ورجته همساً بأن يكون أكثر لطفاً مع أختيه، وحدثته عن أهمية التعاضد العائلي بعد هذه الحادثة المأساوية، وأخبرته بأنها ستعمل خيّاطة في أحد المشاغل بدوام جزئي كي تستطيع إعالتهم بشكل أفضل. ثم جلست مع بشرى وضحى، وطلبت من بشرى أن تتولى الأعباء المنزلية عنها عند رجوعها من المدرسة، وكلّفت ضحى بإعانة أختها كلما استطاعت، ثم عانقتهما بحرارة.
كانت تلك بداية نهاية علاقة الأختين بعمر، الذي لم يجد لنفسه مساحة بين النسوة الباقيات، فصار يأوي إلى أصدقائه في المدرسة ويقضي – مثل والده الراحل – أغلب وقته خارج المنزل.
لم يتزامن دوام بشرى وضحى المدرسي، فكانت ضحى ترافق أمها إلى المشغل أحياناً، وتبقى مع بشرى في المنزل أحياناً أخرى. وقد اكتشفت في تلك المرحلة هوايتها المفضلة: قراءة الروايات البوليسية المترجمة والرخيصة، من موريس لوبلان، إلى أغاثا كريستي، وجورج سيمينون. وكانت تشارك كل من كان بقربها دهشتها وسعادتها عند الانتهاء من قراءة ما بيدها، وكان الشخص الوحيد الذي يعيرها اهتماماً حقيقياً هو بشرى، فقد مرّت عليها هي أيضاً فترة كانت فيها مهووسة بهذه الروايات. وعندما رأت اهتمام ضحى بها، لم تتوانَ عن منحها كل ما نال منه الغبار أو الرطوبة في مكتبتها الصغيرة.
لطالما شعرت بشرى برغبة جامحة – لم تفارقها يوماً – بحماية أختها من كل سوء، ولم يخفَ ذلك عن ضحى منذ الطفولة، فصارت بشرى بمثابة ملجأ دائم وثابت لها، وحافظة للأسرار التي لم تستطع كتمانها تماماً. مع ذلك كثيراً ما راودت ضحى الرغبة – المفهومة – بتجاوز أثر أختها عليها، فكانت تُفاجئها ما أمكنها الأمر، وشحذت انتباهها منذ مرحلة مبكرة كي يلتقط كل ما يصدر عن أفواه البالغين، ويُفسر أغلب ما تراه من الآخرين.
(تذكر بشرى أول مرة أتتها الدورة الشهرية. كانت في الصف السادس، وكانت المعلمة قد تغيّبت عن الحصة الأخيرة. وبينما أخذت الفتيات بالرسم والتحدث والجلوس أينما رغبن، واختلطت مع جلبتهن صنة العرق الغليظة برائحة شظايا أقلام الرصاص اللاذعة، دفنت هي رأسها بين ذراعيها وأغمضت عينيها، فقد اشتد عليها ألم معدتها وأعجزها عن الجلوس بثبات. ولم تدر سبب الألم لكنها ظنت أن وجبة الطعام التي تناولتها خلال الفسحة كانت مسؤولة عنه. وعندما أتت إحدى الفتيات لتطمئن على حالتها لم تستطع أن تجيبها، فتظاهرت بالنوم وغمغمت رداً عليها. وفي إحدى اللحظات شعرت بشيء غريب بين ساقيها، ولحسن الحظ كانت قماشة سروالها الداخلي ثخينة، فبعدما وصلت إلى المنزل، وبعدما أخبرت أمها عن الألم الغريب وتناولت القليل من الطعام، ذهبت إلى الحمام ورأت سروالها الداخلي وقد لُوث بياضه بدم غامق كمعجون الطماطم. تذكر بشرى هلعها، وأنها لم تدر من أين أتتها القدرة على مناداة أمها، التي سمعت الهلع في صوتها، فأتت مسرعة، واستوعبت المشهد، وهدأت من روعها. لسبب ما – ربما لانشغالها الدائم بشؤون المنزل – لم تخبرها أمها قبل ذلك عن الدورة الشهرية، ولم تدرك خطأها أو سهوتها إلا بعدما رأت الرعب الخالص في عيني ابنتها. ومنذ ذلك اليوم عاهدت بشرى نفسها بأن تخبر ضحى عن الدورة الشهرية قبل أن تكتشف أمرها لوحدها بالطريقة نفسها، لكنها عندما أخبرتها ذات مرة – وقد بدأ حديثها متردداً، بل كاد يكون هامساً – رفعت ضحى رأسها مما كان يشغلها، ورأت بشرى أحد عروق صدرها الضئيل، وكان هزيلاً باهت الخُضرة باعثاً على الحزن، ونظرت إليها بكل برود، وكانت لا تحدّج أحداً بتلك النظرة إلا عندما يسيء تقدير ذكائها، وقالت: أعرف. وبعد قليل من الصمت انفجرتا بالضحك).
كانت تلك أياماً غريبة على ضحى، لم تتذكر منها إلا شذرات اكتسبت مع مرور الوقت صبغة حلمية: الصباحات التي خرجت فيها لوحدها إلى المدرسة بعدما ودعتها أمها عند الباب، وصُفرة سماء الفجر تعكس برودة الهواء القاسية لسببٍ ما؛ السكون التام الذي كان يرين على المنزل كلما انتهت بشرى من أعمال المنزل، من تنظيف وطبخ وترتيب، إلى غسل للثياب ونشرها وكيّها؛ مشاوير الأختين مع أمهما إلى محل الحلويات القريب من الحارة لتناول الكيك بصمت وسعادة بعد صلاة المغرب؛ اللعب على الأرجوحة الصدئة في الحديقة العامة المُغبرة قرب البناية؛ منظر الجيران من النوافذ، بعدما صار بإمكان ضحى أن تسترق النظر منها (فقد كانت أمها تمنعها من ذلك تماماً)، وقد استحالت حياة كل من رأتهم صوراً متحركة ومؤطرة، أشلاء تجذبها وتحرضها على تخيّلها. وشعرت ضحى وقتئذ – وكان شعورها أكيداً كموجة هاجت في أعماقها – بأن هذه الأيام كانت أياماً فاصلة، وأن ما قبلها إن لم يكن مصيره النسيان، فهو لم يعد مسودة صالحة للمستقبل.
بعد أشهر قليلة، تخرج عمر من الثانوية العامة، وتمكن من الحصول على منحة دراسية في رومانيا، وغادر البلاد دون جلبة.
عندما تُرك المنزل للنسوة الثلاث، اكتست الأشياء فيه ألقاً حديثاً عليها، ولبست مساحاته سعة مخالفة لها. فأدركت ضحى، وكأنما لأول مرة، ثقل صحون السكر والملبس الكريستالية، وخفة المقولات والحكايا على قفا أوراق الرزنامة المعلقة، ورقّة ملائكة وذئاب البورسلان المخبأة في خزانة الأواني المحنطة، وصلابة تنجيد أرائك الروكوكو المقلّد في غرفة الضيوف، وعزلة أباريق الزهور الفارغة، ورائحة السجاد والغرف المهجورة التي غزت الهواء.
بعد سفر عمر بعدة أسابيع، زارت النسوة أخو الوالدة الكبير نعمان. كان نعمان رجلاً فارع الطول، مكتنز الهيئة، يُذكر المرء بالجبال، وكان شعره، الذي تساقط عند جبهته وارتفع كالكثب على الأطراف، فضياً، مترفاً، ممشطاً إلى الوراء، وكانت عدستا نظارته عاجية الإطار هائلتا الحجم مثله. كان حليق الوجه، دائم العبوس تقريباً، وكانت الابتسامة عندما تزور وجهه تبدو بشوشة بشكل مرعب.
عَمِل نعمان قاضياً، وكان يعيش مع زوجته نسرين في المنزل الكبير الذي ورثه عن والده. لم يكن لدى الزوجين أبناء، لذلك كان من المنطقي بالنسبة لهما أن يدعوا أخت نعمان وابنتيها ليعشن معهما. ورأت الوالدة في ذلك تغييراً حسناً فوافقت، وهاتفت عمر وأخبرته بالأمر، فلم يمانع.
لم تجد ضحى صعوبة في استيعاب التغيّر الجذري الذي حصل في حياتها بعد الانتقال إلى منزل خالها نعمان، بل رحّبت به، فقد كانت زوجته امرأة لطيفة، محبة للدعابة، رحّبت بالمقيمات الجديدات بحرارة وكياسة، ومازحت الأختين ولعبت معهما طوال الوقت، وعلّمتهما لعب الورق والطاولة على الأصول، وأخذتهما بعض الآصال التي انشغلت فيها الأم بشتى المهام إلى المطاعم والمقاهي الفاخرة.
كان المنزل الجديد عظيم المساحة، هائلاً كصاحبه، وكانت السجادات منثورة على بلاطه، ورسوم الشرق الأدنى ومخطوطات الآيات القرآنية مكتظة على جدرانه، وكانت الصالة الرئيسية وحدها – بأطقم أرائكها الثلاثة – بحجم المنزل السابق كله. وفي إحدى الزوايا قبع بيانو كان بأمس الحاجة إلى دوزنة، كما كان هناك تلفاز ضخم، ودولابان زجاجيان فيهما خزفيات وفناجين وأطباق ومباخر لم يلمسها أحد، ومكتبة حقوقية تراكم على محتوياتها الغبار، ولم تكن هناك زاوية بدون منضدة قهوة مطعمة بالفضة أو الصدف. كانت للمنزل ثلاث بلكونات، إحداها يمكن الخروج إليها من غرفة نوم نعمان وزوجته، والأخرى مخصصة للمطبخ، حيث كان يُنشر البصل والثوم والزنجبيل وأوراق الميرمية والسبانخ والملوخية، بالإضافة إلى كل المسّاحات والقشاطات وجرات الغاز الفارغة، أما الثالثة فالرئيسية، التي يمكن الذهاب إليها من الصالة الرئيسية، والتي كان الكل يسهر عليها حتى التعب. كانت هذه البلكونة تطل على عمارتين سكنيتين حجريتين بان طوبهما في عدة رقع، قرب بناء قرميدي مهجور وضخم، سُمي بالريجيه القديم.
كان من السهل إذاً على الأم أن تختلي بنفسها في هذه المساحات الشاسعة والدافئة، وأن تكتب رسائل طويلة لابنها البكر، بالرغم من أنه كان يفضل وضوحاً التحدث على الهاتف (وكان مواظباً على مهاتفتها كل أسبوعين مرة). فكتبت كثيراً، وشعرت بأن الكتابة تمنحها القدرة على التحدث بحرية أكبر، وبصراحة أقل، وأنها عندما تكتب تستطيع أن تفكر بوضوح وحدّة – وكم افتقدت هاتين الخاصيتين كلما فتحت فمها وتفوهت بكلمة!
لكن عمر لم يفهم أياً من ذلك بالطبع، فكان يلقي النكات المتفرقة – بخجل ولطف – بشأن حب أمه للكتابة، ما حملها على اعتزالها بكل هدوء.
في تلك الفترة تعرّفت ضحى وبشرى على ابني أخت نسرين، عبد الله وسليم، اللذين كانا في الثالثة والرابعة عشرة من عمريهما. كانا حسبما تذكر ضحى مرحين، عاليي الصوت، دائمي القذارة، وأخرقين ككل الأولاد في عمريهما. لكنها لا تذكر الكثير عنهما أو عن تلك الفترة، وإنما تذكر مشهدين معينين بكل وضوح:
الأول عندما كانا في المنزل – منزل نعمان – ذات مساء، وأشار عبد الله إلى الريجيه وأخبرها همساً بأنه يستخدم لإيواء المعتقلين وتعذيبهم، وأنه مسكون بأرواح البعض الذين قضوا نحبهم هناك. وعندما قالت له: إنك تكذب! نادى سليماً، وأكّد الأخير رواية أخيه، وأخبرها عن ألوان العذاب التي تذيقها المخابرات للمشتبهين، وقال:
– يكفي أن تعبسي وأنت تنظرين إلى صورة الرئيس كي يعتقلوك!
ثم قبض على قفا رقبتها كي يريها كيف تشج المخابرات الرؤوس المحزونة، لكن نسرين دخلت عليهم في تلك اللحظة وأنّبتهم بلهجة مازحة.
المشهد الثاني كان في مزرعة نعمان في ريف إدلب. كانت الشمس على وشك الغروب، وكانت السماء بلون الأقحوان، وكان الأولاد والبنات يتراكضون في الامتداد الأخضر الفسيح المسيّج بأشجار الصنوبر، ويختبئون بين شجيرات التفاح والخوخ والمشمش، ويدوسون على البرسيم والترمس والفصة المزروعة التي تكسرت بطراوة تحت أقدامهم ولطخت سراويلهم عندما وقعوا عليها. كم كان الهواء رقيقاً يومها.
ماذا حدث لهذين الولدين، بل لهذه العائلة؟ لا تعرف ضحى. ربما انتقلوا إلى محافظة أخرى. ربما اختفوا.
رغم جو المشاع الذي عمّ المنزل الكبير، إلا أن نعمان ونسرين حافظا على خصوصية الأم والابنتين بصرامة دقيقة، ولم تدخل نسرين، التي كانت وحدها ملكة المنزل، ترتبه وتمسح الغبار عن كل زواياه، غرفة الأم أو الأختين إلا بعد الاستئذان.
استكشفت بشرى مقدار تديّنها في تلك الأثناء، فلبست الحجاب وصارت تذهب بتشجيع من أمها إلى مسجد الحارة لتحفظ القرآن. ورغم أن نعمان لم يرضَ بذلك، إلا أنه لم يُشهر تحفظاته. لكن المرء لو نظر جيداً لرأى انقراص عينه اليُسرى كلما خرجت بشرى واتجهت إلى المسجد. أما ضحى، فازدادت رقعة قراءاتها اتساعاً، وأفصحت لبشرى عن كل جديد في تأملاتها، واستمعت إليها بشرى في المساءات الطويلة، ووجهها الشاحب والرقيق تضيئه هالة من نور انكسرت على تجعيدات ضئيلة وسابقة لأوانها أخذت تظهر حول عينيها. كانت ضحى، التي عاشت مستترة أكثر من أختها، ساذجة إلى حد كبير، بالرغم من لمعان مخيلتها وسرعة بديهتها – أي كانت عواطفها بسيطة ومتينة، تقسم العالم إلى فسطاطين لا ثالث لهما: أخيار وأشرار. أما بشرى فكانت أكثر دراية بالعالم، وكانت تدرك أن الحقيقة لا تتسق على الدوام مع السرور، وأن للواقع أوجه لا تراها ولا تستطيع رؤيتها، وأن ذلك من حسن حظها.
وعندما تخرّجت بشرى من الثانوية العامة قررت الالتحاق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة تشرين. وفي أحد أيام عامها الدراسي الثاني، تأخرت في الرجوع إلى المنزل، فأثارت قلق أمها، وكان لقلقها كثافة مُعدية جعلت الوقت يبدو أبطأ لكل الجالسين من حولها في الصالون المُضاء، وكأن الدقائق لم تعدُ وإنما عرجت. وعندما سمعت صوت العدو الفوضوي لبعض الأطفال على الدرج في الخارج كادت أن تنهض، لكن نعمان رفع حاجبيه دون أن يزيح نظره عن شاشة التلفاز الشاحبة، وقال:
– إيه، ما بالنا؟
تمتمت شيئاً غير مسموع، ثم اتجهت إلى المطبخ. بعد قليل نهض نعمان ولحق بها، ورآها متكئة على الرف الرخامي، وكأن بطنها يوجعها. وقالت:
– لقد تأخرت بشرى. أكثر من نصف ساعة الآن. أنا قلقة عليها.
– أعرف أنك قلقة. ذلك واضح تماماً.
– هذا ليس وقتك.
– طيب. أقترح أن نمنحها المزيد من الوقت. قد ترجع في أي لحظة الآن.
لكنها لم تفعل. وبعد ما يزيد عن ساعة تقريباً، رن أحدهم جرس الشقة، فهرعت الوالدة، وهرعت ضحى برفقتها إلى الباب، وعندما فتحته رأت فتاة قصيرة، مربوعة، محجبة، ذات وجه دائري وبشرة دهنية وعينين مكورتين، تأتأت وأبصارها معلقة بأرضية العتبة بعبارات لم تفهمها الوالدة أو ابنتها، عبارات كان لها صوت اللغة الأجنبية.
شبيحة. جاؤوا واعتقلوا الكثير. محجبات. إخوان.
استدارت الوالدة ونادت بصوت ضعيف: نعمان! لكنها فوجئت بوقوفه وراءها مباشرة، وهمست: مـ .. ماذا؟ ماذا تقول؟ فأمسك بكتفيها وأمرها بالتزام الهدوء، وقال لضحى:
– أدخلي أمكِ كي أعرف حلاً لهذه القصة. صبي لها كأساً من الماء.
ثم طلب من الفتاة أن تدخل، لو سمَحت. لم ترَ ضحى أمها بهذا الوهن يوماً، وأخافها ذلك. وعندما حاولت إدخالها، أبعدت أمها يدها وقالت بشراسة مُفاجئة: أفلتي! ثم دخلت مع البقية بصمت.
وبعدما سمع نعمان ما حدث مع البنات، وأخرس الوالدة مراراً، ومنعها من طرح الأسئلة، نهض وقال بشكل قاطع: سأذهب لأرى ما يمكننا فعله.
ثم شكر الفتاة وشيّعها إلى الباب، وغيّر ثيابه وخرج، وبقيت أم ضحى جالسة في مكانها.
لم تقوَ الأم على العويل، حتى عندما أتت نسرين وضمت كتفيها، بل بكت بحرقة صامتة أبكت ضحى أيضاً، وأعطتهما نسرين بعض المناديل الورقية. وعندما حاولت الأم النهوض والبحث عن ابنتها في الشارع وهي تصيح: عليّ إيجاد بشرى! أقعدتها نسرين وضحى وهما تغمغمان وتطلبان منها الاستهداء بالله، وحضّرت نسرين بعض البابونج وصبته في كؤوس بردت ولم تُلمس. وبعدما هدأت قليلاً، أخذت تتمتم لنفسها وهي تحدق في الفراغ:
– لعله خير، لعله خير.
ثم مسحت أنفها وقالت بسرعة:
– لنرَ ما سيحصل مع نعمان.
بعد مرور ساعتين خانقتين رجع نعمان، ولم ينبس ببنت شفة حتى جلس وجال بناظريه على وجوه الجميع، ثم ردد بعبارات أكثر ترابطاً ووضوحاً ما سمعوه من فم الفتاة: أن بشرى قد اعتُقلت هي ومجموعة من زميلاتها بتهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين.
في الأحلام التي راودتها، رأت ضحى أمها جالسة حيث كانت، وعيناها هاويتان كاحلتا السواد كالفحم، وفمها الفاغر يرتجف بعض الشيء، وجسدها بأكمله جامدٌ تماماً.
* كاتب سوري والنص مقطع من قصة طويلة