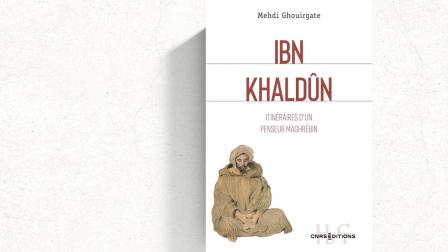"الجنة الآن"، هاني أبو أسعد
يكمن اختيار السينما الفلسطينية عنواناً لنقاش نقديّ يتناول تطوّرها الجمالي والفني والدرامي، ويُساجل كيفية مقارباتها الأسئلة العامّة والحكايات الفردية، في أن صناعتها تُطوّر، منذ أعوام عديدة، لغتها السينمائية في التواصل مع المسائل العامّة، عبر حكايات فردية كثيرة.
مسار تطوّري
الجواب نفسه يحاول رسم خريطة واقع حراك سينمائي مُعتمل داخل البيئة الفلسطينية في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، أو في المخيمات المُقامة في دول عربية (لبنان وسورية والأردن)، أو في بلاد الاغتراب الأوروبي. خريطة تقول إن تقدّماً إيجابياً كبيراً تعرفه الأفلام الفلسطينية، وإن إبداعاً (شكلاً ومضموناً وآلية معالجة واشتغالات فنية وتقنية)، يُصنع عبرها وفيها، وإن نقاشاً جمالياً وفكرياً وإنسانياً، يُصاغ بإنجاز أفلام تخرج عن التسجيليّ المباشر، وتولي الصورة السينمائية أهمية أولى، ولا تتردّد في مخاطبة العقل والروح والقلب معاً بشتّى المواضيع، ولا تنسى أن المجتمع الفلسطيني في إسرائيل يعاني مآزق وارتباكات ليس بسبب الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية العنصرية ضدّه فقط، بل أيضاً بسبب موروث اجتماعي ـ ثقافي ـ تربوي ـ حياتيّ يوميّ، متأتٍ من تفكير مُحافظ وتقليدي ومنغلق على نفسه، تعرفه المجتمعات العربية برمّتها.
تبلغ السينما الفلسطينية مرتبة متقدّمة في المشهد العربي العام، بفضل إنتاجات تستفيد من تاريخ مثقل بالإيديولوجيا والتصوير التسجيلي والتراكم المديد لكَمّ هائل من العناوين المنصبّة بغالبيتها الساحقة على أرشفة اللحظة وتأريخها إلى حدّ كبير، وتُتقن الفحوى الجماليّة لفنّ الصورة السينمائية المتطوّرة في الغرب، فتجيّره لمصلحة الحكاية والسينما معاً في أفلام مستلّة من الهمّ الفلسطيني في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، وفي الشتات الفلسطيني. حيوية سينما كهذه ناشئة من تداخل الماضي بالراهن على مستوى صناعة الصورة، إذ يتنبّه سينمائيون فلسطينيون كثيرون إلى النتاج السابق، بإيجابياته وسلبياته، لكنهم يتوجّهون إلى أفق إبداعي أهمّ وأجمل وأعمق، بالتركيز على أولوية صورة نقيّة في اشتغالاتها الفنية والتقنية والدرامية، وفي كيفية مقاربة الأسئلة كلّها من دون تردّد. أفلامٌ فلسطينية عديدة منجزة في الأعوام القليلة الفائتة تؤكّد معنى الاستفادة من الموروث الإنتاجيّ بتفاصيله كلّها، ومن حيوية المتخيّل في ذات المخرج وانفعاله وتأثّراته، ومن تطوّر التقنيات السينمائية الغربية.
يمكن القول إن فوز إيليا سليمان بجائزة لجنة التحكيم الخاصّة بالدورة الـ55 لمهرجان "كان" السينمائي عن فيلمه "يد إلهية"، لحظة تحوّل تاريخي ـ إبداعي بالنسبة إلى صناعة سينما فلسطينية تجديدية. علماً أن سليمان نفسه يفوز بجائزة أفضل أوّل فيلم روائي طويل في الدورة الـ53 لمهرجان البندقية عن فيلمه "سجل اختفاء". إنه تأسيسٌ جديد في المسار التاريخي هذا، ومحطّة تأمّل في كيفية تحرير النصّ السينمائي الفلسطيني من خطابيته وإيديولوجيته وانغماسه الكبير في الثرثرة الكلامية والبصرية، وفي تفعيل الأبعاد السينمائية كلّها في سرد الحكاية الفلسطينية. ولعلّ اعتماده على سيرة ذاتية ـ حياتية (أو مقتطفات منها)، وعلى حضور تمثيليّ له أيضاً في أفلامه الثلاثة، عامِلَين أساسيين في بلورة صورة سينمائية فلسطينية تنطلق من الذاتيّ البحت إلى واقع جماعي، في التاريخ والجغرافيا والعيش والعلاقات وتفاصيل الحياة اليومية، وربما إلى ما هو أبعد وأعمق من هذا كلّه أيضاً: تفكيك بُنى المجتمع الفلسطينيّ لكشف جوهره العام.
اقرأ أيضاً: مدينة السينما الفاضلة
لغة تجديدية
ميشيل خليفي أحد المخرجين الفلسطينيين القلائل الساعين لابتكار لغة جديدة في التعاطي مع السؤال الفلسطيني، خصوصاً في المراحل الأولى من اشتغالاته السينمائية، بين فيلمي "الذاكرة الخصبة" و"نشيد الحجر"، من دون تناسي أهمية النصّ الوثائقيّ في "الزواج المختلط في الأراضي المقدّسة"، علماً أن تعاونه مع المخرج الإسرائيلي إيال سيفان في "الطريق 181، مقاطع رحلة في فلسطين ـ إسرائيل"، يُنتج عملاً وثائقياً بالغ الأهمية على مستويي الشكل والمضمون، وإن يُردّد نقّادٌ عربٌ عديدون بأن الجزء الخاصّ بالمخرج الإسرائيلي يبقى الأهمّ والأعمق فنياً ودرامياً وآلية معالجة.
لن تكون أهمية النتاجات الروائية والوثائقية، وإن بتفاوت إبداعي بينها، لخليفي كامنةٌ في تخطّيه المألوف في معاينة الواقع الفلسطيني فقط، لأنه يُدرك منذ البداية أن على السينما التحرّر من نزواتها الانفعالية البحتة، كي تبوح بشيء من وقائع العيش على التخوم القاسية مع الاحتلال، وإن يشوب أعمالَه اللاحقة كثيرٌ من التبسيط والعاديّ. في العام 1987، يُنجِز "عرس الجليل"، الذي يُصبح مباشرة أحد أهمّ الأفلام الفلسطينية المؤسِّسة لانطلاقة تجديدية في السينما الفلسطينية: قراءة واقع اجتماعي فلسطيني في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، من دون الإسراف في جَلد النفس، وبعيداً عن أي تزلّف للإسرائيلي، لأن خليفي يتوغّل في أعماق البيئة الاجتماعية الثقافية الإنسانية الفلسطينية المُقيمة في ظلّ احتلال إسرائيلي، من دون أن ينسى قسوة الاحتلال نفسه، وتأثيراته السلبية على البيئة هذه.
سينمائياً، يُزَاوج "عرس الجليل" بين سرد يتماهى بارتباكات شخصيات ممزّقة، وشكل يحاول أن يواكب نصّاً بصرياً مفعماً بأحاسيس ووقائع، وواقعياً إلى أبعد حدّ ممكن. فالعجز الجنسي ليس نتاج احتلال وقمع فقط، لأنه نابعٌ من موروث اجتماعي عربي تقليدي ومتزمّت منذ سنين بعيدة. والحاكم العسكري الإسرائيلي يُدرك أن غيابه عن العرس لا يُفيده بشيء، لأنه مقتنعٌ بأن حضورَه ترجمةٌ لبطشه وقسوته وغرائزه، وإن يُظهِر أمام الملأ الفلسطيني بساطته وعفويته وتفاعله الإيجابي وحرصه على سعادة وليلة هانئة.
جذور
تكمن "جذور" التطوّر البصريّ للصورة السينمائية الفلسطينية في اشتغالات ميشيل خليفي، السابقة بأعوام قليلة على انطلاقة إيليا سليمان، البارع في تفعيل تطوّر بصريّ، يُشكّل مساهمة فعّالة في تأسيسٍ عمليٍ لصورة أجدّ وأعمق وأجمل وأقوى تأثيراً وبراعة في مخاطبة عرب وغربيين معاً. لكن، قبلهم، في مخاطبة محبّي السينما، الذين يرون في أفلامه القصيرة والطويلة شيئاً لامعاً ورائعاً من سينما تستند إلى مقولات علمية وفكرية وتأمّلية في صناعة أفلام تولي أهمية بارزة للصورة وصناعتها، وتضع الحكايات في سياق متتالٍ من جمالية سرد يؤدّي إلى كشف الكثير من المستور الفلسطيني.
بفضل المشاركة في فيلمين له هما "إيليا إيليا لما شبقتني" في الفيلم الجماعي "الحلم العربي" و"سجل اختفاء"، تنطلق عُلا طبري في عالم مليء بحراك إبداعي يريد التوغّل في بنية الإنسان الفلسطيني ومحيطه المتنوّع، فإذا بها تُحقّق بضعة أفلام كمخرجة وممثلة. لكن رائعتها الإخراجية تبقى "خلقنا وعلقنا"، بتحويل الصورة السينمائية الوثائقية إلى مرايا تعكس بعض يوميات العيش الفلسطيني في إسرائيل. بهذا الفيلم، يزداد الاهتمام الفلسطيني بجغرافيا محدّدة بـ"دولة إسرائيل"، وبأفراد فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، علماً أن نزار حسن يُعتبر أحد أبرز المخرجين العاملين في كشف حقائق العيش فيها، مستخدماً أسلوباً وثائقياً في مُقاربة أحوال الناس، وكيفية عيشهم في قلب صراع يوميّ مع المحتلّ. لكن "عطش"، لتوفيق أبو وائل، يبقى أحد أبرز وأهمّ الأفلام، شكلاً ومضموناً، المنصبّة في سرد حكاية فلسطينية في إسرائيل، إذ يعود المخرج الشاب إلى قريته أم الفحم (مقاطعة حيفا)، لرواية تفاصيل يومية من حياة عائلة. الجمالية البصرية تُغلّف معاينة درامية متماسكة في بنائها السرديّ، وتقنياتها المختلفة، كالتصوير والمونتاج وإدارة الممثلين إلخ.
من جهته، يصل هاني أبو أسعد بالفيلم الفلسطيني إلى أمكنة "محرّمة" إلى حدّ بعيد، خصوصاً في "الجنّة الآن" (أوّل فيلم فلسطيني يحصل على جائزة "غولدن غلوب"، التي تمنحها سنوياً، منذ العام 1944، "جمعية الصحافيين السينمائيين الأجانب في هوليوود"، في دورة العام 2005، في فئة أفضل فيلم أجنبي، ويتمّ ترشيحه لجائزة "أوسكار"، التي تمنحها سنوياً، منذ العام 1929، "أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية" في هوليوود أيضاً، في الفئة نفسها)، إذ يطرح فيه سؤال العمليات الاستشهادية ـ الانتحارية، من خلال شخصيتي شابين يلتزمان تنفيذ إحدى هذه العمليات، فيواجهان أشدّ أنواع الأسئلة المتعلّقة بالموت، والصراع مع الذات من أجل الحياة، ومعنى العيش في ظلّ موروث العمالة لإسرائيل، إلخ. العمالة هذه مطروحة أيضاً في "عمر" (2013، الجائزة الخاصّة بمسابقة "نظرة ما"، في الدورة الـ66 لمهرجان "كانّ"، والمرشّح لـ "أوسكار" أفضل فيلم أجنبي في دورة العام 2014)، من خلال قصّة 3 أصدقاء تُفرّقهم أحوال اليوميّ المنغمس إما في صراع مع إسرائيل، وإما في مواجهة انفعال يؤدّي بصاحبه إلى انتزاع حبيبة صديق له منه. قصّة حبّ موؤود، معطوفة على جهاد ضدّ محتل، ومهتمّة بسؤال العمالة. البناء الدرامي في الفيلمين مفتوحٌ على جمالية الصورة في مقاربة السيَر الحياتية لشخصيات غارقة في متاهات الألم والتمزّق والرغبة في الانعتاق من بؤس الشقاء اليوميّ، عبر الإيغال في البيئة المجتمعية الفلسطينية، وفي الصراع مع إسرائيل.
نماذج كهذه تُضيء شيئاً من أحوال سينما فلسطينية متجدّدة في مقارباتها الإنسانية وأسئلتها الأخلاقية والحياتية، من دون أن تُلغي نماذج أخرى تراوح بين جدّية فنية ـ تقنية في متابعة الهوامش الفلسطينية وتأريخ مضامينها المتفرّقة، وتبسيط شكليّ لنواة درامية مهمّة.
(كاتب لبناني)
مسار تطوّري
الجواب نفسه يحاول رسم خريطة واقع حراك سينمائي مُعتمل داخل البيئة الفلسطينية في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، أو في المخيمات المُقامة في دول عربية (لبنان وسورية والأردن)، أو في بلاد الاغتراب الأوروبي. خريطة تقول إن تقدّماً إيجابياً كبيراً تعرفه الأفلام الفلسطينية، وإن إبداعاً (شكلاً ومضموناً وآلية معالجة واشتغالات فنية وتقنية)، يُصنع عبرها وفيها، وإن نقاشاً جمالياً وفكرياً وإنسانياً، يُصاغ بإنجاز أفلام تخرج عن التسجيليّ المباشر، وتولي الصورة السينمائية أهمية أولى، ولا تتردّد في مخاطبة العقل والروح والقلب معاً بشتّى المواضيع، ولا تنسى أن المجتمع الفلسطيني في إسرائيل يعاني مآزق وارتباكات ليس بسبب الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية العنصرية ضدّه فقط، بل أيضاً بسبب موروث اجتماعي ـ ثقافي ـ تربوي ـ حياتيّ يوميّ، متأتٍ من تفكير مُحافظ وتقليدي ومنغلق على نفسه، تعرفه المجتمعات العربية برمّتها.
تبلغ السينما الفلسطينية مرتبة متقدّمة في المشهد العربي العام، بفضل إنتاجات تستفيد من تاريخ مثقل بالإيديولوجيا والتصوير التسجيلي والتراكم المديد لكَمّ هائل من العناوين المنصبّة بغالبيتها الساحقة على أرشفة اللحظة وتأريخها إلى حدّ كبير، وتُتقن الفحوى الجماليّة لفنّ الصورة السينمائية المتطوّرة في الغرب، فتجيّره لمصلحة الحكاية والسينما معاً في أفلام مستلّة من الهمّ الفلسطيني في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، وفي الشتات الفلسطيني. حيوية سينما كهذه ناشئة من تداخل الماضي بالراهن على مستوى صناعة الصورة، إذ يتنبّه سينمائيون فلسطينيون كثيرون إلى النتاج السابق، بإيجابياته وسلبياته، لكنهم يتوجّهون إلى أفق إبداعي أهمّ وأجمل وأعمق، بالتركيز على أولوية صورة نقيّة في اشتغالاتها الفنية والتقنية والدرامية، وفي كيفية مقاربة الأسئلة كلّها من دون تردّد. أفلامٌ فلسطينية عديدة منجزة في الأعوام القليلة الفائتة تؤكّد معنى الاستفادة من الموروث الإنتاجيّ بتفاصيله كلّها، ومن حيوية المتخيّل في ذات المخرج وانفعاله وتأثّراته، ومن تطوّر التقنيات السينمائية الغربية.
يمكن القول إن فوز إيليا سليمان بجائزة لجنة التحكيم الخاصّة بالدورة الـ55 لمهرجان "كان" السينمائي عن فيلمه "يد إلهية"، لحظة تحوّل تاريخي ـ إبداعي بالنسبة إلى صناعة سينما فلسطينية تجديدية. علماً أن سليمان نفسه يفوز بجائزة أفضل أوّل فيلم روائي طويل في الدورة الـ53 لمهرجان البندقية عن فيلمه "سجل اختفاء". إنه تأسيسٌ جديد في المسار التاريخي هذا، ومحطّة تأمّل في كيفية تحرير النصّ السينمائي الفلسطيني من خطابيته وإيديولوجيته وانغماسه الكبير في الثرثرة الكلامية والبصرية، وفي تفعيل الأبعاد السينمائية كلّها في سرد الحكاية الفلسطينية. ولعلّ اعتماده على سيرة ذاتية ـ حياتية (أو مقتطفات منها)، وعلى حضور تمثيليّ له أيضاً في أفلامه الثلاثة، عامِلَين أساسيين في بلورة صورة سينمائية فلسطينية تنطلق من الذاتيّ البحت إلى واقع جماعي، في التاريخ والجغرافيا والعيش والعلاقات وتفاصيل الحياة اليومية، وربما إلى ما هو أبعد وأعمق من هذا كلّه أيضاً: تفكيك بُنى المجتمع الفلسطينيّ لكشف جوهره العام.
اقرأ أيضاً: مدينة السينما الفاضلة
لغة تجديدية
ميشيل خليفي أحد المخرجين الفلسطينيين القلائل الساعين لابتكار لغة جديدة في التعاطي مع السؤال الفلسطيني، خصوصاً في المراحل الأولى من اشتغالاته السينمائية، بين فيلمي "الذاكرة الخصبة" و"نشيد الحجر"، من دون تناسي أهمية النصّ الوثائقيّ في "الزواج المختلط في الأراضي المقدّسة"، علماً أن تعاونه مع المخرج الإسرائيلي إيال سيفان في "الطريق 181، مقاطع رحلة في فلسطين ـ إسرائيل"، يُنتج عملاً وثائقياً بالغ الأهمية على مستويي الشكل والمضمون، وإن يُردّد نقّادٌ عربٌ عديدون بأن الجزء الخاصّ بالمخرج الإسرائيلي يبقى الأهمّ والأعمق فنياً ودرامياً وآلية معالجة.
لن تكون أهمية النتاجات الروائية والوثائقية، وإن بتفاوت إبداعي بينها، لخليفي كامنةٌ في تخطّيه المألوف في معاينة الواقع الفلسطيني فقط، لأنه يُدرك منذ البداية أن على السينما التحرّر من نزواتها الانفعالية البحتة، كي تبوح بشيء من وقائع العيش على التخوم القاسية مع الاحتلال، وإن يشوب أعمالَه اللاحقة كثيرٌ من التبسيط والعاديّ. في العام 1987، يُنجِز "عرس الجليل"، الذي يُصبح مباشرة أحد أهمّ الأفلام الفلسطينية المؤسِّسة لانطلاقة تجديدية في السينما الفلسطينية: قراءة واقع اجتماعي فلسطيني في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي، من دون الإسراف في جَلد النفس، وبعيداً عن أي تزلّف للإسرائيلي، لأن خليفي يتوغّل في أعماق البيئة الاجتماعية الثقافية الإنسانية الفلسطينية المُقيمة في ظلّ احتلال إسرائيلي، من دون أن ينسى قسوة الاحتلال نفسه، وتأثيراته السلبية على البيئة هذه.
سينمائياً، يُزَاوج "عرس الجليل" بين سرد يتماهى بارتباكات شخصيات ممزّقة، وشكل يحاول أن يواكب نصّاً بصرياً مفعماً بأحاسيس ووقائع، وواقعياً إلى أبعد حدّ ممكن. فالعجز الجنسي ليس نتاج احتلال وقمع فقط، لأنه نابعٌ من موروث اجتماعي عربي تقليدي ومتزمّت منذ سنين بعيدة. والحاكم العسكري الإسرائيلي يُدرك أن غيابه عن العرس لا يُفيده بشيء، لأنه مقتنعٌ بأن حضورَه ترجمةٌ لبطشه وقسوته وغرائزه، وإن يُظهِر أمام الملأ الفلسطيني بساطته وعفويته وتفاعله الإيجابي وحرصه على سعادة وليلة هانئة.
جذور
تكمن "جذور" التطوّر البصريّ للصورة السينمائية الفلسطينية في اشتغالات ميشيل خليفي، السابقة بأعوام قليلة على انطلاقة إيليا سليمان، البارع في تفعيل تطوّر بصريّ، يُشكّل مساهمة فعّالة في تأسيسٍ عمليٍ لصورة أجدّ وأعمق وأجمل وأقوى تأثيراً وبراعة في مخاطبة عرب وغربيين معاً. لكن، قبلهم، في مخاطبة محبّي السينما، الذين يرون في أفلامه القصيرة والطويلة شيئاً لامعاً ورائعاً من سينما تستند إلى مقولات علمية وفكرية وتأمّلية في صناعة أفلام تولي أهمية بارزة للصورة وصناعتها، وتضع الحكايات في سياق متتالٍ من جمالية سرد يؤدّي إلى كشف الكثير من المستور الفلسطيني.
بفضل المشاركة في فيلمين له هما "إيليا إيليا لما شبقتني" في الفيلم الجماعي "الحلم العربي" و"سجل اختفاء"، تنطلق عُلا طبري في عالم مليء بحراك إبداعي يريد التوغّل في بنية الإنسان الفلسطيني ومحيطه المتنوّع، فإذا بها تُحقّق بضعة أفلام كمخرجة وممثلة. لكن رائعتها الإخراجية تبقى "خلقنا وعلقنا"، بتحويل الصورة السينمائية الوثائقية إلى مرايا تعكس بعض يوميات العيش الفلسطيني في إسرائيل. بهذا الفيلم، يزداد الاهتمام الفلسطيني بجغرافيا محدّدة بـ"دولة إسرائيل"، وبأفراد فلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية، علماً أن نزار حسن يُعتبر أحد أبرز المخرجين العاملين في كشف حقائق العيش فيها، مستخدماً أسلوباً وثائقياً في مُقاربة أحوال الناس، وكيفية عيشهم في قلب صراع يوميّ مع المحتلّ. لكن "عطش"، لتوفيق أبو وائل، يبقى أحد أبرز وأهمّ الأفلام، شكلاً ومضموناً، المنصبّة في سرد حكاية فلسطينية في إسرائيل، إذ يعود المخرج الشاب إلى قريته أم الفحم (مقاطعة حيفا)، لرواية تفاصيل يومية من حياة عائلة. الجمالية البصرية تُغلّف معاينة درامية متماسكة في بنائها السرديّ، وتقنياتها المختلفة، كالتصوير والمونتاج وإدارة الممثلين إلخ.
من جهته، يصل هاني أبو أسعد بالفيلم الفلسطيني إلى أمكنة "محرّمة" إلى حدّ بعيد، خصوصاً في "الجنّة الآن" (أوّل فيلم فلسطيني يحصل على جائزة "غولدن غلوب"، التي تمنحها سنوياً، منذ العام 1944، "جمعية الصحافيين السينمائيين الأجانب في هوليوود"، في دورة العام 2005، في فئة أفضل فيلم أجنبي، ويتمّ ترشيحه لجائزة "أوسكار"، التي تمنحها سنوياً، منذ العام 1929، "أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية" في هوليوود أيضاً، في الفئة نفسها)، إذ يطرح فيه سؤال العمليات الاستشهادية ـ الانتحارية، من خلال شخصيتي شابين يلتزمان تنفيذ إحدى هذه العمليات، فيواجهان أشدّ أنواع الأسئلة المتعلّقة بالموت، والصراع مع الذات من أجل الحياة، ومعنى العيش في ظلّ موروث العمالة لإسرائيل، إلخ. العمالة هذه مطروحة أيضاً في "عمر" (2013، الجائزة الخاصّة بمسابقة "نظرة ما"، في الدورة الـ66 لمهرجان "كانّ"، والمرشّح لـ "أوسكار" أفضل فيلم أجنبي في دورة العام 2014)، من خلال قصّة 3 أصدقاء تُفرّقهم أحوال اليوميّ المنغمس إما في صراع مع إسرائيل، وإما في مواجهة انفعال يؤدّي بصاحبه إلى انتزاع حبيبة صديق له منه. قصّة حبّ موؤود، معطوفة على جهاد ضدّ محتل، ومهتمّة بسؤال العمالة. البناء الدرامي في الفيلمين مفتوحٌ على جمالية الصورة في مقاربة السيَر الحياتية لشخصيات غارقة في متاهات الألم والتمزّق والرغبة في الانعتاق من بؤس الشقاء اليوميّ، عبر الإيغال في البيئة المجتمعية الفلسطينية، وفي الصراع مع إسرائيل.
نماذج كهذه تُضيء شيئاً من أحوال سينما فلسطينية متجدّدة في مقارباتها الإنسانية وأسئلتها الأخلاقية والحياتية، من دون أن تُلغي نماذج أخرى تراوح بين جدّية فنية ـ تقنية في متابعة الهوامش الفلسطينية وتأريخ مضامينها المتفرّقة، وتبسيط شكليّ لنواة درامية مهمّة.
(كاتب لبناني)