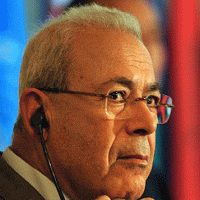11 نوفمبر 2024
سورية وحرب الإبادة الجماعية
دعوة لفك حصار مضايا وسط قصف الغوطة (8 يناير/2016/أ.ف.ب)
أعتقد أن السوريين والمنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة والعالم قد استنفدوا جميع جهودهم في إقناع بشار الأسد وحلفائه بحل يضمن عودة السلام والأمن إلى سورية النازفة، ولم ينجحوا، ولن ينجحوا أبداً في تغيير موقفهم، فقد صوّت مجلس الأمن على خمسة قرارات بخصوص المسألة السورية، كل واحد أكثر إلحاحاً من سابقه، وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أربعة بيانات رئاسية، وأيد تنحي الأسد في الجمعية العامة أكثر من 130 دولة، وأقرّت جميع الدول، بما فيها التي تدعم الأسد ونظامه، بمشروعية المطالب الشعبية في التغيير السياسي، وحق السوريين في تقرير مصيرهم، والانتقال نحو نظام جديد يضمن الحقوق المدنية والسياسية المتساوية للجميع. وأطلقت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والدول الكبرى أكثر من مبادرة وخطة سلام وورقة طريق للتوصل إلى حل. ولم نكف، نحن السوريين، عن الحماسة والتنافس لتشكيل الوفود المفاوضة، وعن التفنن في كتابة الوثائق والعهود الوطنية والرؤى المشتركة، وجهّزنا أنفسنا، كما تتجهز العروس ليوم عرسها، أكثر من مرة، لمفاوضات التسوية السياسية. وفي كل مرة، وجدنا أنفسنا أمام فراغ فاغر. وبعد أن نكون قد اختلفنا، وزاد انقسامنا حول من يمثل من، ومن يتمثل ولا يتمثل، وأين نتنازل، وأين نرفض التنازل، ومكانة العرب والأكراد والتركمان وغيرهم، ومن يمثل السنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والسلفيين والأقل سلفية، في وفودٍ لا تكاد تتشكل حتى تنحل، نصل إلى طريق مسدودة، ويخرج نقبنا، كما يقول المثل، على حجر.
فشل الحل السياسي والحسم العسكري
واليوم، بينما نحن نصرف الوقت في الرياض وغيرها على التحضير لمفاوضات لن تحصل، ونتنازع في ما بيننا على قيادتها أو رفضها، ونراكم ما نستحقه، ولا نستحقه، من الملامة والتأنيب والنقد من دول العالم وعواصمه ومن الشماتة، من خصومنا، تغرق بلادنا كل يوم أكثر في الدم، وتتسع دائرة الدمار، ويتضاعف عدد القتلى والجرحى والمحاصرين والمشردين واللاجئين، وتتكرس حدود الإمارات والدول "المفيدة" والأقل فائدة، وتزداد وتيرة التهجير المنظم للسكان، وتدمير مدنهم وقراهم، حتى لا يفكروا في العودة إلى بلادهم. ويزيد يأس السوريين بمستقبلهم وتختفي آمالهم بالخلاص.
وبعد أن خسرنا ربما مليوني ضحية بين قتيل وجريح ومعطوب ومفقود أو متوفى تحت التعذيب في معسكرات الموت والاعتقال، وخسرنا جيلاً كاملاً من الشباب والأطفال المعنفين والمعوقين والمحرومين من أي تأهيل، ونزح عن البلاد نصف سكانها، يكتشف العالم أن النظام الذي دمر حياتنا، ويهدّد بتدمير المنطقة بأكملها، ليس هو الطرف الأخطر المطلوب تبديله أو تغييره، وإنما ما تبقى من مقاتلي الثورة والجيش الحر، وأن على "المعتدلين" منا أن يتعاونوا، منذ الآن، مع هذا النظام، ويوجهوا حرابهم إلى جانبه إلى منظمات الإرهاب العالمية التي كان هو نفسه المساهم الرئيسي في إعادة إنتاجها، وتعزيز قوتها. بعد أن كنا نناشد العالم بالتضامن مع قضية شعبٍ يزج حرفياً في محرقةٍ، عقاباً له لمطالبته بحرياته وحقوقه، أصبحنا لا نعرف كيف نرد اتهامات العالم لنا برفض التضامن مع ضحايا الإرهاب في الدول الغربية الذي مسح موتهم في ساعات معدودة خمس سنوات كاملة من الموت والقتل والتعذيب والتجويع حتى الموت من تاريخنا.
منذ السنة الأولى للثورة، حصل الإجماع بين الدول المعنية على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون
سياسياً، وأن الحسم العسكري ممنوع لأي من الطرفين. وفي سياق الثورة والأحداث، لم يكن يعني ذلك سوى شيء واحد هو حرمان الثورة من تحقيق أي حسم، وإجبار قواها والمعارضة على التفاهم مع نظام الأسد، برئيسه أو من دونه، على انتقال سياسي متفق عليه. وهذا ما حصل بالفعل منذ نهاية عام 2012. لم يفشل الشعب، ولا قوى الثورة المنظمة، في القضاء على النظام، فقد كان ذلك في متناولهم، ولا يزال. لكن ما فشل هو الخطة الدولية التي فرضت على الشعب السوري، لأسباب متعددة، تختلط فيها المخاوف المبرّرة وغير المبرّرة، والأجندات الإقليمية والدولية، وانقسام المعارضة وغياب القيادة الوطنية الواحدة وضعفها. لكن نتيجة ذلك كله هو الوصول إلى طريق مسدود: ليس أمام السوريين اليوم أي أمل، لا في الحل السياسي، ولا في الحسم العسكري، وهم كالمدانين بالموت ينتظرون مصيرهم، غير قادرين على عمل شيء، تتحكم بهم مليشيات تحوّلت، خلال حرب وحشية لا ترحم، إلى عصاباتٍ أجنبيةٍ، تسعى إلى تحقيق أهدافها الخاصة كل على حدة، أكثر مما تمثل أي مشروع سياسي أو جيوسياسي.
ومثلما مات الحل السياسي، أغلق طريق الحسم العسكري بالتفاهم الدولي. وما تعيشه سورية اليوم، بعد استنفدت أهداف الحرب، وفشل محور النظام في كسر إرادة السوريين وإجبارهم على قبول خياراته، هو حرب إبادة جماعية، يسعى فيها النظام وحلفاؤه إلى تحطيم شعب وتشتيته، لوراثة أرضه وموقعه ومصالحه، تختلط فيها روح الثأر والانتقام، مع الأمل بتشريد ما أمكن من الشعب المقاوم وتدميره، واليأس من الانتصار، والخوف من المثول الحتمي أمام المحاكم المحلية أو الدولية، حساباً على المجازر والانتهاكات. وهي حرب إبادة مستمرة، بسبب مؤامرة الصمت الدولية من جهة، وإفلاس الأمم المتحدة وإصرار الولايات المتحدة الأميركية على رفض التورط مع موسكو أو إيران. ولن يفيد إغماض العينين عن هذه الحقيقة إلا في تأجيل التفكير في الحل، وفي انتظار ذلك فقدان مزيد من المواقع، واستنزاف مزيد من القوى والمعنويات. أما الوعود التي تعطى للسوريين، من خلال التحضير لجنيف3 فليس لها من هدف سوى ترويض المعارضة لقبول تجرّع كأس السم، عندما تحين الساعة.
المفاوضات المستحيلة
لن تكون هناك مفاوضات مثمرة أولاً، لأن الأمم المتحدة التي نراهن عليها في ترتيب أوراق المفاوضات، ورعاية عملية التوصل إلى سلام، لم تعد منظمة فاعلةً، وأثبتت في السنوات الخمس الماضية أنها علبة بريد لا استقلال لها عن نزاعات الأطراف ومواقفها، خصوصاً تلك الأطراف الحائزة على حق النقض في مجلس الأمن، ولا قدرة لها على اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقة الجميع، وأن المشكلة هي، بالضبط، أن هذه الموافقة مستحيلة اليوم، لعدة أسباب، أهمها تباين الأجندات الإقليمية والدولي، إن لم نقل تناقضها.
ولن تكون هناك مفاوضات جدية ثانياً، لأن النظام السوري، وحلفاءه الرئيسيين في طهران
وموسكو، لا يفكرون لحظة واحدة في الانتقال نحو نظام جديد، أو حتى في تعديل ذي مغزى للنظام. ما يريدونه هو بالعكس تماماً، تثبيت النظام وتعزيز أركانه الأمنية والعسكرية والمخابراتية، وإقصاء أكبر عدد من السوريين وتهجيرهم، لتخفيف الضغط عن النظام. ولا تخفي موسكو رفضها المبدئي لفكرة وصول الأكثرية المسلمة إلى مراكز القرار والسلطة السياسية. أما رجال النظام وقادته فهم يعرفون أن حجم الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها لن يمكن تمريرها إلى الأبد. بينما تعتبر طهران أنها تخوض حرباً مصيرية على نظامها ووجودها، جمهورية إسلامية تشكل سورية مسرحها الرئيسي تماماً، كما يشكل الاستحواذ عليها غاية استراتيجية وجائزة مستحقة، في حين يعتقد الروس أن تثبيت أقدامهم في سورية أصبح، اليوم، مصدر المصادقة على دورهم العالمي، وقوة نفوذهم الإقليمي. ما يحصل لسورية وشعبها وسكانها وتاريخها ومستقبلها لا يهم أي واحد من هؤلاء، ولا يدخل لديهم في أي اعتبار، لا أخلاقي ولا سياسي ولا اقتصادي. ما تقوم به الأمم المتحدة في سورية هو رش بعض السكر على الجرح الغائر والنازف، من دون أي إيمان منها، هي نفسها، بالعمل وبالوعود التي تقطعها على نفسها، ويقطعها ممثلوها على أنفسهم، أو أي شعورحقيقي بالمسؤولية تجاه الضحايا والكوارث الانسانية. في سورية بشكل خاص، لم تستطيع الأمم المتحدة حتى الالتزام بتطبيق القرارات الإنسانية، ولا تزال عاجزة عن تقديم شيء آخر غير الشكاوى والتنديدات، لوضع حد لمحنة حصار التجويع والتركيع الذي أصبح إحدى خطط النظام السوري الرئيسية لمعاقبة السوريين، وفرض الاستسلام عليهم، وفصل المقاتلين عن حاضنتهم الشعبية.
ولن تكون هناك مفاوضات جدية ثالثاً، لأن الدول الغربية التي راهنت عليها المعارضات الديمقراطية الدولية، وليس السورية فقط، والتي لم يكن هناك بديل عنها، ليست مستعدة للقبول بأي مخاطر، مهما كانت ضئيلة في مواجهة روسيا وإيران. بل إنها تنحو، اليوم، أكثر فأكثر إلى المراهنة على تعاونهما من أجل احتواء حركات التطرف والإرهاب التي نشأت على هامش الثورة السورية، وتسعى إلى خنقها. وهي، إذ تردد، من دون كلل ولا ملل، أنه لا يوجد هناك سوى الحل السياسي للأزمة السورية تخفي وراء كلماتها الآلية اعتقادها العميق بأنه لا يوجد حل، وليس هناك أي أرضية مشتركة ممكنة لتسوية المصالح الإقليمية والدولية، في إطار انهيار التوازنات الإقليمية الشرق أوسطية والطفرات العميقة التي تطرأ على العلاقات الدولية.
ما جعل بعض الآمال تنتعش، في الأشهر الأخيرة، باحتمال التوصل إلى حل أمران. يتعلق الأول بتطور الإرهاب وتطاير بعض شرارات الإرهاب الذي يضرب بالسوريين في كل شبر من الأرض السورية، ما وراء المعارضة والموالاة، ووصوله إلى أوروبا. لكن أيضاً احتمال انتقاله بسرعة، في مستقبل ليس بعيداً، إلى بعض الجمهوريات الإسلامية التابعة للاتحاد الروسي، أو المحيطة به. الأمر الثاني تفاقم أزمة اللاجئين، وهجرتهم الجماعية نحو بلدان القارة الأوروبية، وما أثارته هذه الأزمة من مخاطر على الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل هذه البلدان، ورد فعل جماعات عنصرية على تنامي حجم السكان من أصول عربية أو إسلامية.
لكن، من الواضح أن أوروبا المتضررة الرئيسية من أزمة اللاجئين ليست قوة فاعلة، حتى تستطيع أن تضغط من أجل التوصل إلى حل، وتدفع الدول الكبرى إلى تغيير أجندتها. أما بالنسبة لروسيا، فهي ترى، بالعكس، أن محاصرة الإرهاب في سورية، وشن الحرب ضده هناك، هو الطريق الوحيدة للوقاية من انتشاره، وأن أفضل وسيلة لذلك تثبيت أقدامها في سورية، وبسط سيطرتها عليها، حيث توجد اليوم حاضنة المنظمات الإرهابية، واستخدام النظام السوري نفسه والمليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية أداة من أدوات حربها على الإرهاب. والترجمة المنظورة لذلك هي إعادة تأهيل النظام القائم وتدعيمه، تحت غطاء الحرب على الإرهاب، لا البحث عن حل سياسي يوقفها. فروسيا ليست معنية بوقف الحرب من دون القضاء على المقاتلين بكل أشكالهم، وهذا ما يجعلها حليفةً جدية لطهران ونظام الأسد معاً وشريكة لهما في تمديد أجل الحرب، حتى لو لم تتبن أجندتيهما.
وما يعزز من هذا الاحتمال تفجر النزاع الروسي التركي، بعد إسقاط الطائرة الروسية في سياق سعي موسكو إلى إخراج تركيا من المنافسة، وانفجار الأزمة السعودية الإيرانية. وكلاهما جاء في الوقت المناسب، لكي يقضي على آخر احتمالات انطلاق المفاوضات السياسية حول سورية، بل على أي أمل في حصول مثل هذه المفاوضات، حتى في صورتها الشكلية الفاقعة، كما حصل من قبل في مؤتمر جنيف 2.
قلب الطاولة على موسكو وطهران
يمكن تلخيص ما يعدنا به المجتمع الدولي في ورقة فيينا في شقين: الأول إنساني، يتعلق
برعاية أزمة اللاجئين والجائعين بشكل أو آخر. والثاني سياسي، يتخذ شكل الاستقالة أكثر منه شكل المواجهة، ويقوم على دفع الأمم المتحدة، الممثلة بمبعوثها ستيفان دي ميستورا، إلى رعاية مباحثات رسمية وغير رسمية، للتخفيف من وتيرة العنف. وجميع الدول تنطلق من فرضية مشتركة، هي أن سورية أصبحت، اليوم، فريسة سائبة، لا صاحب لها، ومن دون شعب واحد أو قيادة، تتنازعها القوى الإقليمية وغير الإقليمية. وبمقدار ما أصبحت متنفساً لجميع التناقضات في المصالح والتصورات والخطط المستقبلية، تتحول أكثر فأكثر إلى بركان لا قبل لأحد في السيطرة عليه، ولا حل سوى تركه ينفث حممه، حتى يبرد من تلقاء نفسه. وجميع العروض المقترحة والمتداولة في الأوساط الدبلوماسية الغربية والشرقية الآن هي العمل على إنجاح مفاوضاتٍ حول هدن محلية وجزئية، على شاكلة ما حصل في الزبداني والفوعة والوعر. وهو ما أثبتت مجاعات مضايا والمعضمية وغيرها فشله.
هذا يعني أن سورية انتهت، وأن النزاع فيها سوف يستمر، حتى تظهر نتائجه على الأرض، وتتبلور القوى والخرائط الجديدة. وفي انتظار ذلك، سوف يميل المجتمع الدولي إلى قصر تدخله بالفعل على محاربة المنظمات الإرهابية، بسبب مخاطر عملها عليه، ويترك للدول والقوى الإقليمية المعنية حسم الأمور في سورية. وعلى المستوى السوري، هذا يعني أن النظام الذي يتمتع بدعم قوي من طهران وحزب الله وروسيا سوف يستمر في حرب الإبادة، وتفريغ سورية من سكانها، وإعادة هيكلتها على حجم قواه، ومصالحه ومصالح حلفائه، بكل الوسائل: القتل والحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء والموت تحت التعذيب والتدمير المنظم. والعمل، في موازاة ذلك، على عزل القوى المقاتلة، معتدلةً ومتطرفة من دون تمييز، وتشتيتها ودفعها عن طريق القصف وقطع الموارد وطرق الإمداد والتواصل إلى إخلاء مواقعها وحصرها في مناطق محدودة، قبل تعريضها لمحرقة نهائية كاملة.
لن تنجح هذه الخطة في تحقيق أهدافها بالتأكيد. لكن، في المقابل من المستبعد أن تؤدي الاستراتيجية الدفاعية التي تبنتها منذ سنوات عن مناطق محرّرة أو شبه محرّرة، معظمها محاصر من جهة، والاستمرار في الانقسام والتشتت وغياب قيادة موحدة وتنظيم مركزي للقوى المقاتلة، وخطة وطنية واضحة من جهة ثانية، والاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي بالذخيرة والسلاح، حتى لو كان من حلفاء لهم مصالح في زوال النظام، من جهة ثالثة، إلى أي حسم قريب، ينقذ ما تبقى من حياة السوريين.
في المقابل، تستطيع المعارضة أن تقلب الطاولة على قوات المحور الروسي الإيراني بسهولة، إذا ما حاولت الاستفادة من نقاط ضعفه الرئيسية، وهي استعجاله التوصل إلى حسم، وهذا ما يفسر التصعيد الوحشي المتزايد، وتحويل حرب الاستنزاف التي تتعرض لها منذ سنتين إلى حرب استنزاف له، مستفيدةً من إعادة تجميع قواها وتنظيمها وإعادة نشرها بطريقة حرب العصابات الطويلة. وهذا ما سوف يزيد من قدرتها على المقاومة والاستمرار، ويقلل من حجم اعتمادها على الخارج، ويعزّز هامش مبادرتها الخاصة واستقلالها، واستعادة ثقة الجمهور السوري بها.
لكن، حتى تنجح المعارضة في مثل هذه الخطة، ينبغي أولاً أن تتقدم الفكرة والأجندة الوطنيتان على كل الأفكار والأجندات الخاصة التي تتمسك بها الفصائل، حتى تلك التابعة لما نسميه الجيش السوري الحر، والتي ترتبط كل واحدة منها بشخص قائد، أو بمجموعة قيادية، وربما بدولة مموّلة، أو بطرف خارجي داعم. وينبغي ثانياً أن يتغلب الهدف الوطني الشامل على منطق إمارات الحرب، ويتحول جميع قادة الفصائل إلى مشاريع رجال دولة، يفكّرون بمصير سورية كاملة، وبمصير السوريين، على اختلاف انتماءاتهم واعتقاداتهم، وليس بمصير جماعاتهم المقاتلة، أو مناطقهم أو مذاهبهم وطوائفهم، فبناء أجندة وطنية تعكس مصالح السوريين الوطنية، والعمل على توحيد فكر الفصائل وتعبئتها حول مشروع وطني واحد وملهم، يجمع السوريين بوصفهم شعباً، وينهي حالة الحرب، ويفكك إماراتها، وفي مقدمتها دولة إمارات الحرب التي ليس لها علاقة لا بمفهوم الدولة، ولا بمنطقها وقانونها. هذا هو الثمن، أو الطريق الوحيد لحسم الحرب، ولا طريق غيره.
فشل الحل السياسي والحسم العسكري
واليوم، بينما نحن نصرف الوقت في الرياض وغيرها على التحضير لمفاوضات لن تحصل، ونتنازع في ما بيننا على قيادتها أو رفضها، ونراكم ما نستحقه، ولا نستحقه، من الملامة والتأنيب والنقد من دول العالم وعواصمه ومن الشماتة، من خصومنا، تغرق بلادنا كل يوم أكثر في الدم، وتتسع دائرة الدمار، ويتضاعف عدد القتلى والجرحى والمحاصرين والمشردين واللاجئين، وتتكرس حدود الإمارات والدول "المفيدة" والأقل فائدة، وتزداد وتيرة التهجير المنظم للسكان، وتدمير مدنهم وقراهم، حتى لا يفكروا في العودة إلى بلادهم. ويزيد يأس السوريين بمستقبلهم وتختفي آمالهم بالخلاص.
وبعد أن خسرنا ربما مليوني ضحية بين قتيل وجريح ومعطوب ومفقود أو متوفى تحت التعذيب في معسكرات الموت والاعتقال، وخسرنا جيلاً كاملاً من الشباب والأطفال المعنفين والمعوقين والمحرومين من أي تأهيل، ونزح عن البلاد نصف سكانها، يكتشف العالم أن النظام الذي دمر حياتنا، ويهدّد بتدمير المنطقة بأكملها، ليس هو الطرف الأخطر المطلوب تبديله أو تغييره، وإنما ما تبقى من مقاتلي الثورة والجيش الحر، وأن على "المعتدلين" منا أن يتعاونوا، منذ الآن، مع هذا النظام، ويوجهوا حرابهم إلى جانبه إلى منظمات الإرهاب العالمية التي كان هو نفسه المساهم الرئيسي في إعادة إنتاجها، وتعزيز قوتها. بعد أن كنا نناشد العالم بالتضامن مع قضية شعبٍ يزج حرفياً في محرقةٍ، عقاباً له لمطالبته بحرياته وحقوقه، أصبحنا لا نعرف كيف نرد اتهامات العالم لنا برفض التضامن مع ضحايا الإرهاب في الدول الغربية الذي مسح موتهم في ساعات معدودة خمس سنوات كاملة من الموت والقتل والتعذيب والتجويع حتى الموت من تاريخنا.
منذ السنة الأولى للثورة، حصل الإجماع بين الدول المعنية على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون
ومثلما مات الحل السياسي، أغلق طريق الحسم العسكري بالتفاهم الدولي. وما تعيشه سورية اليوم، بعد استنفدت أهداف الحرب، وفشل محور النظام في كسر إرادة السوريين وإجبارهم على قبول خياراته، هو حرب إبادة جماعية، يسعى فيها النظام وحلفاؤه إلى تحطيم شعب وتشتيته، لوراثة أرضه وموقعه ومصالحه، تختلط فيها روح الثأر والانتقام، مع الأمل بتشريد ما أمكن من الشعب المقاوم وتدميره، واليأس من الانتصار، والخوف من المثول الحتمي أمام المحاكم المحلية أو الدولية، حساباً على المجازر والانتهاكات. وهي حرب إبادة مستمرة، بسبب مؤامرة الصمت الدولية من جهة، وإفلاس الأمم المتحدة وإصرار الولايات المتحدة الأميركية على رفض التورط مع موسكو أو إيران. ولن يفيد إغماض العينين عن هذه الحقيقة إلا في تأجيل التفكير في الحل، وفي انتظار ذلك فقدان مزيد من المواقع، واستنزاف مزيد من القوى والمعنويات. أما الوعود التي تعطى للسوريين، من خلال التحضير لجنيف3 فليس لها من هدف سوى ترويض المعارضة لقبول تجرّع كأس السم، عندما تحين الساعة.
المفاوضات المستحيلة
لن تكون هناك مفاوضات مثمرة أولاً، لأن الأمم المتحدة التي نراهن عليها في ترتيب أوراق المفاوضات، ورعاية عملية التوصل إلى سلام، لم تعد منظمة فاعلةً، وأثبتت في السنوات الخمس الماضية أنها علبة بريد لا استقلال لها عن نزاعات الأطراف ومواقفها، خصوصاً تلك الأطراف الحائزة على حق النقض في مجلس الأمن، ولا قدرة لها على اتخاذ أي قرار لا يحظى بموافقة الجميع، وأن المشكلة هي، بالضبط، أن هذه الموافقة مستحيلة اليوم، لعدة أسباب، أهمها تباين الأجندات الإقليمية والدولي، إن لم نقل تناقضها.
ولن تكون هناك مفاوضات جدية ثانياً، لأن النظام السوري، وحلفاءه الرئيسيين في طهران
ولن تكون هناك مفاوضات جدية ثالثاً، لأن الدول الغربية التي راهنت عليها المعارضات الديمقراطية الدولية، وليس السورية فقط، والتي لم يكن هناك بديل عنها، ليست مستعدة للقبول بأي مخاطر، مهما كانت ضئيلة في مواجهة روسيا وإيران. بل إنها تنحو، اليوم، أكثر فأكثر إلى المراهنة على تعاونهما من أجل احتواء حركات التطرف والإرهاب التي نشأت على هامش الثورة السورية، وتسعى إلى خنقها. وهي، إذ تردد، من دون كلل ولا ملل، أنه لا يوجد هناك سوى الحل السياسي للأزمة السورية تخفي وراء كلماتها الآلية اعتقادها العميق بأنه لا يوجد حل، وليس هناك أي أرضية مشتركة ممكنة لتسوية المصالح الإقليمية والدولية، في إطار انهيار التوازنات الإقليمية الشرق أوسطية والطفرات العميقة التي تطرأ على العلاقات الدولية.
ما جعل بعض الآمال تنتعش، في الأشهر الأخيرة، باحتمال التوصل إلى حل أمران. يتعلق الأول بتطور الإرهاب وتطاير بعض شرارات الإرهاب الذي يضرب بالسوريين في كل شبر من الأرض السورية، ما وراء المعارضة والموالاة، ووصوله إلى أوروبا. لكن أيضاً احتمال انتقاله بسرعة، في مستقبل ليس بعيداً، إلى بعض الجمهوريات الإسلامية التابعة للاتحاد الروسي، أو المحيطة به. الأمر الثاني تفاقم أزمة اللاجئين، وهجرتهم الجماعية نحو بلدان القارة الأوروبية، وما أثارته هذه الأزمة من مخاطر على الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل هذه البلدان، ورد فعل جماعات عنصرية على تنامي حجم السكان من أصول عربية أو إسلامية.
لكن، من الواضح أن أوروبا المتضررة الرئيسية من أزمة اللاجئين ليست قوة فاعلة، حتى تستطيع أن تضغط من أجل التوصل إلى حل، وتدفع الدول الكبرى إلى تغيير أجندتها. أما بالنسبة لروسيا، فهي ترى، بالعكس، أن محاصرة الإرهاب في سورية، وشن الحرب ضده هناك، هو الطريق الوحيدة للوقاية من انتشاره، وأن أفضل وسيلة لذلك تثبيت أقدامها في سورية، وبسط سيطرتها عليها، حيث توجد اليوم حاضنة المنظمات الإرهابية، واستخدام النظام السوري نفسه والمليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية أداة من أدوات حربها على الإرهاب. والترجمة المنظورة لذلك هي إعادة تأهيل النظام القائم وتدعيمه، تحت غطاء الحرب على الإرهاب، لا البحث عن حل سياسي يوقفها. فروسيا ليست معنية بوقف الحرب من دون القضاء على المقاتلين بكل أشكالهم، وهذا ما يجعلها حليفةً جدية لطهران ونظام الأسد معاً وشريكة لهما في تمديد أجل الحرب، حتى لو لم تتبن أجندتيهما.
وما يعزز من هذا الاحتمال تفجر النزاع الروسي التركي، بعد إسقاط الطائرة الروسية في سياق سعي موسكو إلى إخراج تركيا من المنافسة، وانفجار الأزمة السعودية الإيرانية. وكلاهما جاء في الوقت المناسب، لكي يقضي على آخر احتمالات انطلاق المفاوضات السياسية حول سورية، بل على أي أمل في حصول مثل هذه المفاوضات، حتى في صورتها الشكلية الفاقعة، كما حصل من قبل في مؤتمر جنيف 2.
قلب الطاولة على موسكو وطهران
يمكن تلخيص ما يعدنا به المجتمع الدولي في ورقة فيينا في شقين: الأول إنساني، يتعلق
هذا يعني أن سورية انتهت، وأن النزاع فيها سوف يستمر، حتى تظهر نتائجه على الأرض، وتتبلور القوى والخرائط الجديدة. وفي انتظار ذلك، سوف يميل المجتمع الدولي إلى قصر تدخله بالفعل على محاربة المنظمات الإرهابية، بسبب مخاطر عملها عليه، ويترك للدول والقوى الإقليمية المعنية حسم الأمور في سورية. وعلى المستوى السوري، هذا يعني أن النظام الذي يتمتع بدعم قوي من طهران وحزب الله وروسيا سوف يستمر في حرب الإبادة، وتفريغ سورية من سكانها، وإعادة هيكلتها على حجم قواه، ومصالحه ومصالح حلفائه، بكل الوسائل: القتل والحصار والتجويع والحرمان من الغذاء والماء والدواء والموت تحت التعذيب والتدمير المنظم. والعمل، في موازاة ذلك، على عزل القوى المقاتلة، معتدلةً ومتطرفة من دون تمييز، وتشتيتها ودفعها عن طريق القصف وقطع الموارد وطرق الإمداد والتواصل إلى إخلاء مواقعها وحصرها في مناطق محدودة، قبل تعريضها لمحرقة نهائية كاملة.
لن تنجح هذه الخطة في تحقيق أهدافها بالتأكيد. لكن، في المقابل من المستبعد أن تؤدي الاستراتيجية الدفاعية التي تبنتها منذ سنوات عن مناطق محرّرة أو شبه محرّرة، معظمها محاصر من جهة، والاستمرار في الانقسام والتشتت وغياب قيادة موحدة وتنظيم مركزي للقوى المقاتلة، وخطة وطنية واضحة من جهة ثانية، والاعتماد المتزايد على الدعم الخارجي بالذخيرة والسلاح، حتى لو كان من حلفاء لهم مصالح في زوال النظام، من جهة ثالثة، إلى أي حسم قريب، ينقذ ما تبقى من حياة السوريين.
في المقابل، تستطيع المعارضة أن تقلب الطاولة على قوات المحور الروسي الإيراني بسهولة، إذا ما حاولت الاستفادة من نقاط ضعفه الرئيسية، وهي استعجاله التوصل إلى حسم، وهذا ما يفسر التصعيد الوحشي المتزايد، وتحويل حرب الاستنزاف التي تتعرض لها منذ سنتين إلى حرب استنزاف له، مستفيدةً من إعادة تجميع قواها وتنظيمها وإعادة نشرها بطريقة حرب العصابات الطويلة. وهذا ما سوف يزيد من قدرتها على المقاومة والاستمرار، ويقلل من حجم اعتمادها على الخارج، ويعزّز هامش مبادرتها الخاصة واستقلالها، واستعادة ثقة الجمهور السوري بها.
لكن، حتى تنجح المعارضة في مثل هذه الخطة، ينبغي أولاً أن تتقدم الفكرة والأجندة الوطنيتان على كل الأفكار والأجندات الخاصة التي تتمسك بها الفصائل، حتى تلك التابعة لما نسميه الجيش السوري الحر، والتي ترتبط كل واحدة منها بشخص قائد، أو بمجموعة قيادية، وربما بدولة مموّلة، أو بطرف خارجي داعم. وينبغي ثانياً أن يتغلب الهدف الوطني الشامل على منطق إمارات الحرب، ويتحول جميع قادة الفصائل إلى مشاريع رجال دولة، يفكّرون بمصير سورية كاملة، وبمصير السوريين، على اختلاف انتماءاتهم واعتقاداتهم، وليس بمصير جماعاتهم المقاتلة، أو مناطقهم أو مذاهبهم وطوائفهم، فبناء أجندة وطنية تعكس مصالح السوريين الوطنية، والعمل على توحيد فكر الفصائل وتعبئتها حول مشروع وطني واحد وملهم، يجمع السوريين بوصفهم شعباً، وينهي حالة الحرب، ويفكك إماراتها، وفي مقدمتها دولة إمارات الحرب التي ليس لها علاقة لا بمفهوم الدولة، ولا بمنطقها وقانونها. هذا هو الثمن، أو الطريق الوحيد لحسم الحرب، ولا طريق غيره.