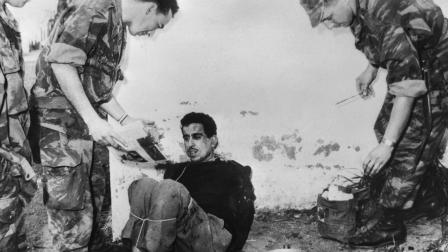تستعيد هذه الزاوية شخصية ثقافية عربية أو عالمية بمناسبة ذكرى ميلادها في محاولة لإضاءة جوانب من شخصيتها أو من عوالمها الإبداعية. يصادف اليوم، الرابع والعشرون من حزيران/ يونيو، ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانة سلوى روضة شقير (1916 – 2017).
في عام 1951، نشرت سلوى روضة شقير مقالاً بعنوان "كيف أفهم فن التصوير" في مجلة "الأبحاث" البيروتية، تدافع فيه عن التراث الفني العربي الذي رأت أنه "لم يكترث بالواقع المحسوس المنظور أو الحقيقة كما يراها الإنسان، بل ذهب في بحثه عن الجمال إلى جوهر الموضوع، مجرّداً إياه من كلّ الشوائب التي رافقت زمن الإغريق حتى القرن التاسع عشر".
واجهت الفنانة اللبنانية (1916 – 2017) التي تحلّ اليوم ذكرى ميلادها، تساؤلات حول الفن الغربي وتحديداً حول مبدأ المحاكاة والمنظور، بالتزامن مع تساؤلات ملحّة أخرى حول خصائص الفن الإسلامي ضمن التفكير في مسارات تآلفهما وتنافرهما التي ظلّت المساحة الأساسية المولّدة لتجربتها على مدار ثمانين عاماً.
 شقير التي تعلّمت في محترفَي عمر الأنسي ومصطفى فروخ، وهما من روّاد الفن الواقعي في لبنان، نزعت أعمالها نحو التجريد باكراً، عبر اطلاعها المعمق على التراث واستيعابها في الوقت نفسه للحداثة الغربية، التي تعرّفت عليها أكثر بعد دراسة الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت، وانتقالها إلى باريس حيث التحقت بـ "المدرسة الوطنية للفنون الجميلة"، ثم تابعت دراستها في أكاديمية "دو لاغراند شومير".
شقير التي تعلّمت في محترفَي عمر الأنسي ومصطفى فروخ، وهما من روّاد الفن الواقعي في لبنان، نزعت أعمالها نحو التجريد باكراً، عبر اطلاعها المعمق على التراث واستيعابها في الوقت نفسه للحداثة الغربية، التي تعرّفت عليها أكثر بعد دراسة الفلسفة في الجامعة الأميركية في بيروت، وانتقالها إلى باريس حيث التحقت بـ "المدرسة الوطنية للفنون الجميلة"، ثم تابعت دراستها في أكاديمية "دو لاغراند شومير".
في تلك المرحلة، ستتأثر بتجربة الفنان الهولندي بيت موندريان بمفهومه العام للعمل الفني، لكنها ستواصل بحثها النظري والبصري لتبلوّر رؤيتها الخاصة، لتصل إلى ما كانت تطلق عليه "القوافي البصرية" وهي الثيمة الأساسية التي تحكم معظم أعمالها، وتتجلّى في اكتشاف الواحد في المتعدّد.
شاركت شقير في معرض "الحقائق الجديدة" الذي أقامته "جماعة التجريديين" في باريس سنة 1951، وانتظمت مشاركتها منذ ذلك التاريخ في العديد من المعارض والتظاهرات الفرنسية حتى رحيلها، إلا أنها عادت في صيف العام نفسه إلى بيروت حالمة بتأسيس معهد للفن الحديث في مدينتها، بحسب ما صرحت به في مقابلة أُجريت معها حينذاك.
ضمن تحويلها لمبادئ رياضية وهندسية إلى تعبيرات فنية، قدّمت في الستينيات والسبعينيات مجموعتها الشهيرة "القصائد"، وهي منحوتات متشابكة تتألف من مكونات متفاوتة العدد، مصنوعة من الخشب والألمنيوم والنحاس والطين والألياف الزجاجية، في محاكاة بصرية للبنية المركّبة للشعر الصوفي، بحيث يكون المقطع الشعري قائماً بذاته، لكن يندمج أيضاً مع القصيدة كلها.
كما قدّمت بعد ذلك سلسلة "ثنائيات" التي تتألف من أزواج من المنحوتات الصغيرة على النحاس والألمينيوم والزجاج، والطين المشوي والخشب، وتتعانق وتلتف متشابكة مع ببعضها، رغم أنها أقل تعقيداً إلى حد كبير، واستفادت في عملها من فيزياء الكم وعلم الأحياء الجزيئي، لمعالجة العلاقة بين الجمود والجوهر، والثبات والانسياب، والتوليد والتحريف، واللانهاية واللحظة.
أثناء الحرب الأهلية في لبنان حيث غابت عن المشهد تقريباً، نفّذت العديد من القطع الثنائية، تبدو كما لو كانت شيئاً واحداً لكن أمراً طرأ ومزقه إلى نصفين، هذه القطع تظهر في حالة توق إلى الاندماج من جديد والتلاحم في بنية واحدة لكن شيئاً ما يحول دون ذلك.
تنطلق شقير عادة في منحوتها برسم خطوط دقيقة تتحول إلى معالم لمجسّمات من الفخار قد تفضي إلى أعمال مختلفة المواد، مستخدمة الخشب والبرونز والبولي يوريثين، قدّمتها ضمن أربعة فضاءات رئيسة، هي: مسار الخط والقصائد ومسار القوس والمثنيات أو الثنائيات.