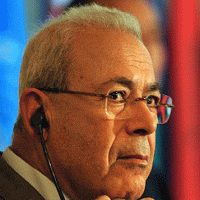11 نوفمبر 2024
روسيا أمام امتحان الهدنة وتحدّي السلام
صورة وزعتها وكالة تاس لقصف سوخوي مواقع سورية (15اكتوبر/2015/Getty)
على الرغم من كل ما يقال في الأوساط الدبلوماسية التي كانت تصطف في لحظة ذعرٍ سابقة وراء أطروحة الحفاظ على الأسد كأفضل الشرّين مقابل داعش، ليس هناك أحد، بما في ذلك طهران، المدافع الأول عن نظام دمشق، يعتقد بالفعل أن من الممكن وقف الحرب السورية مع الإبقاء على الأسد. المشكلة كانت، ولا تزال، كيف يمكن إزاحته، قبل التفاهم بين أصحاب المصالح الرئيسية والدول الفاعلة على مرحلة ما بعد الأسد.
بمعنى آخر، قبلت جميع الأطراف الدولية والإقليمية أن يستمر نزيف الدم السوري، وأن يضحّى بالسوريين، بانتظار أن تضمن كل الأطراف مصالحها في سورية المستقبل. ولأن هذه المصالح متناقضة ومتنافية، استمر القتال، مع ترديد جميع الأطراف، في وجه خصومها، شعاراً واحداً تبرّر به حربها وتدعو الآخرين إلى التراجع: ليس هناك حسم عسكري، ولا مخرج، إلا بالحل السياسي. لكن، في الواقع، جميع الأطراف تسعى إلى تغيير ميزان القوى، قبل أن تقبل بالدخول في أي مفاوضات جدية. أما الأسد فكان، ولا يزال وسيبقى، لا يفكر بشيء آخر سوى سحق أعدائه واستعادة مملكته الوراثية، معتقداً، عن حق، أنه مهما كان الحل السياسي القادم فسوف يكون لا محالة على حسابه، ولن يكون حل من دون خروجه حياً أو ميتاً من المسرح.
بيان فيينا ثم إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254 بتوافق جميع الأطراف، أظهر كما لو أن شرخاً ما حصل في هذه الحلقة المفرغة، أوحى للجميع بأن دورة جديدة من مفاوضات الحل السياسي يمكن أن تبدأ، أو أن الشروط لإطلاقها أصبحت جاهزة. منذ التدخل العسكري الروسي الواسع والمباشر في الحرب. وهذا ما بعث بعض التفاؤل في أوساط الرأي العام، ويمكن أن يخلق زخماً ما لو ثبتت الهدنة التي أعلنت في 27 من فبراير/ شباط 2016، ويكمن وراء هذا التغيير التفاهم الأميركي الروسي الذي يضمر وجود إرادة مشتركة لوضع حدٍّ للحرب الداخلية السورية، أو على الأقل، لتغيير قواعد اللعبة الحربية المستمرة منذ خمس سنوات، يقود إلى تخفيف حدة العنف، وتقليص النتائج المدمرة لاستمرارها على البيئة الإقليمية والدولية.
في هذا المستوى من التحليل، هناك من دون شك فرصة للتقدم نحو عمليةٍ سياسيةٍ جديدةٍ أكثر حظا من سابقاتها جنيف 1 و2، لأن جميع الأطراف المعنية المحلية والإقليمية مضطرة للمشاركة فيها، حتى لو أنها ليست مقتنعة بها، ولأن روسيا التي عرقلت العملية السياسية في السابق هي اليوم العراب الرئيسي لجنيف 3، بمشاركة واشنطن ومباركتها.
وهناك، من دون شك أيضاً، مصلحة كبيرة لروسيا في إنجاح المهمة التي أوكلت لها، والدفع
بعمليةٍ قد تفضي إلى الخروج تدريجياً من الحرب. فليس من مصلحتها الغرق في مستنقع حرب عصاباتٍ لا تنتهي، على الطريقة الأفغانية، كما أن موسكو تدرك أن هذه فرصتها الكبيرة لتبسط نفوذها في المشرق الذي كانت على وشك أن تطرد منه، وأن تتحول من قوةٍ خارجيةٍ مهمشةٍ إلى القوة الإقليمية المهيمنة التي تملك بين يديها مفتاح إعادة تنظيم العلاقات بين دول المنطقة وترتيب أوضاعها، بمقدار ما أصبحت الدولة الوحيدة التي تملك علاقاتٍ قويةً مع جميع الأطراف المتنازعة والمتنافسة العربية والإيرانية. وإذا نجحت في تجميد النزاع الإقليمي وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار في منطقةٍ ملتهبة، ستتحول إلى مركز استقطاب، وتقطف ثمار تقرب جميع الدول في الإقليم منها والمراهنة عليها والاعتراف بها دولة عظمى مشاركة في صنع أجندة السياسة الدولية، بعد أن كانت مهمشة تماماً. يُضاف إلى ذلك أن الروس الذين أنقذوا المشروع الإيراني من الفشل ونظام الأسد من الانهيار يملكون وحدهم وسائل الضغط الكافية، إذا أرادوا، لإجبار الطرفين على التأقلم مع المطلب الدولي في تحقيق الهدنة، ثم الانتقال إلى عملية سياسية. لا يشذ عن ذلك إلا تركيا التي ستبدو الخاسرة الرئيسية في هذه التسوية الروسية الموعودة.
المشكلة الأولى في هذا التغيير الحاصل من حول القضية السورية هو أن باعثه ليس تحقيق تطلعات الشعب السوري التي تدخلت جيوش وقوى إقليمية ودولية عديدة لقطع الطريق عليه، ولا حتى السعي إلى تخفيف معاناة السوريين، بالرغم من احتمال أن يكون ذلك من آثارها. الحافز الحقيقي لذلك هو خوف الغربيين والروس معا من مضاعفات استمرار الحرب على مصالحهم الاستراتيجية، سواء ما تعلق منها بتجذر الإرهاب وانتشاره وتمدده في اتجاهها، وقد عانى بعضها منذ الآن من التفجيرات الإرهابية، أو بتفاقم أزمة اللجوء التي تهدد بتقويض التفاهم الهش أصلا داخل الاتحاد الأوروبي وبدرجة ثالثة الضغط المتزايد لدول الخليج العربي التي تشعر بالتهديد المباشر على أمنها الوطني والإقليمي. وهذا يعني أن المقاربة الدولية للحل سوف تكون مرتبطةً بشكل أكبر بتحقيق هذه الرهانات الإقليمية والدولية الجيوسياسية، بصرف النظر عن مصالح السوريين ومستقبل سورية نفسها، أو ربط هذه المصالح الأخيرة بأجندة الحل الدولية. بل من الأغلب أن تتم على حساب سورية والسوريين سواء بالذهاب نحو نوع من التقسيم السياسي الذي يشرعن تقاسم مناطق النفوذ بين الدول، أو التقسيم الطائفي الذي يضمن للجميع التدخل للتحكم بمستقبل البلاد ومصيرها.
المشكلة الثانية أن روسيا التي أوكل إليها دور رعاية الحل السياسي لا تملك أي رصيد إيجابي في مسألة الاستجابة لتطلعات الشعوب، بل ربما كانت من أكثر الدول عداءً لها، وأن معالجتها هذا النوع من الثورات، أو التحولات الاجتماعية، تكاد تقتصر على اللجوء إلى العنف واستخدام القوة. وما من شك في أن مثل هذه المقاربة المغرقة في الرجعية والمحافظة، والتي تركّز في جوهرها على الحفاظ على مؤسسات النظام، أي في الواقع على نظامٍ ومؤسساتٍ، كان فسادها السبب في الانفجار والأزمة الراهنة، ستشكل العائق الرئيس أمام تقدم العملية السياسية، وربما مقتلها. والسبب أن موسكو، حتى لو تمكّنت بالضغط العسكري من دفع المعارضة والدول الداعمة لها إلى الانخراط في المفاوضات، إلا أن رؤيتها تفتقر إلى البصيرة التي يحتاجها التوصل إلى تسويةٍ متوازنةٍ، توفق بين تطلعات الشعب السوري الذي قدّم أعظم التضحيات في السنوات الخمس الماضية، ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في الكارثة التي حلت به، بما فيها روسيا نفسها. كما أنها تفتقر إلى المرونة الكافية للتعامل مع قوىً سورية مشتتة، نظامية وغير نظامية، تابعة للدول أو مستقلة عنها. بالإضافة إلى أنها تفتقر للروح الإبداعية الضرورية لصوغ التوافقات الممكنة بين المصالح والرهانات المتباينة والمتناقضة والمتداخلة. وعلى الأغلب، سيحتاج الوضع إلى وقت طويل، قبل أن تدرك روسيا نقائص مقاربتها، في ما لو حصل وأدركت ذلك، وأن تتقدّم باقتراحاتٍ إيجابية قادرة على فكفكة العقد القائمة، وإعادة ترتيب الوضعين، الداخلي والإقليمي.
والمشكلة الثالثة موقف روسيا المسبق من نتائج مفاوضات التسوية السياسية، والذي يدفعها إلى
تبرير الاستمرار في الحسم العسكري، أو في تحقيق تغيير جذري في ميزان القوى على الأرض، من أجل فرض وجهة نظرها القائمة على مبدأ تعزيز وضع النظام، وإجبار المعارضة على الاندماج به من خلال حكومة وحدةٍ وطنيةٍ، ضماناً لمصالح الدول التي تعتقد خطأ أن نظام الأسد هو آخر حاجز أمام توسع الإرهاب وانتشاره وسيطرة منظماته. والحال، لا يمكن لمصير الهدنة أن ينفصل عن إطلاق عمليةٍ سياسيةٍ ذات صدقية تنظر إلى مصالح جميع الأطراف، وتدرك مركزية الرهانات القائمة وراء تضحيات السوريين واستبسالهم. ولن يكون من الممكن إطلاق مثل هذه العملية، ما لم تتوقف جميع الأطراف، وليس طرفاً واحداً عن التفكير في الحسم العسكري، أو في تغيير أساسي لميزان القوى على الأرض. ولا يهم ما إذا كان الساعي إلى هذا الحسم بشار الأسد أو الرئيس بوتين. ففي حال استمرار بعض الأطراف في سياسة الحسم العسكري، لن يعني قبول الأطراف الأخرى بها سوى تحييد نفسها، وإخراجها من الصراع، والمقصود هنا بشكل خاص فصائل الجيش الحر.
مهما كانت قوة موسكو وقدرتها على المبادرة، لن يكون من الممكن تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، وقبل ذلك في وقف إطلاق النار، قبل أن يدرك الروس أنه لا يمكن إنهاء الحرب السورية فقط من خلال التوصل إلى تسويةٍ، لا تأخذ في الاعتبار سوى مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة فيها. وأن وقف الحرب وإحلال السلام في سورية والمنطقة لن يتحققا إلا بالاعتراف بأسبقية مصالح السوريين، المعارضين والموالين، التي يتقدمها تفكيك نظام الرق والعبودية والذل والانتقال نحو نظام ديمقراطي، ومؤسسات قانونية، ودولة مدنية تخضع لحكم القانون، وتساوي بين جميع مواطنيها وتتعامل معهم من منطق الاحترام والسيادة، وتضع نفسها في خدمتهم، بدل أن تجندهم لتحقيق مصالح طغمة صغيرة تعمل وسيطاً لخدمة مصالح الدول الأجنبية على حساب مصلحة شعبها وضد تحرر أبنائه وانعتاقهم.
الاعتقاد بأن حرباً ضروساً أزهقت أرواح أكثر من نصف مليون سوري يمكن أن تنتهي من دون تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة مهما كانوا، أو أن السلام والمصالحة الإنسانية والوطنية يمكن أن يعودا من دون مساءلة أحد.
فكما أن الحرب لا يمكن أن تنتهي بالتوصل إلى تسويةٍ تقتصر على توزيع مناطق النفوذ والمصالح بين الأطراف الإقليمية والدولية، وتتجاهل مصالح الشعب السوري وحقوقه، كذلك لا يمكن للسلام الأهلي في سورية أن يتحقق إذا أصرّت موسكو على تجاهل مبادئ المساءلة والعدالة وتطبيق القانون. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يخرج سورية من محنة الحرب، ويضعها على طريق التفاهم والتعاون والازدهار.
بمعنى آخر، قبلت جميع الأطراف الدولية والإقليمية أن يستمر نزيف الدم السوري، وأن يضحّى بالسوريين، بانتظار أن تضمن كل الأطراف مصالحها في سورية المستقبل. ولأن هذه المصالح متناقضة ومتنافية، استمر القتال، مع ترديد جميع الأطراف، في وجه خصومها، شعاراً واحداً تبرّر به حربها وتدعو الآخرين إلى التراجع: ليس هناك حسم عسكري، ولا مخرج، إلا بالحل السياسي. لكن، في الواقع، جميع الأطراف تسعى إلى تغيير ميزان القوى، قبل أن تقبل بالدخول في أي مفاوضات جدية. أما الأسد فكان، ولا يزال وسيبقى، لا يفكر بشيء آخر سوى سحق أعدائه واستعادة مملكته الوراثية، معتقداً، عن حق، أنه مهما كان الحل السياسي القادم فسوف يكون لا محالة على حسابه، ولن يكون حل من دون خروجه حياً أو ميتاً من المسرح.
بيان فيينا ثم إصدار قرار مجلس الأمن رقم 2254 بتوافق جميع الأطراف، أظهر كما لو أن شرخاً ما حصل في هذه الحلقة المفرغة، أوحى للجميع بأن دورة جديدة من مفاوضات الحل السياسي يمكن أن تبدأ، أو أن الشروط لإطلاقها أصبحت جاهزة. منذ التدخل العسكري الروسي الواسع والمباشر في الحرب. وهذا ما بعث بعض التفاؤل في أوساط الرأي العام، ويمكن أن يخلق زخماً ما لو ثبتت الهدنة التي أعلنت في 27 من فبراير/ شباط 2016، ويكمن وراء هذا التغيير التفاهم الأميركي الروسي الذي يضمر وجود إرادة مشتركة لوضع حدٍّ للحرب الداخلية السورية، أو على الأقل، لتغيير قواعد اللعبة الحربية المستمرة منذ خمس سنوات، يقود إلى تخفيف حدة العنف، وتقليص النتائج المدمرة لاستمرارها على البيئة الإقليمية والدولية.
في هذا المستوى من التحليل، هناك من دون شك فرصة للتقدم نحو عمليةٍ سياسيةٍ جديدةٍ أكثر حظا من سابقاتها جنيف 1 و2، لأن جميع الأطراف المعنية المحلية والإقليمية مضطرة للمشاركة فيها، حتى لو أنها ليست مقتنعة بها، ولأن روسيا التي عرقلت العملية السياسية في السابق هي اليوم العراب الرئيسي لجنيف 3، بمشاركة واشنطن ومباركتها.
وهناك، من دون شك أيضاً، مصلحة كبيرة لروسيا في إنجاح المهمة التي أوكلت لها، والدفع
المشكلة الأولى في هذا التغيير الحاصل من حول القضية السورية هو أن باعثه ليس تحقيق تطلعات الشعب السوري التي تدخلت جيوش وقوى إقليمية ودولية عديدة لقطع الطريق عليه، ولا حتى السعي إلى تخفيف معاناة السوريين، بالرغم من احتمال أن يكون ذلك من آثارها. الحافز الحقيقي لذلك هو خوف الغربيين والروس معا من مضاعفات استمرار الحرب على مصالحهم الاستراتيجية، سواء ما تعلق منها بتجذر الإرهاب وانتشاره وتمدده في اتجاهها، وقد عانى بعضها منذ الآن من التفجيرات الإرهابية، أو بتفاقم أزمة اللجوء التي تهدد بتقويض التفاهم الهش أصلا داخل الاتحاد الأوروبي وبدرجة ثالثة الضغط المتزايد لدول الخليج العربي التي تشعر بالتهديد المباشر على أمنها الوطني والإقليمي. وهذا يعني أن المقاربة الدولية للحل سوف تكون مرتبطةً بشكل أكبر بتحقيق هذه الرهانات الإقليمية والدولية الجيوسياسية، بصرف النظر عن مصالح السوريين ومستقبل سورية نفسها، أو ربط هذه المصالح الأخيرة بأجندة الحل الدولية. بل من الأغلب أن تتم على حساب سورية والسوريين سواء بالذهاب نحو نوع من التقسيم السياسي الذي يشرعن تقاسم مناطق النفوذ بين الدول، أو التقسيم الطائفي الذي يضمن للجميع التدخل للتحكم بمستقبل البلاد ومصيرها.
المشكلة الثانية أن روسيا التي أوكل إليها دور رعاية الحل السياسي لا تملك أي رصيد إيجابي في مسألة الاستجابة لتطلعات الشعوب، بل ربما كانت من أكثر الدول عداءً لها، وأن معالجتها هذا النوع من الثورات، أو التحولات الاجتماعية، تكاد تقتصر على اللجوء إلى العنف واستخدام القوة. وما من شك في أن مثل هذه المقاربة المغرقة في الرجعية والمحافظة، والتي تركّز في جوهرها على الحفاظ على مؤسسات النظام، أي في الواقع على نظامٍ ومؤسساتٍ، كان فسادها السبب في الانفجار والأزمة الراهنة، ستشكل العائق الرئيس أمام تقدم العملية السياسية، وربما مقتلها. والسبب أن موسكو، حتى لو تمكّنت بالضغط العسكري من دفع المعارضة والدول الداعمة لها إلى الانخراط في المفاوضات، إلا أن رؤيتها تفتقر إلى البصيرة التي يحتاجها التوصل إلى تسويةٍ متوازنةٍ، توفق بين تطلعات الشعب السوري الذي قدّم أعظم التضحيات في السنوات الخمس الماضية، ومصالح الأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في الكارثة التي حلت به، بما فيها روسيا نفسها. كما أنها تفتقر إلى المرونة الكافية للتعامل مع قوىً سورية مشتتة، نظامية وغير نظامية، تابعة للدول أو مستقلة عنها. بالإضافة إلى أنها تفتقر للروح الإبداعية الضرورية لصوغ التوافقات الممكنة بين المصالح والرهانات المتباينة والمتناقضة والمتداخلة. وعلى الأغلب، سيحتاج الوضع إلى وقت طويل، قبل أن تدرك روسيا نقائص مقاربتها، في ما لو حصل وأدركت ذلك، وأن تتقدّم باقتراحاتٍ إيجابية قادرة على فكفكة العقد القائمة، وإعادة ترتيب الوضعين، الداخلي والإقليمي.
والمشكلة الثالثة موقف روسيا المسبق من نتائج مفاوضات التسوية السياسية، والذي يدفعها إلى
مهما كانت قوة موسكو وقدرتها على المبادرة، لن يكون من الممكن تحقيق أي تقدم في العملية السياسية، وقبل ذلك في وقف إطلاق النار، قبل أن يدرك الروس أنه لا يمكن إنهاء الحرب السورية فقط من خلال التوصل إلى تسويةٍ، لا تأخذ في الاعتبار سوى مصالح الأطراف الإقليمية والدولية المنخرطة فيها. وأن وقف الحرب وإحلال السلام في سورية والمنطقة لن يتحققا إلا بالاعتراف بأسبقية مصالح السوريين، المعارضين والموالين، التي يتقدمها تفكيك نظام الرق والعبودية والذل والانتقال نحو نظام ديمقراطي، ومؤسسات قانونية، ودولة مدنية تخضع لحكم القانون، وتساوي بين جميع مواطنيها وتتعامل معهم من منطق الاحترام والسيادة، وتضع نفسها في خدمتهم، بدل أن تجندهم لتحقيق مصالح طغمة صغيرة تعمل وسيطاً لخدمة مصالح الدول الأجنبية على حساب مصلحة شعبها وضد تحرر أبنائه وانعتاقهم.
الاعتقاد بأن حرباً ضروساً أزهقت أرواح أكثر من نصف مليون سوري يمكن أن تنتهي من دون تحديد المسؤوليات ومعاقبة الجناة مهما كانوا، أو أن السلام والمصالحة الإنسانية والوطنية يمكن أن يعودا من دون مساءلة أحد.
فكما أن الحرب لا يمكن أن تنتهي بالتوصل إلى تسويةٍ تقتصر على توزيع مناطق النفوذ والمصالح بين الأطراف الإقليمية والدولية، وتتجاهل مصالح الشعب السوري وحقوقه، كذلك لا يمكن للسلام الأهلي في سورية أن يتحقق إذا أصرّت موسكو على تجاهل مبادئ المساءلة والعدالة وتطبيق القانون. هذا هو الطريق الوحيد الذي يمكن أن يخرج سورية من محنة الحرب، ويضعها على طريق التفاهم والتعاون والازدهار.