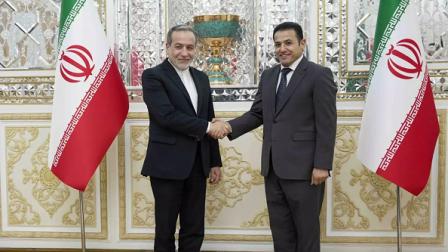يرتبط مأزق المقاومة الفلسطينية ارتباطاً عضوياً بمأزق السياسة الفلسطينية وفجوة الشرعية. وفي ظل ترهّل الحقل والفكر السياسي وغياب القيادة الممثِّلة، تزداد درجة التشنّج والاحتقان بين حقلي المقاومة والسياسة؛ وإن كان ترابطهما العضوي يعني أنهما بالأصل مكمّلان لبعضهما البعض، خصوصاً في ظل العيش تحت شرط كولونيالي استعماري.
فالفعل السياسي يجب أن يكون فعلاً مقاوماً مشتبكاً مستجيباً لتطلّعات الجماهير. ولكن هذا الترابط النظري بين المقاومة والسياسة تبّدّل عبر العقدين الماضيين بموجب مقتضيات المرحلة وشخوصها وأولوياتها وشروط المانحين وإفرازات علاقات القوى بين المستعمَر والمستعمِر.
على سبيل المثال، بعد نشوء السلطة الفلسطينية وما رافق ذلك من أزمة هوياتية لقيادتها ما بين العمل كبيروقراطية إدارية أو كامتداد لثورة عادت للوطن، لم تستطع تلك السلطة تجريم المقاومة المسلّحة أو تقزيم الفعل والسلوك المقاوم (بعمومه وليس بتسلّحه فقط) رغم المراوغات المتعدّدة تحت سقف العملية السلمية البائسة.
ولكن، خلال العقد الأخير وكأحد متطّلبات مشروع بناء الدولة والعصرنة والحوكمة الرشيدة، كان لزاماً (والذي ما لبث أن أضحى اقتناعاً) على السلطة الفلسطينية البدء بعملية إعادة خلق لأجهزتها ومنظومتها الأمنية لأهداف عدّة من ضمنها تجريم المقاومة المسلّحة وتسليع "المقاومة" السلمية.
عملية التسليع هذه من طرف السلطة الفلسطينية ترافقت مع نشوء "صناعة ومهننة" للمقاومة السلمية يتقاضى خلالها شخوص ومؤسّسات الأموال مقابل خدماتهم المقاوِمة. فقد أقدمت بعض مؤسّسات السلطة الفلسطينية وشخوصها على "تكنقرطة" المقاومة السلمية -كنتيجة لاقتحام مصطلح التكنوقراط للساحة السياسية الفلسطينية- وأصبحت المقاومة السلمية تُفهَم في تلك الأروقة السياسية كخدمة مدفوعة الأجر تقدَّم بموجب عقود ومواعيد نهائية لتسليم المخرجات.
بالطبع، هذا التوصيف لا ينطبق على الفعل المقاوم السلمي- الشعبي اليومي النابع من الفعل الجماهيري الشعبوي التعبوي؛ فالتسليع هنا هو من شأن بعض مؤسّسات السلطة الفلسطينية وإن غطّت ووَصَفت عملية التسليع هذه بكلمات أخرى لتمويه حقيقة ما يحدث.
هذا التسليع لأشكالٍ من أشكال المقاومة السلمية ينسجم تماماً مع البرنامج السياسي المتبنَّى من قبل السلطة الفلسطينية، والذي لا يستجيب بحدّه الأدنى لتطلعات الفلسطينيين في الوطن والمنفى، وينسجم أيضاً مع نهج السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني ومنع الاشتباك مع المحتل بالمعنى الواسع والشامل، ويأتي كذلك كنتيجة حتمية للاعتمادية المطلَقة على الغير بدل الذات بما فيها المساعدات الدولية المشروطة وللسياسات الاقتصادية النيوليبرالية المتبنّاة.
هذا الانسجام والتكامل زاد من ضعف ووهن المجتمع الفلسطيني في مقاومة المحتلّ والمستعمِر، وأضحى الفعل المقاوم، أو مجرّد الاحتجاج الفعّال، هو الاستثناء بدل القاعدة.
وبالتالي، وكأحد إفرازات مشروع بناء الدولة وكترجمة ضيقة منقوصة لنهج "سلاح واحد، قانون واحد، سلطة واحدة"، أضحى مصطلح "المقاومة" بحدّ ذاته مصطلحاً "قذراً" في أروقة صنع القرار السياسي الفلسطيني، وهنا تكمن الخطورة الأكبر؛ إذ أن الهدف الأخطر لعملية إعادة بناء الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية والتحوّلات السلطوية المرافقة لتلك العملية تمثّل في العمل على ضرورة ضرب عنصر ووعي المقاومة، بمعناها الواسع، وإن كانت المقاومة المسلّحة هي الهدف الأهم لتلك العمليات، ونهجها كنهج فعّال للتحرّر من الاستعمار.
لم تستهدف العمليات الأمنية للسلطة الفلسطينية لضرب الفعل المقاوم المسلّح فقط، بل استهدفت فكرة وسلوك وجوهر ووعي المقاومة. فقد عرّف المجتمع الفلسطيني نفسه على مر العقود كمجتمع مقاوم، والآن وبموجب متطلّبات العصرنة وبناء الدولة يجري ضرب أحد أهم الأسس في بناء المجتمع الفلسطيني وهويته من دون مراعاة مركزية عنصر المقاومة والشرعية والفعالية السياسية التمثيلية في الوعي العام.
وبالتالي، فلا عجب أن نرى مزيداً من الإحباط واليأس والغضب خصوصاً مع تجذّر التحوّلات السلطوية القمعية، ومع توسّع نفوذ المؤسّسات الأمنية للسلطة الفلسطينية في كافة مناحي الحياة الفلسطينية على حساب المقاومة الشاملة وفعلها.
بالطبع، هذه ليست دعوة إلى "الفلتان الأمني" كما قد يودّ أن يراها بعضهم، وإنما هي دعوة لأهمية مركزية الناس في فعلهم وقرارهم الوطني والسياسي المقاوم، ودعوة أيضاً للتساؤل حول أيهما أهما: احترام الفلسطينيين للقانون المدفوع أمنياً، أم احترام القانون للفلسطينيين المدفوعين بفعلهم السياسي - المجتمعي المقاوم للاستعمار؟
ولأن منهج الحصرية المطلقة لن يجدي أبداً، بمعنى أن تقاطُع المقاومة والسياسة ستبقى قاعدة ثابتة خصوصاً تحت الاستعمار، ولأن إمكانات المقاومة المسلّحة مضمحلّة وميزان القوى المختل ليس في صالحها، فالمطلوب هو تبني المقاومة كنهج حياة تحت الاستعمار بدلاً عن تبنيها كأداة نضالية فحسب.
فالأداة يمكن أن تُستغل وتسوّغ، ولكن النهج يُبنى بثبات ويتداخل مع مقوّمات المجتمع وخياراته. فالمقاومة كأداة كانت مسرحاً للتلاعب السياسي خصوصاً في ظل نظام حوكمة شخصاني فرداني زبائني وهو الذي أضعف المقاومة، فكراً وممارسة، على مر السنين والذي سهّل بدوره عملية تجريمها خلال مرحلة بناء مؤسّسات الدولة في العقد الماضي.
المقاومة كنهج للحياة تحت الاستعمار تعني في ما تعنيه إعادة القيمة للمُثُل والقيم الأصيلة للمجتمع الفلسطيني التي أهلّته على مّر العقود لمواجهة الاستعمار بدل الرضوخ له. تعني أيضاً تحويل الإحباط واليأس إلى فعل سياسي جماعي مشتبك لإحراز الحقوق الوطنية والمدنية والإنسانية. وتعني كذلك أن اعتياد امتهان كرامة الفلسطينيين لن يمر من دون عواقب منظّمة تخلخل النُظم الاستعمارية والقمعية.
(باحث وأكاديمي فلسطيني/ جنيف، مدير البرامج في الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية)