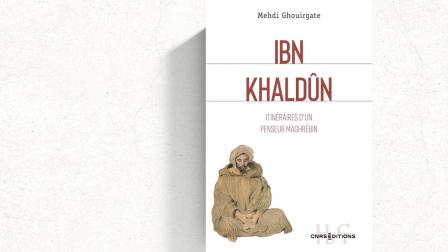سامية حلبي، الشاطئ الزهري، 2013
للعمل الفني سطوة على النفس، سواء أكان يمثّل الطبيعي أم البشري، وسواء أكان بورتريهاً أم مشهداً، تجريداً أم تشخيصاً، أو مزيجاً منهما، بل سواء أكان ما يقترحه جميلاً بالمقاييس المتداولة أم بشعاً بالمعنى نفسه. لكننا، والعمل قد اكتمل وأنجز، غالباً ما لا نفكّر في سيروة تكوينه، أي الطريقة التي بها وصل إلينا في اكتماله، أو عدم اكتماله القصدي. بل إننا لا نعرف غالباً شيئاً عن حياة الفنّان ومعاناته. والحال أن سيروة تكوّن العمل الفني كما حياة صاحبه، تتألّفان من الثراء ومن الحيوية والتعقّد والمفاجآت والتعرجات، ما يجعلها أحياناً أشدّ غنى من العمل الفنّي نفسه، تضيف إليه من مكنوناتها، وتضيء بعض ما غمض منه.
حين كتب جان جونيه عن مشغل ألبيرتو جياكوميتي، أدرك أن العالم الذي يبدعه الفنّان لصيقٌ بعناصر المكان وأجوائه. وأن ثمة تناغماً وجودياً بين رحم الإبداع وكائناته التي تنبثق منه، بين الجرح الذي يحمله الفنان ورغباته الدفينة. وفي أواسط التسعينيات قال لي عبد الكبير الخطيبي: "إننا نتعلّم الكثير من مراسم ومشاغل الفنانين".
هذه الفضاءات التي تتنفّس الإبداع ونتنفّسها فيه: مغارة الإبداع ورحمه. إنها تزخر بالحكايات والوحدة القاتلة والمعاناة والألم. المشغل مرآة يرى فيها الفنّان نفسه، وهو يجهد ويصارع كي يتولَّد من يديه عمل نتلقاه ببساطة المعاين المشاهد.
نشأت الصورة أو العمل التصويري كما يحكي بلاين القديم، من خيال الحبيب الغائب المرسوم على الجدار. ثمّ كان أصل العمل استحضاراً للغائب يجرّده من حسّيته. كانت الصورة عبارة عن شبحٍ، ومن ثمّ كان أصل الفنّ تجريدياً، غير أنه استحضاري. وهذه الوظيفة ما زالت تخترق العمل الفنّي. فمغارة الإبداع المنعزلة، تستحضر الذات والعالم الخارجي، بل إنها تستنفر الذات لتحوّلها إلى شلالٍ مرئي ينهل منه الفنّان. لهذا يمكننا أن نعرف، أو على الأقل، أن نستشّف مدى قوّة الأعمال الفّنية لفنّان ما، من الطريقة التي يشتغل بها، ومن أنواع الخامات والمواد والحوامل التي يستعملها.
فضاء المشغل جزءٌ من العملية الإبداعية، لأنه يحتضن أسرار اللعبة الفنّية. إنه المسرح الباطن للفنّان، يعرفه بكامل تفاصيله ويحبّه بكامل جوارحه ويسكن إليه في عزّ الحيرة الإبداعية. منه يستمدّ قوّته الإلهامية، وفيه يفجر مكنوناته التعبيرية. لهذا تدبّ في المشاغل حركة الحكايات التي تحتضنها، وأسرار لحظات اليأس والإحباط والسؤال الحارق الذي يعيشه الفنّان في غياب الآخرين. فتوحّده ذو طابع أنطولوجي لأنه الشرط الذي يجعله يستمدّ الطاقة المبدعة من الكون ومن أحشائه.
وبما أن فضاء المشغل يعدّ جزءاً من حياة الفنّان، فإنه بشكل أو بآخر، يشكّل عصارتها الوجودية. وبين المعطيين الإبداعيين ضربٌ من التواشج بحيث تنساب الحياة في المشغل وعلى صفحة العمل الفنّي، مهما كانت طبيعتها، كما على شاشة الحلم. فإذا كانت الحياة الشخصية للفنّان ممتلئة بالمفارقات وبالإحباط، أو بالكآبة والانفصام، فإن هذا الطابع المأساوي يظلّ لصيقاً بـ "بشرة الفنّان الذهنية"، ليعبّر عن وجوده في الفاصل الواصل بين الواقع والحلم، وبين الرغبة الغنية التي تحملها الذات من جهة، وشحّ الواقع وقصوره من جهة أخرى. بهذا المعنى يكون المأساوي، المسارَ التكويني للعمل الفنّي من حيث إنه يشكّل البركان المفجّر للإبداع. وهو الأمر الذي يجعل رغبات الفنان وأحلامه عالماً أشدّ شساعة وعمقاً من العالم الواقعي، ذلك العالم الذي وصفه رونيه جيرار بأنه عالم منحط، ووصفه مارتن هايدغر بأنه عالم مطبوع بالاختلاف بين الوجود العامّ والوجود الفردي.
في نهاية القرن الماضي، طلب مني أحد الفنانين أن أشير عليه باسم صحافي يساعده لكتابة سيرته الذاتية والفنية. وبعد عام، أتاني فرحاً بالمخطوط. قرأت السيرة فوجدت أسلوب الصحافي أكثر متعة من السيرة نفسها. إذ كانت لا تحوي أي شيء عن معاناته ولقاءاته والجوّ السياسي والتحوّلات التي عايشها، لسبب بسيط أنه ليس لديه ما يحكيه. حينها أدركت لِمَ كانت أعماله فارغة وطنّانة كطبل، ولم طغى عليها الطابع الزخرفي التنميقي، ولِمَ لمْ أحسّ أمامها أبداً بعمقٍ يشدّني إليها.
بيد أن مفهوم المشغل صار مع التحولات الجديدة للفنون البصرية، فضاءً مغايراً. فهو في المنجزات الفنية، أي Performance، فضاءٌ مسرحي قد يكون أي مكان، بل قد يكون فضاءُ الإبداع، فضاءَ العرض. وهو في فنّ الفيديو شاشة الحاسوب ومناطق التصوير. وبهذا المعنى، فإن الفضاء القارّ صار فضاءً محمولاً كالحاسوب والهاتف الجوال. ومع ذلك يظلّ لكلّ فنان، مهما تشتّت مكان إنتاجه للعمل الفنّي، علاقة بمشغل ما وبأمكنة رمزية، فيها يرتكن الفكر والجسد للإبداع.
فيغدو تكوين العمل الفنّي وحكاية إبداعه جزءاً لا يتجزأ من هذا العمل. إنه بالأحرى قطعةٌ من حياة الفنّان ومجالٌ تتفجّر فيه طاقة الخلق، بل تفور فيه كالبركان أحياناً مخلّفة الكثير من الندوب والجروح. وبذلك تكون حياة الفنّان الحكاية الكبرى التي تتجسّد في حكايات أخرى عبر إنتاج كلّ عمل فني.
حين يطلب منك أحد كتابة نصّ لـ "كاتالوغه"، يرسل لك الصور ظانّاً أنها تكفي. والحال فإن صورة العمل الفنّي، خصوصاً إذا كان مجسّماً، لا يمكن أن تفي بالغرض، لأنها محكومة بزاوية النظر والنور وغيرها. وحين تطلب منه رؤية الأعمال، يندهش. فمثلما تتلطّخ اليد التي صنعت العمل الفنّي بالمواد والأصباغ، كذلك عين الناقد أو الكاتب؛ إذ حين تقع على العمل الفني، ترجّ الجسد بكامله، فترى يدَ الناقد تتحسّس العمل، وتستمد من تضاريسه منافذ للتأويل. وفي المشغل تبدو تلك الأعمال كوليدٍ تريد أن تتلمّسه بيدك وتتحسس "بشرته". إنها علاقة عشق يمنحها المشغل فتنةً لا تقل متعتها عن متعة الإبداع.
حين كتب جان جونيه عن مشغل ألبيرتو جياكوميتي، أدرك أن العالم الذي يبدعه الفنّان لصيقٌ بعناصر المكان وأجوائه. وأن ثمة تناغماً وجودياً بين رحم الإبداع وكائناته التي تنبثق منه، بين الجرح الذي يحمله الفنان ورغباته الدفينة. وفي أواسط التسعينيات قال لي عبد الكبير الخطيبي: "إننا نتعلّم الكثير من مراسم ومشاغل الفنانين".
هذه الفضاءات التي تتنفّس الإبداع ونتنفّسها فيه: مغارة الإبداع ورحمه. إنها تزخر بالحكايات والوحدة القاتلة والمعاناة والألم. المشغل مرآة يرى فيها الفنّان نفسه، وهو يجهد ويصارع كي يتولَّد من يديه عمل نتلقاه ببساطة المعاين المشاهد.
نشأت الصورة أو العمل التصويري كما يحكي بلاين القديم، من خيال الحبيب الغائب المرسوم على الجدار. ثمّ كان أصل العمل استحضاراً للغائب يجرّده من حسّيته. كانت الصورة عبارة عن شبحٍ، ومن ثمّ كان أصل الفنّ تجريدياً، غير أنه استحضاري. وهذه الوظيفة ما زالت تخترق العمل الفنّي. فمغارة الإبداع المنعزلة، تستحضر الذات والعالم الخارجي، بل إنها تستنفر الذات لتحوّلها إلى شلالٍ مرئي ينهل منه الفنّان. لهذا يمكننا أن نعرف، أو على الأقل، أن نستشّف مدى قوّة الأعمال الفّنية لفنّان ما، من الطريقة التي يشتغل بها، ومن أنواع الخامات والمواد والحوامل التي يستعملها.
فضاء المشغل جزءٌ من العملية الإبداعية، لأنه يحتضن أسرار اللعبة الفنّية. إنه المسرح الباطن للفنّان، يعرفه بكامل تفاصيله ويحبّه بكامل جوارحه ويسكن إليه في عزّ الحيرة الإبداعية. منه يستمدّ قوّته الإلهامية، وفيه يفجر مكنوناته التعبيرية. لهذا تدبّ في المشاغل حركة الحكايات التي تحتضنها، وأسرار لحظات اليأس والإحباط والسؤال الحارق الذي يعيشه الفنّان في غياب الآخرين. فتوحّده ذو طابع أنطولوجي لأنه الشرط الذي يجعله يستمدّ الطاقة المبدعة من الكون ومن أحشائه.
وبما أن فضاء المشغل يعدّ جزءاً من حياة الفنّان، فإنه بشكل أو بآخر، يشكّل عصارتها الوجودية. وبين المعطيين الإبداعيين ضربٌ من التواشج بحيث تنساب الحياة في المشغل وعلى صفحة العمل الفنّي، مهما كانت طبيعتها، كما على شاشة الحلم. فإذا كانت الحياة الشخصية للفنّان ممتلئة بالمفارقات وبالإحباط، أو بالكآبة والانفصام، فإن هذا الطابع المأساوي يظلّ لصيقاً بـ "بشرة الفنّان الذهنية"، ليعبّر عن وجوده في الفاصل الواصل بين الواقع والحلم، وبين الرغبة الغنية التي تحملها الذات من جهة، وشحّ الواقع وقصوره من جهة أخرى. بهذا المعنى يكون المأساوي، المسارَ التكويني للعمل الفنّي من حيث إنه يشكّل البركان المفجّر للإبداع. وهو الأمر الذي يجعل رغبات الفنان وأحلامه عالماً أشدّ شساعة وعمقاً من العالم الواقعي، ذلك العالم الذي وصفه رونيه جيرار بأنه عالم منحط، ووصفه مارتن هايدغر بأنه عالم مطبوع بالاختلاف بين الوجود العامّ والوجود الفردي.
في نهاية القرن الماضي، طلب مني أحد الفنانين أن أشير عليه باسم صحافي يساعده لكتابة سيرته الذاتية والفنية. وبعد عام، أتاني فرحاً بالمخطوط. قرأت السيرة فوجدت أسلوب الصحافي أكثر متعة من السيرة نفسها. إذ كانت لا تحوي أي شيء عن معاناته ولقاءاته والجوّ السياسي والتحوّلات التي عايشها، لسبب بسيط أنه ليس لديه ما يحكيه. حينها أدركت لِمَ كانت أعماله فارغة وطنّانة كطبل، ولم طغى عليها الطابع الزخرفي التنميقي، ولِمَ لمْ أحسّ أمامها أبداً بعمقٍ يشدّني إليها.
بيد أن مفهوم المشغل صار مع التحولات الجديدة للفنون البصرية، فضاءً مغايراً. فهو في المنجزات الفنية، أي Performance، فضاءٌ مسرحي قد يكون أي مكان، بل قد يكون فضاءُ الإبداع، فضاءَ العرض. وهو في فنّ الفيديو شاشة الحاسوب ومناطق التصوير. وبهذا المعنى، فإن الفضاء القارّ صار فضاءً محمولاً كالحاسوب والهاتف الجوال. ومع ذلك يظلّ لكلّ فنان، مهما تشتّت مكان إنتاجه للعمل الفنّي، علاقة بمشغل ما وبأمكنة رمزية، فيها يرتكن الفكر والجسد للإبداع.
فيغدو تكوين العمل الفنّي وحكاية إبداعه جزءاً لا يتجزأ من هذا العمل. إنه بالأحرى قطعةٌ من حياة الفنّان ومجالٌ تتفجّر فيه طاقة الخلق، بل تفور فيه كالبركان أحياناً مخلّفة الكثير من الندوب والجروح. وبذلك تكون حياة الفنّان الحكاية الكبرى التي تتجسّد في حكايات أخرى عبر إنتاج كلّ عمل فني.
حين يطلب منك أحد كتابة نصّ لـ "كاتالوغه"، يرسل لك الصور ظانّاً أنها تكفي. والحال فإن صورة العمل الفنّي، خصوصاً إذا كان مجسّماً، لا يمكن أن تفي بالغرض، لأنها محكومة بزاوية النظر والنور وغيرها. وحين تطلب منه رؤية الأعمال، يندهش. فمثلما تتلطّخ اليد التي صنعت العمل الفنّي بالمواد والأصباغ، كذلك عين الناقد أو الكاتب؛ إذ حين تقع على العمل الفني، ترجّ الجسد بكامله، فترى يدَ الناقد تتحسّس العمل، وتستمد من تضاريسه منافذ للتأويل. وفي المشغل تبدو تلك الأعمال كوليدٍ تريد أن تتلمّسه بيدك وتتحسس "بشرته". إنها علاقة عشق يمنحها المشغل فتنةً لا تقل متعتها عن متعة الإبداع.