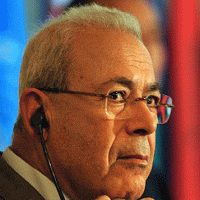11 نوفمبر 2024
العيش في عالم من دون عهد وعقد وضمير
من مظاهرة في برلين تضامناً مع حلب (1أكتوبر/2016/Getty)
لا تكاد عمليات القصف الوحشي بالطائرات والصواريخ البعيدة والقريبة للمدن والقرى في سورية، وقتل المدنيين نساءً وأطفالاً، من دون تمييز، منذ ما يقرب من ست سنوات على التوالي، ولا الاستخدامات المتكرّرة للغازات الكيميائية والقنابل العنقودية والحارقة المحرّمة، وصور آلاف القتلى تحت التعذيب في معتقلات الموت، ولا محاصرة المدن والبلدات وتجويع سكانها، ولا القصف المتعمد للمشافي والمدارس وتفريغ حافلات الإغاثة الإنسانية من الأدوية وحليب الأطفال، بغرض إرسال رسالة الحكم بالموت على الأهالي وإجبارهم على الرحيل أو الاستسلام، أقول لا تكاد هذه الأعمال اللاإنسانية تثير أي حركة تضامنٍ فعلية مع الشعب السوري المنكوب، لا على مستوى الشارع العربي، ولا من باب أولى على مستوى العالم. ولم تنظم مظاهرة واحدة ذات معنى لنصرة الشعب السوري، كما كان يحصل في الماضي في الحرب الفيتنامية، وفي زمن أقرب إلينا، إزاء مأساة البوسنة والهرسك، بل يمكن القول إن ما يسم الموقف العربي والعالمي، الشعبي والرسمي، هو بالأحرى التراجع عما كان عليه التضامن في السنة الأولى للثورة، من حيث التأييد الشعبي والتعبير عنه معا.
في سبب انعدام التضامن
ما من شك في أن قصور السوريين وتقصيرهم، وانقسامات معارضاتهم، وتضارب خياراتهم، أضعف تعاطف العالم معهم. وما من شك أيضا في أن دخول التنظيمات الجهادية على الخط زاد في تشويش صورة كفاحهم البطولي والعادل من أجل الحرية، وضد نظام القهر والطغيان، وأن الطابع الإسلامي الذي آلت إليه قوى الثورة المسلحة السورية نفّر جزءاً كبيراً من العالم أو أخافه. ومع ذلك، لا يفسر هذان العاملان السقوط الأخلاقي والسياسي للرأي العام العالمي أمام محنة السوريين ومعاناتهم، فلا يمنع ضعف المعارضة الرأي العام من معرفة حقيقة ما يجري والظلم الواقع على السوريين بالفعل. ولم يصبح الطابع الإسلامي غالباً على قوى الثورة، إلا بسبب تنكر العالم لها، وترك شبابها لأشهر طويلة، يواجهون العنف المتوحش بصدروهم العارية، من دون دعم ولا اعتراف ولا عون، فمن اليأس من العالم وفقدان الأمل بتضامنه ولد شعار "ما لنا غيرك يا الله"، ولا يزال الشعار الأكثر تجسيداً لواقع الحال. كان الأولى أن يزيد ضعف المعارضة وقصورها، والخوف من سعي الأيديولوجيات الجهادية إلى ملء الفراغ الذي أنتجه تقاعس المجتمع الدولي، من تأييد الرأي العام العالمي لثورة السوريين الديمقراطيين، والتعاطف مع تضحياتهم ومد يد المساعدة لهم، وهذا ما كنا ننتظره، وندعو إليه باستمرار خلال أشهر طويلة قبل فوات الأوان، بل لم يكن لدخول الجهاديين والسلفيين على الخط أن يدفع إلى خلط الأوراق والتنكر للقضية السورية التحررية، إلا لوجود رغبة مسبقة في التهرّب من المسؤوليات الأخلاقية والسياسية واستخدام هذا الدخول ذريعةً لتبرير التنكر لواجب التضامن الإنساني، وهذا ما حصل بالضبط.
وعلى جميع الأحوال، لا يمكن لهذه العوامل نفسها أن تفسّر انعدام التضامن الملحوظ، حتى في بلدان العالم العربي والإسلامي الذي لا تشغله مخاوف الغرب ولا حساسياته، فلم يشهد هذا
الفضاء الفسيح، حتى داخل الدول التي تدعم المعارضة، أي تعبيرات شعبيةٍ واضحةٍ تعكس التفاعل مع المعاناة السورية. لا يلغي هذا الواقع الدعم الذي تلقته بعض قوى الثورة المسلحة من بعض الحكومات ضمن إطار تقاطع المصالح الاستراتيجية، ولا ينفي التعاطف القلبي من قطاعات واسعة من الرأي العام، كما تجسّده جهود الجمعيات الخيرية. لكن، في ما وراء ذلك التعاطف الإنساني والديني، لم تنظم أي مسيرة أو تظاهرة أو اعتصام يعبّر عن موقف سياسي ويتسلح بمطالب محدّدة للحكومات والقوى الاجتماعية والسياسية. التعاطف مشاركة وجدانية لا تعني تبني القضية، ولا التعاطف مع قيمها، ولا الاستعداد لتحمل ثمن المساهمة في نصرتها، أما التظاهرات العلنية فهي فعل تضامن سياسي بامتياز.
قد يكون السبب هنا أيضاً غياب الثقافة التضامنية، بعد عقود طويلة من شل المجتمعات، والقضاء على استقلالها الفكري والعملي تجاه السلطة، وتعقيمها سياسياً وأخلاقياً، لتحييدها حتى في ما يتعلق بتضامن أبنائها في ما بينهم. هذا صحيح في بعض الحالات فقط، لكنه لا يكفي لتفسير حالة انعدام الحركة، في مواقع ومناطق إسلامية لا يحمل التعبير فيها عن التضامن أي مخاطر أو أثمان صعبة الاحتمال.
من الواضح أن الأمر لا يتعلق فقط بمحنة السوريين، وإنما بحالةٍ عامةٍ تنطبق على جميع القضايا المشابهة. ونحن أنفسنا لم نقم بأي تظاهرة للتعبير عن غضبنا أو تضامننا مع مجازر رواندا أو البوسنة من قبل. المآل الذي آلت إليه أوضاعنا، نحن السوريين، جزء من المآل الذي آلت إليه الإنسانية التي ننتمي إليها في هذا القرن الواحد والعشرين، الحامل لانقلابات أعمق بكثير مما شهدته أجيال القرن الماضي، بمقدار ما هو عصر التحولات الكبرى والطويلة المدى.
عولمة الأسواق والإغلاق على الثقافات
حتى نلتقط بعض العناصر التي تساعد على فهم غياب التضامن بين الناس داخل المجتمعات وبين الشعوب، وما إذا كان لا يزال من الممكن إحياء الضمير العالمي، من المفيد العودة إلى العقود الثلاثة، وربما الأربعة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية. سنلاحظ عندئذ، بالعكس، أن التضامن كان الظاهرة الأبرز، وشكل عاملاً أساسياً في الدفع نحو تحولات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، على مستوى المعمورة. ولعل أفضل مثال على ذلك التضامن العالمي في قضية التحرر من الاستعمار التي تجلى فيها تضامن الشعوب المستعمَرة، بالفتح، على أوسع نطاق في ما بينها، لكن أيضا حصول تظاهرات تضامنٍ لا تقل أهميةً مع القضية ذاتها داخل الدول الاستعمارية، شارك فيها مثقفون وسياسيون وجمهور واسع من الناس العاديين. وحصل ما يشبه ذلك في فترة انتشار العقيدة اليسارية والثورة الاجتماعية والاشتراكية، حتى اتخذت سمة الأممية واسمها. وهناك مثال آخر أقرب إلينا هو ما شهدته البلدان العربية في ما أطلقنا عليه اسم الحقبة القومية، والناصرية بشكل خاص، حيث كان التفاعل على درجة كبيرة بين القوى السياسية والشعبية على امتداد الدائرة العربية. وفي السياق ذاته، يمكننا الإشارة إلى قوة التضامن الذي لا نزال نشاهده اليوم بين الحركات النسوية، أو بين حركات البيئة التي تتخذ بعداً عالمياً حقيقياً.
نلاحظ في كل تلك الأمثلة أمرين: وجود قضية مشتركة، وأمل كبير بعدالتها وانتصارها.
وتعني القضية المشتركة الشعور بوجود قيم ومصالح مشتركة عند القوى المتضامنة، ينجم عنه شعور مواز بوحدة المصير وإيمان مشترك لدى نخب وقطاعات واسعة من الرأي العام، بما يشبه الهوية الواحدة، أو ما يمكن أن نسميه جماعة معيارية واحدة، تقرّب في ما بين أعضائها وحدة القيم والأهداف والتطلعات، وتدفعها إلى تحديد مماثل للصديق والعدو، لكن مشروع التحرّر من الاستعمار لم يكن سوى جزء من مشروع أشمل وأكبر، قاد الإنسانية في تلك العقود، وألهب حماسها، ووحّد خطى القوى الحية من شعوبها، هو مشروع تصفية إرث النظام الاستعماري القديم، وبناء عالم تتساوى فيه الشعوب، على أساس الاعتراف بحقها المتساوي في تقرير مصيرها، وهو مشروع إعادة بناء العالم على نموذج الدولة الأمة، بدل الإمبرطوريات والسلطنات، وهو النموذج المؤسس على مثال الدولة السيدة التي تشكل الإطار القانوني والسياسي للأمة الحرة التي تضمن السيادة والحرية والعدالة لكل فرد فيها. وقد شاركت جميع التيارات العقائدية لتلك الحقبة، الاشتراكية والديمقراطية والشيوعية، وجميعها من النوع الكوني أو الشامل للإنسانية، في نشر عقيدة التحرّر والمساواة والعدالة والانعتاق هذه، ومهّدت لحقبة جديدة من التفاهم والتعاون بين الشعوب. وهي التي طبعت، بعد مرحلة الحروب والنزاعات الاستعمارية، ثقافة تلك الحقبة وسلوك أجيالها. وفي هذا السياق الفكري والسياسي، تطورت أيضا ديناميكيات انصهار المجتمعات في بوتقة وطنية واحدة، وفي موازاتها خمود التمايزات الطائفية والأقوامية التقليدية. هكذا صار بناء الأمة أو الدولة الأمة دليلا على مشروع التحرر من الماضي العبودي والتمييزي، وأداة تحقيقه في الوقت نفسه، كما صارت قواعد عملها، وتنظيم الحياة السياسية والقانونية بين أفرادها، على أساس المواطنة الحرة والمتساوية، مصدر الشرعية للحكومات الديمقراطية، والأساس الفلسفي الذي قامت عليه فكرة تنظيم العالم في إطار منظمة أو منظومة واحدة، هي الأمم المتحدة، التي ساوت بين جميعها.
لكن، منذ الثمانينيات، وبموازاة إطلاق سياسات العولمة، ومتطلباتها الاستراتيجية والاقتصادية، دخلت البشرية في سياسةٍ عالميةٍ جديدةٍ قامت بالأساس على إلغاء الانتظامات والالتزامات والعقود أو العهود والمواثيق الوطنية والدولية القديمة، وأحلت محلها تدريجياً عهداً أو ميثاقاً جديداً يستند إلى إطلاق ديناميكيات السوق وتنشيط التجارة العالمية، وإضعاف سلطة الرقابة على قوى الرأسمالية ورفع الحماية التقليدية عن الأسواق وعن قوة العمل معاً، وإقامة سوق عالمية واحدة، بهدف توسيع دائرة التفاعل بين الاقتصادات الوطنية وإعطاء زخم أكبر للاستثمار الرأسمالي، وهذا ما فجر ثورة الاتصالات والمعلومات التي أصبحت أداتها ومحركها.
لكن العولمة التي وحّدت مصائر المجتمعات بالفعل بمقدار ما أدرجتها جميعاً في حركة سوق عالمية واحدة، وأعادت هيكلة اقتصاداتها وتبعيتها المتبادلة، افتقرت كلياً لعهد أو ميثاق إنساني جديد، يحدد معايير سلوك القوى الكبرى الناشئة في الاقتصاد، وفي الميدان الجيوستراتيجي والثقافي، والقيم الأساسية التي تحدّد حقوق الأفراد الأساسية عبر حدود الدول والأسواق، وتوجههم وتضمن تعاونهم. ولذلك، بدل أن تعزّز العولمة الشعور بوحدة المصير العالمي الذي دفعت إليه في الواقع، عملت، بالعكس، في غياب هذا العهد، على زعزعة استقرار الدول وتعميق الهوة بين شعوبها، ودفعت إلى تفكيك المجتمعات، وتشجيع الجماعات المحلية والعرقية والمذهبية على الانفصال والانشقاق وإعادة موضعة نفسها، من وراء الحدود السياسية والأوطان، في محيط العولمة وتفاعلاتها المتزايدة والمتنافرة. وبمقدار ما دمرت ديناميكيات العولمة النيوليبرالية الوطنيات القائمة، وأضعفت المشاعر التضامنية المرتبطة بها، ألغت أو كادت الشعور بوجود مصير وطني وإنساني مشترك، وولّدت نزوعاً قلقاً وشاملاً عند الأفراد والجماعات إلى البحث عن المصير الخاص بها في فضاء لا يزال لم يستقر بعد..
تتجاوز المشكلة، إذن، الحدود القومية والهويات الدينية والمذهبية، وتتلخص، ببساطة، في أن
العولمة، في وقتٍ وحدت فيه المصائر العالمية، لم تطور في مواكبتها ثقافة عالمية، أي معايير وقيم وغايات تجعل الأفراد في العالم الموحد يشعرون بوحدة المصير الفعلية، ويدركون أن أي كارثة طبيعية أو بشرية، تحصل في أي مكان، تؤثر على مصير الإنسانية، وتعني كل أفرادها. وفي غياب هذه الثقافة، فتحت العولمة العالم على الفوضى بمقدار ما حطمت في سيرها العهود الوطنية، أو أفرغتها من محتواها، وكانت الحصيلة عالماً يزخر بالتوترات والتناقضات وعدم الاستقرار والأمن، وجرى الجميع وراء سراب التطلعات والأحلام المتنافرة والمتضاربة.
لا يرجع هذا الضياع الكبير الذي نعيش إلى العولمة بحد ذاتها، وإنما إلى أصحاب المصالح الكبرى الذين كانوا وراءها والمستفيدين الوحيدين منها، فلم يكن في مصلحة هؤلاء تأطيرها أخلاقياً وسياسياً، حتى يضمنوا لأنفسهم السيطرة الكاملة على ديناميكياتها، ويتحرّروا من ضغط الشعوب المتضرّرة التي استبيحت فضاءاتها، وووضعت في خدمة السوق الجديدة مواردها البشرية والمادية. أرادوا بالعكس أن تكون العولمة سياسةً وقسمة ضيزى، يستفيد منها الأقوياء ويخسر فيها الضعفاء، وهذا ما يفسر ما يرافق تقدمها من نمو ثقافة العنصرية والخوف من الآخر وكره الأجنبي في المجتمعات المتقدمة، وفي المقابل، العداء للغرب والاحتجاج عليه وعدم الثقة به، في العوالم المتأخرة والمتخلفة.
إحياء التضامن الإنساني العالمي
قتلت العولمة النيوليبرالية أي شعور بوجود قضية مشتركة بين البشر، وسعّرت، في المقابل، الشعور بالتنافس والتزاحم والعداء، وقضت على إمكانية ظهور حركات تضامن في المركز مع شعوب المحيط الملحق والمفكّك، كما قتلت إمكانية تضامن شعوب المحيط في ما بينها، بمقدار ما قضت على مشروعاتها الوطنية التي كانت توحد برامج عملها وتطلعات شعوبها، وقدّمت النزاع في ما بين جماعاتها الأهلية ونخبها، المذهبية والطائفية والسياسية والثقافية، على الالتحاق بالمركز، على التعاون والتضامن لبناء دول وطنية متضامنة ومتكافلة. وفي النهاية، بتقويضها وجود الدولة الوطنية، قوضت العولمة أيضا عهداً قائماً للتعارف والتعايش والتواصل والتضامن بين النخب والشعوب والمجتمعات، وتركت الإنسانية من دون معايير ولا قيم، ولا مشروع إنساني مشترك، وبالتالي من دون أي إمكانية للتواصل في ما بينها، على الرغم من توحيد مصائرها وتماثل شروط وجودها. ما نعيشه اليوم على مستوى العالم، وداخل الدول، الغنية والفقيرة، المركزية والمحيطية، هو ضياع كامل، وغياب لأي قضية مشتركة، فليس للعهد النيوليبرالي القائم اليوم مضمون آخر سوى تقديس المصالح الخاصة، وتعظيم المنافع، من دون مراعاةٍ لأي قواعد ومعايير سوى معايير المنفعة وقيم الأنانية وأخلاقها. هذا التفكيك لكل ما هو مشترك في العالم، من قيم ومبادئ وتطلعات، هو أيضاً قتل للضمير العالمي وإلغاء لمعنى الإنسانية.
لا يعني هذا أنه لم يبق لنا ما نفعله اليوم. بالعكس، لم تكن الحاجة للتضامن بين الشعوب
والجماعات ملحةً كما هي عليه اليوم، تماماً كما لم تكن المصائر العالمية مترابطةً مثل ما هي اليوم، ولا القضايا المطروحة على الشعوب والمجتمعات عالمية بامتياز كما أصبحت اليوم، سواء ما تعلق منها بقضية الأمن، وبالتالي الحرب والسلام، أو قضية الفقر، أو قضية البيئة، أو قضية الهجرة واللجوء وتنقل الأفراد عبر الحدود، أو قضية الإنسان كإنسان، وما تعنيه من ضمان الكرامة والحرية والعدل للجميع. لكن، كما هو الحال في أي مخاض، ونحن نعيش على مستوى المعمورة مرحلة مخاض، تقود الأزمة الفكرية والسلوكية، أي ما يتعلق بالفعل والممارسة، وما يرافقها من حيرة وتردّد وتخبط نعيشه اليوم بشكل واضح في كل ما يتعلق بالعلاقات داخل الدول وبين المجتمعات، إلى إعادة صياغة للقضية المشتركة واكتشاف آليات ووسائل جديدة للفعل.
لن يكون هناك أمل في إحياء التضامن بين الشعوب والمجتمعات، من دون إحياء ديناميكيات الكفاح المشترك ضد القهر والظلم والإجحاف والغدر الذي ينتجه ويعيش عليه نظام العصر الهمجي الجديد. وإذا لم يكن في مقدرتنا عبور المسافة التي تفصلنا عن ولادة عالم جديد، وعهد عالمي جديد، بمفردنا، وحسب رغبتنا، فنحن نستطيع، منذ الآن، بتضامننا مع من يسعى مثلنا إلى مقاومة مخاطر الانجراف والفوضى وموت الضمير والإنسان، أن نجعل من إحياء قيم التضامن الإنسانية العالمية قضيتنا الإنسانية المشتركة، وفي صلبها تحويل محنة السوريين التي، بمقدار ما تعبّر عن موت الإنسان والضمير، تشكل أحد أهم روافع العمل من أجل إعادة بناء أخلاقيات العصر القادم الذي نريد.
في سبب انعدام التضامن
ما من شك في أن قصور السوريين وتقصيرهم، وانقسامات معارضاتهم، وتضارب خياراتهم، أضعف تعاطف العالم معهم. وما من شك أيضا في أن دخول التنظيمات الجهادية على الخط زاد في تشويش صورة كفاحهم البطولي والعادل من أجل الحرية، وضد نظام القهر والطغيان، وأن الطابع الإسلامي الذي آلت إليه قوى الثورة المسلحة السورية نفّر جزءاً كبيراً من العالم أو أخافه. ومع ذلك، لا يفسر هذان العاملان السقوط الأخلاقي والسياسي للرأي العام العالمي أمام محنة السوريين ومعاناتهم، فلا يمنع ضعف المعارضة الرأي العام من معرفة حقيقة ما يجري والظلم الواقع على السوريين بالفعل. ولم يصبح الطابع الإسلامي غالباً على قوى الثورة، إلا بسبب تنكر العالم لها، وترك شبابها لأشهر طويلة، يواجهون العنف المتوحش بصدروهم العارية، من دون دعم ولا اعتراف ولا عون، فمن اليأس من العالم وفقدان الأمل بتضامنه ولد شعار "ما لنا غيرك يا الله"، ولا يزال الشعار الأكثر تجسيداً لواقع الحال. كان الأولى أن يزيد ضعف المعارضة وقصورها، والخوف من سعي الأيديولوجيات الجهادية إلى ملء الفراغ الذي أنتجه تقاعس المجتمع الدولي، من تأييد الرأي العام العالمي لثورة السوريين الديمقراطيين، والتعاطف مع تضحياتهم ومد يد المساعدة لهم، وهذا ما كنا ننتظره، وندعو إليه باستمرار خلال أشهر طويلة قبل فوات الأوان، بل لم يكن لدخول الجهاديين والسلفيين على الخط أن يدفع إلى خلط الأوراق والتنكر للقضية السورية التحررية، إلا لوجود رغبة مسبقة في التهرّب من المسؤوليات الأخلاقية والسياسية واستخدام هذا الدخول ذريعةً لتبرير التنكر لواجب التضامن الإنساني، وهذا ما حصل بالضبط.
وعلى جميع الأحوال، لا يمكن لهذه العوامل نفسها أن تفسّر انعدام التضامن الملحوظ، حتى في بلدان العالم العربي والإسلامي الذي لا تشغله مخاوف الغرب ولا حساسياته، فلم يشهد هذا
قد يكون السبب هنا أيضاً غياب الثقافة التضامنية، بعد عقود طويلة من شل المجتمعات، والقضاء على استقلالها الفكري والعملي تجاه السلطة، وتعقيمها سياسياً وأخلاقياً، لتحييدها حتى في ما يتعلق بتضامن أبنائها في ما بينهم. هذا صحيح في بعض الحالات فقط، لكنه لا يكفي لتفسير حالة انعدام الحركة، في مواقع ومناطق إسلامية لا يحمل التعبير فيها عن التضامن أي مخاطر أو أثمان صعبة الاحتمال.
من الواضح أن الأمر لا يتعلق فقط بمحنة السوريين، وإنما بحالةٍ عامةٍ تنطبق على جميع القضايا المشابهة. ونحن أنفسنا لم نقم بأي تظاهرة للتعبير عن غضبنا أو تضامننا مع مجازر رواندا أو البوسنة من قبل. المآل الذي آلت إليه أوضاعنا، نحن السوريين، جزء من المآل الذي آلت إليه الإنسانية التي ننتمي إليها في هذا القرن الواحد والعشرين، الحامل لانقلابات أعمق بكثير مما شهدته أجيال القرن الماضي، بمقدار ما هو عصر التحولات الكبرى والطويلة المدى.
عولمة الأسواق والإغلاق على الثقافات
حتى نلتقط بعض العناصر التي تساعد على فهم غياب التضامن بين الناس داخل المجتمعات وبين الشعوب، وما إذا كان لا يزال من الممكن إحياء الضمير العالمي، من المفيد العودة إلى العقود الثلاثة، وربما الأربعة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية. سنلاحظ عندئذ، بالعكس، أن التضامن كان الظاهرة الأبرز، وشكل عاملاً أساسياً في الدفع نحو تحولات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، على مستوى المعمورة. ولعل أفضل مثال على ذلك التضامن العالمي في قضية التحرر من الاستعمار التي تجلى فيها تضامن الشعوب المستعمَرة، بالفتح، على أوسع نطاق في ما بينها، لكن أيضا حصول تظاهرات تضامنٍ لا تقل أهميةً مع القضية ذاتها داخل الدول الاستعمارية، شارك فيها مثقفون وسياسيون وجمهور واسع من الناس العاديين. وحصل ما يشبه ذلك في فترة انتشار العقيدة اليسارية والثورة الاجتماعية والاشتراكية، حتى اتخذت سمة الأممية واسمها. وهناك مثال آخر أقرب إلينا هو ما شهدته البلدان العربية في ما أطلقنا عليه اسم الحقبة القومية، والناصرية بشكل خاص، حيث كان التفاعل على درجة كبيرة بين القوى السياسية والشعبية على امتداد الدائرة العربية. وفي السياق ذاته، يمكننا الإشارة إلى قوة التضامن الذي لا نزال نشاهده اليوم بين الحركات النسوية، أو بين حركات البيئة التي تتخذ بعداً عالمياً حقيقياً.
نلاحظ في كل تلك الأمثلة أمرين: وجود قضية مشتركة، وأمل كبير بعدالتها وانتصارها.
لكن، منذ الثمانينيات، وبموازاة إطلاق سياسات العولمة، ومتطلباتها الاستراتيجية والاقتصادية، دخلت البشرية في سياسةٍ عالميةٍ جديدةٍ قامت بالأساس على إلغاء الانتظامات والالتزامات والعقود أو العهود والمواثيق الوطنية والدولية القديمة، وأحلت محلها تدريجياً عهداً أو ميثاقاً جديداً يستند إلى إطلاق ديناميكيات السوق وتنشيط التجارة العالمية، وإضعاف سلطة الرقابة على قوى الرأسمالية ورفع الحماية التقليدية عن الأسواق وعن قوة العمل معاً، وإقامة سوق عالمية واحدة، بهدف توسيع دائرة التفاعل بين الاقتصادات الوطنية وإعطاء زخم أكبر للاستثمار الرأسمالي، وهذا ما فجر ثورة الاتصالات والمعلومات التي أصبحت أداتها ومحركها.
لكن العولمة التي وحّدت مصائر المجتمعات بالفعل بمقدار ما أدرجتها جميعاً في حركة سوق عالمية واحدة، وأعادت هيكلة اقتصاداتها وتبعيتها المتبادلة، افتقرت كلياً لعهد أو ميثاق إنساني جديد، يحدد معايير سلوك القوى الكبرى الناشئة في الاقتصاد، وفي الميدان الجيوستراتيجي والثقافي، والقيم الأساسية التي تحدّد حقوق الأفراد الأساسية عبر حدود الدول والأسواق، وتوجههم وتضمن تعاونهم. ولذلك، بدل أن تعزّز العولمة الشعور بوحدة المصير العالمي الذي دفعت إليه في الواقع، عملت، بالعكس، في غياب هذا العهد، على زعزعة استقرار الدول وتعميق الهوة بين شعوبها، ودفعت إلى تفكيك المجتمعات، وتشجيع الجماعات المحلية والعرقية والمذهبية على الانفصال والانشقاق وإعادة موضعة نفسها، من وراء الحدود السياسية والأوطان، في محيط العولمة وتفاعلاتها المتزايدة والمتنافرة. وبمقدار ما دمرت ديناميكيات العولمة النيوليبرالية الوطنيات القائمة، وأضعفت المشاعر التضامنية المرتبطة بها، ألغت أو كادت الشعور بوجود مصير وطني وإنساني مشترك، وولّدت نزوعاً قلقاً وشاملاً عند الأفراد والجماعات إلى البحث عن المصير الخاص بها في فضاء لا يزال لم يستقر بعد..
تتجاوز المشكلة، إذن، الحدود القومية والهويات الدينية والمذهبية، وتتلخص، ببساطة، في أن
لا يرجع هذا الضياع الكبير الذي نعيش إلى العولمة بحد ذاتها، وإنما إلى أصحاب المصالح الكبرى الذين كانوا وراءها والمستفيدين الوحيدين منها، فلم يكن في مصلحة هؤلاء تأطيرها أخلاقياً وسياسياً، حتى يضمنوا لأنفسهم السيطرة الكاملة على ديناميكياتها، ويتحرّروا من ضغط الشعوب المتضرّرة التي استبيحت فضاءاتها، وووضعت في خدمة السوق الجديدة مواردها البشرية والمادية. أرادوا بالعكس أن تكون العولمة سياسةً وقسمة ضيزى، يستفيد منها الأقوياء ويخسر فيها الضعفاء، وهذا ما يفسر ما يرافق تقدمها من نمو ثقافة العنصرية والخوف من الآخر وكره الأجنبي في المجتمعات المتقدمة، وفي المقابل، العداء للغرب والاحتجاج عليه وعدم الثقة به، في العوالم المتأخرة والمتخلفة.
إحياء التضامن الإنساني العالمي
قتلت العولمة النيوليبرالية أي شعور بوجود قضية مشتركة بين البشر، وسعّرت، في المقابل، الشعور بالتنافس والتزاحم والعداء، وقضت على إمكانية ظهور حركات تضامن في المركز مع شعوب المحيط الملحق والمفكّك، كما قتلت إمكانية تضامن شعوب المحيط في ما بينها، بمقدار ما قضت على مشروعاتها الوطنية التي كانت توحد برامج عملها وتطلعات شعوبها، وقدّمت النزاع في ما بين جماعاتها الأهلية ونخبها، المذهبية والطائفية والسياسية والثقافية، على الالتحاق بالمركز، على التعاون والتضامن لبناء دول وطنية متضامنة ومتكافلة. وفي النهاية، بتقويضها وجود الدولة الوطنية، قوضت العولمة أيضا عهداً قائماً للتعارف والتعايش والتواصل والتضامن بين النخب والشعوب والمجتمعات، وتركت الإنسانية من دون معايير ولا قيم، ولا مشروع إنساني مشترك، وبالتالي من دون أي إمكانية للتواصل في ما بينها، على الرغم من توحيد مصائرها وتماثل شروط وجودها. ما نعيشه اليوم على مستوى العالم، وداخل الدول، الغنية والفقيرة، المركزية والمحيطية، هو ضياع كامل، وغياب لأي قضية مشتركة، فليس للعهد النيوليبرالي القائم اليوم مضمون آخر سوى تقديس المصالح الخاصة، وتعظيم المنافع، من دون مراعاةٍ لأي قواعد ومعايير سوى معايير المنفعة وقيم الأنانية وأخلاقها. هذا التفكيك لكل ما هو مشترك في العالم، من قيم ومبادئ وتطلعات، هو أيضاً قتل للضمير العالمي وإلغاء لمعنى الإنسانية.
لا يعني هذا أنه لم يبق لنا ما نفعله اليوم. بالعكس، لم تكن الحاجة للتضامن بين الشعوب
لن يكون هناك أمل في إحياء التضامن بين الشعوب والمجتمعات، من دون إحياء ديناميكيات الكفاح المشترك ضد القهر والظلم والإجحاف والغدر الذي ينتجه ويعيش عليه نظام العصر الهمجي الجديد. وإذا لم يكن في مقدرتنا عبور المسافة التي تفصلنا عن ولادة عالم جديد، وعهد عالمي جديد، بمفردنا، وحسب رغبتنا، فنحن نستطيع، منذ الآن، بتضامننا مع من يسعى مثلنا إلى مقاومة مخاطر الانجراف والفوضى وموت الضمير والإنسان، أن نجعل من إحياء قيم التضامن الإنسانية العالمية قضيتنا الإنسانية المشتركة، وفي صلبها تحويل محنة السوريين التي، بمقدار ما تعبّر عن موت الإنسان والضمير، تشكل أحد أهم روافع العمل من أجل إعادة بناء أخلاقيات العصر القادم الذي نريد.