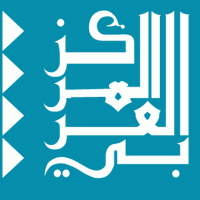24 أكتوبر 2024
العراق ... سياسات المالكي وحساباته الخاطئة أم أنها "داعش"؟
عراقيون ينزحون من الموصل مع اشتداد المواجهات (Getty)
طرح الانهيار السريع لقوات الجيش والشرطة العراقية في الموصل، وفرارها من مواجهة المسلحين، سيناريوهات عديدة، في محاولة الاقتراب من تفهم الحدث وتفسيره، تراوحت بين ثلاث قراءات: تآمريةٍ، نظرت إلى الحدث، بوصفه خطة محكمة يديرها رئيس الحكومة، نوري المالكي، لضمان ولاية ثالثة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية وإيران. وتهويلية، تضع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في المركز، بوصفه قوة إرهابية صاعدة. وتهوينية، نظرت إلى الحدث كمحصلة طبيعية لحركة الاحتجاجات الشعبية في المحافظات السنيّة. ولا ترى هذه الورقة أنّ أيًا من هذه القراءات تفسّر ما حصل في العراق في الأيام القليلة الماضية.
المالكي والولايات المتحدة: حدود المؤامرة
يستند سيناريو المؤامرة إلى الاعتقاد بأنّ المالكي يسعى إلى ضمان ولاية ثالثة، بفرض حالة الطوارئ، بسبب استعصاء الحل السياسي، عقب الفوز الهزيل لائتلافه في الانتخابات التي جرت في 17 إبريل/نيسان 2014، مع تصاعد عمليات العنف في البلاد. فعقب الهجوم على الموصل، فجر الثلاثاء 10 يونيو/ حزيران 2014، وإعلان محافظ نينوى، أثيل النجيفي، سقوط الموصل في قبضة "داعش"، طالب المالكي البرلمان "إعلان حالة الطوارئ في البلاد"، بحسب قانون الطوارئ العراقي، الصادر في عام 2010، ما يسمح للمالكي بتجميد العمل بالدستور والقانون، وفرض الأحكام العرفية في البلاد، بذريعة استعادة السيطرة الأمنية.
وقد عزّز فرضية التواطؤ لدى بعضهم، اتهام رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، حكومة المالكي، بعدم تجاوبها مع نداءات حكومته، قبل يومين من سقوط الموصل، للتنسيق، بهدف توفير الحماية للمدينة. وفي هذه الأثناء، استذكر بعضهم تصريحات سابقة لوزير العدل العراقي، حسن الشمري، عندما ذكر أنّ هروب مئات المعتقلين من سجني أبو غريب والتاجي في 29 يوليو/ تموز 2013، ومعظمهم ينتمون إلى تنظيم "القاعدة"، كان مدبرًا بمعرفة مسؤولين عراقيين كبار، بهدف إقناع واشنطن التخلي عن خططها لضرب نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، عبر تعظيم دور "القاعدة" و"داعش". ويستند أنصار نظرية المؤامرة، أيضًا، إلى أنّ المالكي لا يزال خيارًا أميركيًا وإيرانيًا مفضلًا في عراق ما بعد الاحتلال التابع لإيران، والذي بات فيه المكون العربي السني مهمشًا ومعزولًا، ويعامل بوصفه أقلية.
يقوم الإطار الجامع بين الولايات المتحدة والمالكي على تبني سياسات "الحرب على الإرهاب"، وفق مقاربة عسكرية أمنيةٍ، تتعامل مع نتائج منظومة الفساد والاستبداد ومخرجاتها وغياب الشفافية والعدالة، من دون أن تلتفت إلى الأسباب والشروط الموضوعية، المنتجة ظاهرة التطرّف العنيف التي توصم بـ "الإرهاب". فقد استخدم المالكي "قانون الإرهاب"، للتخلص من معارضيه وخصومه السياسيين، وتدعيم سلطته الدكتاتورية، واستثمر "قانون المساءلة والعدالة" الذي حل مكان قانون "اجتثاث البعث"، في تهميش سياسيين بارزين من السنة، واستبعادهم، بحجة وجود ارتباطات مزعومة لهم بمراتب عليا في حزب البعث السابق.
وقد تغاضت الولايات المتحدة عن عمليات التهميش والإقصاء الطائفي التي مارسها المالكي، تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب"؛ لضمان مصالحها، بتأمين "الاستقرار". وعقب انطلاق الثورة السورية، في منتصف مارس/ آذار 2011، وبروز الجماعات الجهادية السنية، وتصاعد نفوذ تنظيم القاعدة، باتت مسألة محاربة الإرهاب تهيمن على مجمل الرؤى والتصورات، الأمر الذي دفع المالكي إلى التمادي في سياساته الرعناء، في التعامل مع الحركة الاحتجاجية السنيّه السلمية نهاية عام 2012. ولقد اتخذ قرارًا حازمًا بعدم الاستجابة، ولو جزئيًا، لمطالب الاعتصامات السلمية، والعمل على فضها بالقوة. ووصل في ذلك إلى حد قتل 50 محتجً سلميًا، وجرح أكثر من 110 محتجين في مدينة الحويجة في محافظة كركوك في 23 إبريل/نيسان 2013. وقبل أحداث الحويجة، اصطدمت قوات الأمن بالمتظاهرين في مناسبتين، في الفلوجة في 25 يناير/ كانون ثاني، وفي الموصل في 8 مارس/ آذار 2014، ما أدى إلى مصرع سبعة أشخاص في الحادثة الأولى، وشخص في الثانية. وتعامل المالكي مع هذه الحوادث باستخفاف، بوصفها تمردًا يقوده "الصداميون والبعثيون والإرهابيون". ولجأ إلى تكتيكات أكثر خطورة، في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، بادعاء أنّ المتظاهرين ترعاهم تركيا ودول الخليج، والإصرار على أنّ بينهم إرهابيين ينتمون إلى حزب البعث السابق، أو أنهم مدفوعون بالعداء الطائفي للشيعة. وأدى ذلك إلى تحويل الطائفة الشيعية نحو قدر أكبر من الراديكالية، الأمر الذي بلور اقتناعاً لدى المحتجين بعدم جدوى النضال السلمي، وهو ما استثمره تنظيم "داعش"، عبر توسيع دائرة التجنيد وتكثيف نطاق عملياته المسلحة.
وقد حذر قادة العشائر العربية المالكي من مغبة محاولة إعادة احتلال الأنبار، لكنه لم يستمع لهم، وبدا أنّ السياسي المقبول لديه هو الذي يقبل بهيمنة "الشيعية السياسية"، ويعمل في خدمتها. وقد عبر العرب السنة بأشكال مختلفة عن يأسهم من العملية السياسية، ومن عجز ممثليهم الذين شاركوا فيها، والذين فقدوا قواعدهم الشعبية.
وعلى الرغم من سياسات المالكي الطائفية، وافقت الولايات المتحدة في زيارته واشنطن، مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، على بيع حكومته كميات كبيرة من الأسلحة المتطوّرة، بما فيها طائرات الاستطلاع وصواريخ هلفاير، بذريعة محاربة "الإرهاب"، وعدم السماح بانتقال الفوضى إلى الدول المجاورة. كما تتفاوض واشنطن مع بغداد على تدريب قوات خاصة مشتركة، وتعمل على تأسيس قواعد لطائرات من دون طيار، بحجة التصدي لتنظيم "القاعدة".
ومع تحول الاحتجاجات السلمية إلى مسلحة، بدأت في الرمادي ثم توجت بالسيطرة على الفلوجة، جرى تأسيس مجالس عسكرية للعشائر والسكان عمومًا. وقد تعامل المالكي معها بوصفها إرهابًا، تقوده القاعدة و"داعش"، وساندته في هذا الولايات المتحدة، ثم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعرب في 11 يناير/ كانون ثاني2014 عن دعمه جهد الحكومة العراقية، في الأنبار، ضد ما أسماه العنف والإرهاب، ودان هجمات "داعش" من دون الإشارة إلى الفاعلين الشعبيين الآخرين، ولا إلى المطالب العادلة لأهالي هذه المناطق.
"داعش" بوصفها قوة صاعدة
تستند القراءة التهويلية إلى الاعتقاد بأنّ انسحاب القوات الأميركية عام 2011 من العراق، والذي تزامن مع بدء فعاليات حركات الاحتجاج الثوري في العالم العربي، ودخوله إلى سورية منتصف مارس/ آذار، ثم وصوله إلى العراق نهاية 2012، عمل على ولادةٍ ثالثةٍ لتنظيم القاعدة، وبعث الحياة في جسد تنظيم "داعش"، وتكوين سلالة جديدة أكثر عنفًا وأشد فتكًا. فقد استثمرت "داعش" الظروف الموضوعية التي تمثلت بالثورة السورية، والحركة الاحتجاجية التي شهدتها المحافظات العراقية السنية الأربع المنتفضة؛ الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين، وأجزاء عدة من بغداد وكركوك.
وترتبط ولادة "داعش" بتمرد الفرع العراقي للقاعدة على القيادة المركزية لتنظيم القاعدة، بزعامة أيمن الظواهري؛ فقد أبرزت الثورة السورية التي ولدت من رحم "الربيع العربي" خلافات أيديولوجية وتنظيمية تاريخية بين القاعدة المركزية وفروعها الإقليمية. وجاء إعلان أبو بكر البغدادي، أمير "الدولة الإسلامية في العراق" في 9 إبريل/نيسان 2013 عن ضم "جبهة النصرة" في سورية إلى دولته، لتصبح "الدولة الإسلامية في العراق والشام" تتويجًا حتميًا للخلافات التاريخية بين الفرع والمركز، والتي تم احتواؤها إبان زعامة أسامة بن لادن. وقد تطور الخلاف، بعد أن أصدر زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، في اليوم التالي لإعلان الدمج في 10 إبريل/ نيسان، بيانًا يرفض فيه الامتثال للدمج والانضمام لـتنظيم "داعش"، وأعلن عن ارتباطه بالتنظيم المركزي للقاعدة، وتأكيد بيعته الصريحة للظواهري. ولم يفلح جهد الأخير في احتواء الخلاف، حين أصدر قراره تحديد الولاية المكانية للفرعين، في 9 يونيو/ حزيران 2013، والفصل ببطلان الدمج وحل "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، مع بقاء "جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية في العراق" فرعين منفصلين، يتبعان تنظيم القاعدة.
وتدرّج الخلاف بين الفرع العراقي للقاعدة والتنظيم المركزي، منذ بيعة "أبو مصعب الزرقاوي" لأسامة بن لادن، وصولًا إلى "إعلان الدولة"؛ فأجندة القاعدة تهدف منذ الإعلان عن تأسيس "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" عام 1998 إلى قتال الغرب عمومًا، والولايات المتحدة خصوصًا، باعتبارها حامية للأنظمة العربية الاستبدادية، وراعية لحليفتها الإستراتيجية إسرائيل من جهة، والسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة الخلافة، من جهة أخرى. ومواجهة الغرب ورفع الهيمنة الخارجية، والتصدي للاستبداد وتمكين الشريعة داخليًا، هما ركنا القاعدة الأساسيان.
أما أجندة "داعش" فتقوم على أولوية مواجهة النفوذ والتوسع الإيراني في المنطقة، ومحاربة "المشروع الصفوي" كما تصفه، خصوصًا بعد رحيل القوات الأميركية عن العراق؛ فالأساس الهوياتي (السني – الشيعي) هو المحرّك الرئيس لسلوك الفرع العراقي، بينما الأساس المصلحي الجيوسياسي هو المحرّك الرئيس للقيادة المركزية للقاعدة. أما تمكين الشريعة فهو الهدف المشترك للطرفين، إلا أنّ توقيت الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية في العراق فجّر خلافاتٍ، جرى تجاوزها آنذاك، نظرًا للظروف الموضوعية والأسباب العملية. وساهم وجود بن لادن على رأس التنظيم، بما يمتلكه من كاريزما في تدبير الاختلاف والتعايش الحذر، على الرغم من انتقاداتٍ لم تنقطع لنهج الفرع العراقي، وممارساته المتعلقة بتكتيكاته القتالية، عبر التوسع في استخدام العمليات الانتحارية، وتحديد دائرة الاستهداف.
وعلى الرغم من انضمام الفرع العراقي لتنظيم القاعدة المركزي، ومبايعة بن لادن، فإنّ المؤسس الأول للتنظيم العراقي، أبو مصعب الزرقاوي، (أحمد فضيل الخلايلة) عمل على تأسيس شبكته الممتدة الخاصة المستقلة، بدءًا من الأردن وتنظيم "بيعة الإمام"، مرورًا بأفغانستان وإنشاء "معسكر هيرات"، وختامًا في العراق. فقد عمل على توسيع دائرة نفوذه وتأثيره، عقب احتلال الولايات المتحدة الأميركية العراق عام 2003، وأعلن عن تأسيس جماعة "التوحيد والجهاد" في سبتمبر/ أيلول 2003، كما أعلن عن تأسيس "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"، عقب بيعة بن لادن في 8 أكتوبر/ تشرين أول 2004.
بعد مقتل الزرقاوي في 7 يونيو/ حزيران 2006، أعلن عن تأسيس "الدولة الإسلامية في العراق" في 15 أكتوبر/ تشرين أول 2006 بزعامة أبو عمر البغدادي (حامد داود الزاوي)، وعقب مقتله، في 19 إبريل/نيسان 2010، إلى جانب وزير حربه، أبو حمزة المهاجر، تولى الإمارة أبو بكر البغدادي ("أبو دعاء" إبراهيم عواد البدري) في 16 مايو/ أيار 2010، وهي الحقبة التي شهدت تحولًا في البنية التنظيمية للفرع العراقي، بعد سيطرة عسكريين عملوا في المؤسسة العسكرية، في عهد صدام حسين، منهم العميد الركن محمد الندى الجبوري المعروف بـ "الراعي"، والذي استلم قيادة أركان الدولة بتكليف من المهاجر؛ وهو الذي وضع العميد الركن سمير عبد محمد المعروف بـ "حجي بكر" نائبًا له، والذي أصبح بعد أشهر قائدًا لأركان الدولة، بعد مقتل الراعي.
سيطرت "داعش" على مساحات شاسعة في غرب العراق، وخصوصًا في محافظة الأنبار، وكذلك في شرق سورية، وخصوصاً محافظة الرقة. ولم يعد التنظيم يحفل برضا القاعدة والجماعات الإسلامية المسلحة؛ إذ يتعامل معها بالقوة المميتة، بوصفها جماعات مرتدة وصحوات، وخصوصًا عقب الصدام المسلح المفتوح منذ انفجاره، في 3 يناير/ كانون ثاني 2014، مع الفصائل الإسلامية المسلحة، وفي مقدمتها جبهة النصرة، وجيش المجاهدين، والجبهة الإسلامية، وجبهة ثوار سورية، فضلًا عن تشكيلات الجيش الحر وقوى المجتمع المحلي.
يبلغ عدد أعضاء التنظيم نحو 15 ألف مقاتل؛ وهو يستقطب النسبة الكبرى من المقاتلين الأجانب، ويتوفر على موارد مالية كبيرة، تعتمد على فرض الإتاوات في مناطق نفوذه في العراق، وعلى التبرعات التي تأتيه من شبكة منظمة في دول عديدة. وقد شهدت موارده نموًا كبيرًا، عقب دخوله سورية، من خلال سيطرته على موارد رئيسة، تركّز معظمها في المنطقة الشرقية، مثل النفط، إذ استولى التنظيم على عدة حقول للنفط والغاز في الرقة والحسكة ودير الزور، وعلى قطاع الزراعة، حينما استولى على صوامع الحبوب في الحسكة، وهو يتحكم بإدارة المنتجات الزراعية واستثمارها. كما تعتبر الفدية من مصادر تمويله التقليدية، إذ اعتقل التنظيم سوريين وأجانب، وأفرج عنهم بعد أخذ فدية مالية.
على الرغم من قوة تنظيم "داعش" الذاتية، فإنّ قوتها الحقيقية موضوعية؛ فالمشكلات السياسية والاقتصادية في العراق وسورية توفر بيئات حاضنة للتطرف. كما وفرت الطبيعة السلطوية والطائفية لنظامي الأسد والمالكي، المدعومة من إيران، وانحراف طبائع الصراع إلى شكل هوياتي طائفي بين السنة والشيعة، بيئةً مثاليةً خصبةً للتعبئة، وجاذبيةً أيديولوجيةً للتنظيم.
المعارضة السنيّة: انبعاث الحركات المسلحة
تستند القراءة التهوينية في تفهم حدث سقوط الموصل، وانهيار المنظومة العسكرية والأمنية، إلى اعتباره محصلة طبيعية لحركة الاحتجاجات الشعبية في المحافظات السنيّة المنتفضة؛ إذ أدت سياسات المالكي الطائفية الفجة إلى فقدان السياسيين السنة الذين لم ينضموا لتلك الاحتجاجات صدقيتهم، وإلى تحوّل الحركة الاحتجاجية السلمية التي انطلقت مع نهاية عام 2012 إلى حركات مسلحة. فالسياسات الهوياتية الاستبدادية الفاسدة، والتي طبعت مسارات الدولة منذ بداية الاحتلال، عملت على إذلال المكون العربي السني، ولم تجلب محاولات العرب السنة للانخراط في العملية السياسية سوى مزيد من التهميش والشعور بالظلم والتمييز. وقد تنامت هذه المشاعر وتعززت، عقب اقتحام قوات المالكي خيم المعتصمين على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان ودمشق، ققد استخدم المالكي جميع الوسائل الممكنة، المغلّفة بالقانون والشرعية، لاستبعاد خصومه السياسيين، وترسيخ سلطته الفردية، من خلال توليه جميع الملفات الحيوية في الدولة. فبالإضافة إلى تولّيه منصب رئاسة الوزراء، يتولى المالكي المسؤولية عن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ويتحكم بتفسير جملة من القوانين وتطبيقها؛ بدءًا بقانون الإرهاب الذي بات سيفًا مصلتًا، يستخدمه للتخلص من معارضيه وخصومه السياسيين، وتدعيم سلطته الديكتاتورية، كما حدث مع نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، الذي بات ملاحقًا بتهمة الإرهاب، مرورًا بالتعامل مع وزير المال، رافع العيساوي، واعتقال حراسه ورئيس البرلمان، أسامه النجيفي، وبعض أتباعه، واعتقال النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه، وانتهاءً بقانون المساءلة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث البعث. ومن خلال القانون الأخير، تم تهميش سياسيين بارزين من السنة واستبعادهم، بحجة وجود ارتباطات مزعومة عليا بحزب البعث السابق. كما أنّ قوات المالكي كانت تنتشر، بشكل استفزازي، في سائر الأحياء السنيّة في بغداد، وفي المحافظات التي يقطنها السنة في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، وديالى.
بعد أن تفجّرت الأوضاع في الأنبار، وسيطرت قوات العشائر على الفلوجة والرمادي، تشكلت مجالس عسكرية مكونة من بعض أفراد الجيش العراقي السابق، وعناصر عشائرية مسلحة، ومن غيرهم من بقايا جماعات المقاومة العراقية، مثل "الجيش الاسلامي"، و"حماس العراق"، و"كتائب ثورة العشرين"، و"جيش المجاهدين"، و"أنصار السنّة". ولا يجوز تجاهل المكون الشعبي في الانتفاضة العراقية السلمية السابقة، والمسلحة الحالية.
خلاصة
تلامس القراءات الأحادية جانبًا من الحقيقة، لكنها تبقى خاطئة لهذا السبب بالذات. فالقراءة التعددية المركبة تؤكد على أنها تتكامل في رسم صورة أكثر دقة. تصرّ رواية نوري المالكي السلطوية، الطامحة بولاية ثالثة، على أنها تواجه تنظيم القاعدة، وبأنّ تنظيم "داعش" هو من يسيطر وحده على الأنبار والموصل، وبأنه يحارب الإرهاب الممتد من العراق إلى سورية. وهو بذلك يتماهى مع السياسات الأميركية المتعلقة بمحاربة "الإرهاب"، وتأمين "الاستقرار" لضمان مصالحها. ولا شك في أنّ سياسات المالكي الأمنية العنيفة، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في الوقت نفسه، دفعت القوى السنيّة السلمية المطالبة بالعدالة والديمقراطية والحرية ومحاربة الفساد والاستبداد إلى الاقتناع بعدم جدوى المطالبات السلمية، والانتقال إلى المقاومة العسكرية في صد الهجوم، الأمر الذي استثمره تنظيم "داعش" لتوسيع نفوذه وملء الفراغ، والدخول في تحالفات موضوعية، مضمرة مع القوى المسلحة السنيّة، في مواجهة عدو مشترك، يمثله الحلف المالكي -الأميركي.
لكن، السؤال الأهم: هل ستصمد التحالفات السابقة، أم أنها ستبدأ بالتفكك، والبحث عن بدائل أخرى، بعد تبيّن فشل المالكي؟ والسؤال الثاني: هل ستدرك القوى العربية السنية التي عانت الأمرّين، منذ الاحتلال، أنّ "داعش" هي، في النهاية، عبء حقيقي معاد للديمقراطية والمدنية، على حد سواء، في العراق كما في سورية؟ وقد تدرك، أيضًا، أنه لا بد من طرح المطالب العربية بصيغة ديمقراطية، وأنّ الموقف ضد الطائفية السياسية، يجب أن يكون ضد كل طائفية سياسية في العراق، وفي المشرق العربي عمومًا.
المالكي والولايات المتحدة: حدود المؤامرة
يستند سيناريو المؤامرة إلى الاعتقاد بأنّ المالكي يسعى إلى ضمان ولاية ثالثة، بفرض حالة الطوارئ، بسبب استعصاء الحل السياسي، عقب الفوز الهزيل لائتلافه في الانتخابات التي جرت في 17 إبريل/نيسان 2014، مع تصاعد عمليات العنف في البلاد. فعقب الهجوم على الموصل، فجر الثلاثاء 10 يونيو/ حزيران 2014، وإعلان محافظ نينوى، أثيل النجيفي، سقوط الموصل في قبضة "داعش"، طالب المالكي البرلمان "إعلان حالة الطوارئ في البلاد"، بحسب قانون الطوارئ العراقي، الصادر في عام 2010، ما يسمح للمالكي بتجميد العمل بالدستور والقانون، وفرض الأحكام العرفية في البلاد، بذريعة استعادة السيطرة الأمنية.
وقد عزّز فرضية التواطؤ لدى بعضهم، اتهام رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، حكومة المالكي، بعدم تجاوبها مع نداءات حكومته، قبل يومين من سقوط الموصل، للتنسيق، بهدف توفير الحماية للمدينة. وفي هذه الأثناء، استذكر بعضهم تصريحات سابقة لوزير العدل العراقي، حسن الشمري، عندما ذكر أنّ هروب مئات المعتقلين من سجني أبو غريب والتاجي في 29 يوليو/ تموز 2013، ومعظمهم ينتمون إلى تنظيم "القاعدة"، كان مدبرًا بمعرفة مسؤولين عراقيين كبار، بهدف إقناع واشنطن التخلي عن خططها لضرب نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، عبر تعظيم دور "القاعدة" و"داعش". ويستند أنصار نظرية المؤامرة، أيضًا، إلى أنّ المالكي لا يزال خيارًا أميركيًا وإيرانيًا مفضلًا في عراق ما بعد الاحتلال التابع لإيران، والذي بات فيه المكون العربي السني مهمشًا ومعزولًا، ويعامل بوصفه أقلية.
يقوم الإطار الجامع بين الولايات المتحدة والمالكي على تبني سياسات "الحرب على الإرهاب"، وفق مقاربة عسكرية أمنيةٍ، تتعامل مع نتائج منظومة الفساد والاستبداد ومخرجاتها وغياب الشفافية والعدالة، من دون أن تلتفت إلى الأسباب والشروط الموضوعية، المنتجة ظاهرة التطرّف العنيف التي توصم بـ "الإرهاب". فقد استخدم المالكي "قانون الإرهاب"، للتخلص من معارضيه وخصومه السياسيين، وتدعيم سلطته الدكتاتورية، واستثمر "قانون المساءلة والعدالة" الذي حل مكان قانون "اجتثاث البعث"، في تهميش سياسيين بارزين من السنة، واستبعادهم، بحجة وجود ارتباطات مزعومة لهم بمراتب عليا في حزب البعث السابق.
وقد تغاضت الولايات المتحدة عن عمليات التهميش والإقصاء الطائفي التي مارسها المالكي، تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب"؛ لضمان مصالحها، بتأمين "الاستقرار". وعقب انطلاق الثورة السورية، في منتصف مارس/ آذار 2011، وبروز الجماعات الجهادية السنية، وتصاعد نفوذ تنظيم القاعدة، باتت مسألة محاربة الإرهاب تهيمن على مجمل الرؤى والتصورات، الأمر الذي دفع المالكي إلى التمادي في سياساته الرعناء، في التعامل مع الحركة الاحتجاجية السنيّه السلمية نهاية عام 2012. ولقد اتخذ قرارًا حازمًا بعدم الاستجابة، ولو جزئيًا، لمطالب الاعتصامات السلمية، والعمل على فضها بالقوة. ووصل في ذلك إلى حد قتل 50 محتجً سلميًا، وجرح أكثر من 110 محتجين في مدينة الحويجة في محافظة كركوك في 23 إبريل/نيسان 2013. وقبل أحداث الحويجة، اصطدمت قوات الأمن بالمتظاهرين في مناسبتين، في الفلوجة في 25 يناير/ كانون ثاني، وفي الموصل في 8 مارس/ آذار 2014، ما أدى إلى مصرع سبعة أشخاص في الحادثة الأولى، وشخص في الثانية. وتعامل المالكي مع هذه الحوادث باستخفاف، بوصفها تمردًا يقوده "الصداميون والبعثيون والإرهابيون". ولجأ إلى تكتيكات أكثر خطورة، في التعامل مع الاحتجاجات السلمية، بادعاء أنّ المتظاهرين ترعاهم تركيا ودول الخليج، والإصرار على أنّ بينهم إرهابيين ينتمون إلى حزب البعث السابق، أو أنهم مدفوعون بالعداء الطائفي للشيعة. وأدى ذلك إلى تحويل الطائفة الشيعية نحو قدر أكبر من الراديكالية، الأمر الذي بلور اقتناعاً لدى المحتجين بعدم جدوى النضال السلمي، وهو ما استثمره تنظيم "داعش"، عبر توسيع دائرة التجنيد وتكثيف نطاق عملياته المسلحة.
وقد حذر قادة العشائر العربية المالكي من مغبة محاولة إعادة احتلال الأنبار، لكنه لم يستمع لهم، وبدا أنّ السياسي المقبول لديه هو الذي يقبل بهيمنة "الشيعية السياسية"، ويعمل في خدمتها. وقد عبر العرب السنة بأشكال مختلفة عن يأسهم من العملية السياسية، ومن عجز ممثليهم الذين شاركوا فيها، والذين فقدوا قواعدهم الشعبية.
وعلى الرغم من سياسات المالكي الطائفية، وافقت الولايات المتحدة في زيارته واشنطن، مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني 2013، على بيع حكومته كميات كبيرة من الأسلحة المتطوّرة، بما فيها طائرات الاستطلاع وصواريخ هلفاير، بذريعة محاربة "الإرهاب"، وعدم السماح بانتقال الفوضى إلى الدول المجاورة. كما تتفاوض واشنطن مع بغداد على تدريب قوات خاصة مشتركة، وتعمل على تأسيس قواعد لطائرات من دون طيار، بحجة التصدي لتنظيم "القاعدة".
ومع تحول الاحتجاجات السلمية إلى مسلحة، بدأت في الرمادي ثم توجت بالسيطرة على الفلوجة، جرى تأسيس مجالس عسكرية للعشائر والسكان عمومًا. وقد تعامل المالكي معها بوصفها إرهابًا، تقوده القاعدة و"داعش"، وساندته في هذا الولايات المتحدة، ثم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعرب في 11 يناير/ كانون ثاني2014 عن دعمه جهد الحكومة العراقية، في الأنبار، ضد ما أسماه العنف والإرهاب، ودان هجمات "داعش" من دون الإشارة إلى الفاعلين الشعبيين الآخرين، ولا إلى المطالب العادلة لأهالي هذه المناطق.
"داعش" بوصفها قوة صاعدة
تستند القراءة التهويلية إلى الاعتقاد بأنّ انسحاب القوات الأميركية عام 2011 من العراق، والذي تزامن مع بدء فعاليات حركات الاحتجاج الثوري في العالم العربي، ودخوله إلى سورية منتصف مارس/ آذار، ثم وصوله إلى العراق نهاية 2012، عمل على ولادةٍ ثالثةٍ لتنظيم القاعدة، وبعث الحياة في جسد تنظيم "داعش"، وتكوين سلالة جديدة أكثر عنفًا وأشد فتكًا. فقد استثمرت "داعش" الظروف الموضوعية التي تمثلت بالثورة السورية، والحركة الاحتجاجية التي شهدتها المحافظات العراقية السنية الأربع المنتفضة؛ الموصل والأنبار وديالى وصلاح الدين، وأجزاء عدة من بغداد وكركوك.
وترتبط ولادة "داعش" بتمرد الفرع العراقي للقاعدة على القيادة المركزية لتنظيم القاعدة، بزعامة أيمن الظواهري؛ فقد أبرزت الثورة السورية التي ولدت من رحم "الربيع العربي" خلافات أيديولوجية وتنظيمية تاريخية بين القاعدة المركزية وفروعها الإقليمية. وجاء إعلان أبو بكر البغدادي، أمير "الدولة الإسلامية في العراق" في 9 إبريل/نيسان 2013 عن ضم "جبهة النصرة" في سورية إلى دولته، لتصبح "الدولة الإسلامية في العراق والشام" تتويجًا حتميًا للخلافات التاريخية بين الفرع والمركز، والتي تم احتواؤها إبان زعامة أسامة بن لادن. وقد تطور الخلاف، بعد أن أصدر زعيم جبهة النصرة، أبو محمد الجولاني، في اليوم التالي لإعلان الدمج في 10 إبريل/ نيسان، بيانًا يرفض فيه الامتثال للدمج والانضمام لـتنظيم "داعش"، وأعلن عن ارتباطه بالتنظيم المركزي للقاعدة، وتأكيد بيعته الصريحة للظواهري. ولم يفلح جهد الأخير في احتواء الخلاف، حين أصدر قراره تحديد الولاية المكانية للفرعين، في 9 يونيو/ حزيران 2013، والفصل ببطلان الدمج وحل "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، مع بقاء "جبهة النصرة" و"الدولة الإسلامية في العراق" فرعين منفصلين، يتبعان تنظيم القاعدة.
وتدرّج الخلاف بين الفرع العراقي للقاعدة والتنظيم المركزي، منذ بيعة "أبو مصعب الزرقاوي" لأسامة بن لادن، وصولًا إلى "إعلان الدولة"؛ فأجندة القاعدة تهدف منذ الإعلان عن تأسيس "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين" عام 1998 إلى قتال الغرب عمومًا، والولايات المتحدة خصوصًا، باعتبارها حامية للأنظمة العربية الاستبدادية، وراعية لحليفتها الإستراتيجية إسرائيل من جهة، والسعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة الخلافة، من جهة أخرى. ومواجهة الغرب ورفع الهيمنة الخارجية، والتصدي للاستبداد وتمكين الشريعة داخليًا، هما ركنا القاعدة الأساسيان.
أما أجندة "داعش" فتقوم على أولوية مواجهة النفوذ والتوسع الإيراني في المنطقة، ومحاربة "المشروع الصفوي" كما تصفه، خصوصًا بعد رحيل القوات الأميركية عن العراق؛ فالأساس الهوياتي (السني – الشيعي) هو المحرّك الرئيس لسلوك الفرع العراقي، بينما الأساس المصلحي الجيوسياسي هو المحرّك الرئيس للقيادة المركزية للقاعدة. أما تمكين الشريعة فهو الهدف المشترك للطرفين، إلا أنّ توقيت الإعلان عن قيام الدولة الإسلامية في العراق فجّر خلافاتٍ، جرى تجاوزها آنذاك، نظرًا للظروف الموضوعية والأسباب العملية. وساهم وجود بن لادن على رأس التنظيم، بما يمتلكه من كاريزما في تدبير الاختلاف والتعايش الحذر، على الرغم من انتقاداتٍ لم تنقطع لنهج الفرع العراقي، وممارساته المتعلقة بتكتيكاته القتالية، عبر التوسع في استخدام العمليات الانتحارية، وتحديد دائرة الاستهداف.
وعلى الرغم من انضمام الفرع العراقي لتنظيم القاعدة المركزي، ومبايعة بن لادن، فإنّ المؤسس الأول للتنظيم العراقي، أبو مصعب الزرقاوي، (أحمد فضيل الخلايلة) عمل على تأسيس شبكته الممتدة الخاصة المستقلة، بدءًا من الأردن وتنظيم "بيعة الإمام"، مرورًا بأفغانستان وإنشاء "معسكر هيرات"، وختامًا في العراق. فقد عمل على توسيع دائرة نفوذه وتأثيره، عقب احتلال الولايات المتحدة الأميركية العراق عام 2003، وأعلن عن تأسيس جماعة "التوحيد والجهاد" في سبتمبر/ أيلول 2003، كما أعلن عن تأسيس "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"، عقب بيعة بن لادن في 8 أكتوبر/ تشرين أول 2004.
بعد مقتل الزرقاوي في 7 يونيو/ حزيران 2006، أعلن عن تأسيس "الدولة الإسلامية في العراق" في 15 أكتوبر/ تشرين أول 2006 بزعامة أبو عمر البغدادي (حامد داود الزاوي)، وعقب مقتله، في 19 إبريل/نيسان 2010، إلى جانب وزير حربه، أبو حمزة المهاجر، تولى الإمارة أبو بكر البغدادي ("أبو دعاء" إبراهيم عواد البدري) في 16 مايو/ أيار 2010، وهي الحقبة التي شهدت تحولًا في البنية التنظيمية للفرع العراقي، بعد سيطرة عسكريين عملوا في المؤسسة العسكرية، في عهد صدام حسين، منهم العميد الركن محمد الندى الجبوري المعروف بـ "الراعي"، والذي استلم قيادة أركان الدولة بتكليف من المهاجر؛ وهو الذي وضع العميد الركن سمير عبد محمد المعروف بـ "حجي بكر" نائبًا له، والذي أصبح بعد أشهر قائدًا لأركان الدولة، بعد مقتل الراعي.
سيطرت "داعش" على مساحات شاسعة في غرب العراق، وخصوصًا في محافظة الأنبار، وكذلك في شرق سورية، وخصوصاً محافظة الرقة. ولم يعد التنظيم يحفل برضا القاعدة والجماعات الإسلامية المسلحة؛ إذ يتعامل معها بالقوة المميتة، بوصفها جماعات مرتدة وصحوات، وخصوصًا عقب الصدام المسلح المفتوح منذ انفجاره، في 3 يناير/ كانون ثاني 2014، مع الفصائل الإسلامية المسلحة، وفي مقدمتها جبهة النصرة، وجيش المجاهدين، والجبهة الإسلامية، وجبهة ثوار سورية، فضلًا عن تشكيلات الجيش الحر وقوى المجتمع المحلي.
يبلغ عدد أعضاء التنظيم نحو 15 ألف مقاتل؛ وهو يستقطب النسبة الكبرى من المقاتلين الأجانب، ويتوفر على موارد مالية كبيرة، تعتمد على فرض الإتاوات في مناطق نفوذه في العراق، وعلى التبرعات التي تأتيه من شبكة منظمة في دول عديدة. وقد شهدت موارده نموًا كبيرًا، عقب دخوله سورية، من خلال سيطرته على موارد رئيسة، تركّز معظمها في المنطقة الشرقية، مثل النفط، إذ استولى التنظيم على عدة حقول للنفط والغاز في الرقة والحسكة ودير الزور، وعلى قطاع الزراعة، حينما استولى على صوامع الحبوب في الحسكة، وهو يتحكم بإدارة المنتجات الزراعية واستثمارها. كما تعتبر الفدية من مصادر تمويله التقليدية، إذ اعتقل التنظيم سوريين وأجانب، وأفرج عنهم بعد أخذ فدية مالية.
على الرغم من قوة تنظيم "داعش" الذاتية، فإنّ قوتها الحقيقية موضوعية؛ فالمشكلات السياسية والاقتصادية في العراق وسورية توفر بيئات حاضنة للتطرف. كما وفرت الطبيعة السلطوية والطائفية لنظامي الأسد والمالكي، المدعومة من إيران، وانحراف طبائع الصراع إلى شكل هوياتي طائفي بين السنة والشيعة، بيئةً مثاليةً خصبةً للتعبئة، وجاذبيةً أيديولوجيةً للتنظيم.
المعارضة السنيّة: انبعاث الحركات المسلحة
تستند القراءة التهوينية في تفهم حدث سقوط الموصل، وانهيار المنظومة العسكرية والأمنية، إلى اعتباره محصلة طبيعية لحركة الاحتجاجات الشعبية في المحافظات السنيّة المنتفضة؛ إذ أدت سياسات المالكي الطائفية الفجة إلى فقدان السياسيين السنة الذين لم ينضموا لتلك الاحتجاجات صدقيتهم، وإلى تحوّل الحركة الاحتجاجية السلمية التي انطلقت مع نهاية عام 2012 إلى حركات مسلحة. فالسياسات الهوياتية الاستبدادية الفاسدة، والتي طبعت مسارات الدولة منذ بداية الاحتلال، عملت على إذلال المكون العربي السني، ولم تجلب محاولات العرب السنة للانخراط في العملية السياسية سوى مزيد من التهميش والشعور بالظلم والتمييز. وقد تنامت هذه المشاعر وتعززت، عقب اقتحام قوات المالكي خيم المعتصمين على الطريق الدولي الرابط بين بغداد وعمان ودمشق، ققد استخدم المالكي جميع الوسائل الممكنة، المغلّفة بالقانون والشرعية، لاستبعاد خصومه السياسيين، وترسيخ سلطته الفردية، من خلال توليه جميع الملفات الحيوية في الدولة. فبالإضافة إلى تولّيه منصب رئاسة الوزراء، يتولى المالكي المسؤولية عن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني، ويتحكم بتفسير جملة من القوانين وتطبيقها؛ بدءًا بقانون الإرهاب الذي بات سيفًا مصلتًا، يستخدمه للتخلص من معارضيه وخصومه السياسيين، وتدعيم سلطته الديكتاتورية، كما حدث مع نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، الذي بات ملاحقًا بتهمة الإرهاب، مرورًا بالتعامل مع وزير المال، رافع العيساوي، واعتقال حراسه ورئيس البرلمان، أسامه النجيفي، وبعض أتباعه، واعتقال النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه، وانتهاءً بقانون المساءلة والعدالة الذي حل مكان قانون اجتثاث البعث. ومن خلال القانون الأخير، تم تهميش سياسيين بارزين من السنة واستبعادهم، بحجة وجود ارتباطات مزعومة عليا بحزب البعث السابق. كما أنّ قوات المالكي كانت تنتشر، بشكل استفزازي، في سائر الأحياء السنيّة في بغداد، وفي المحافظات التي يقطنها السنة في الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، وكركوك، وديالى.
بعد أن تفجّرت الأوضاع في الأنبار، وسيطرت قوات العشائر على الفلوجة والرمادي، تشكلت مجالس عسكرية مكونة من بعض أفراد الجيش العراقي السابق، وعناصر عشائرية مسلحة، ومن غيرهم من بقايا جماعات المقاومة العراقية، مثل "الجيش الاسلامي"، و"حماس العراق"، و"كتائب ثورة العشرين"، و"جيش المجاهدين"، و"أنصار السنّة". ولا يجوز تجاهل المكون الشعبي في الانتفاضة العراقية السلمية السابقة، والمسلحة الحالية.
خلاصة
تلامس القراءات الأحادية جانبًا من الحقيقة، لكنها تبقى خاطئة لهذا السبب بالذات. فالقراءة التعددية المركبة تؤكد على أنها تتكامل في رسم صورة أكثر دقة. تصرّ رواية نوري المالكي السلطوية، الطامحة بولاية ثالثة، على أنها تواجه تنظيم القاعدة، وبأنّ تنظيم "داعش" هو من يسيطر وحده على الأنبار والموصل، وبأنه يحارب الإرهاب الممتد من العراق إلى سورية. وهو بذلك يتماهى مع السياسات الأميركية المتعلقة بمحاربة "الإرهاب"، وتأمين "الاستقرار" لضمان مصالحها. ولا شك في أنّ سياسات المالكي الأمنية العنيفة، المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وإيران، في الوقت نفسه، دفعت القوى السنيّة السلمية المطالبة بالعدالة والديمقراطية والحرية ومحاربة الفساد والاستبداد إلى الاقتناع بعدم جدوى المطالبات السلمية، والانتقال إلى المقاومة العسكرية في صد الهجوم، الأمر الذي استثمره تنظيم "داعش" لتوسيع نفوذه وملء الفراغ، والدخول في تحالفات موضوعية، مضمرة مع القوى المسلحة السنيّة، في مواجهة عدو مشترك، يمثله الحلف المالكي -الأميركي.
لكن، السؤال الأهم: هل ستصمد التحالفات السابقة، أم أنها ستبدأ بالتفكك، والبحث عن بدائل أخرى، بعد تبيّن فشل المالكي؟ والسؤال الثاني: هل ستدرك القوى العربية السنية التي عانت الأمرّين، منذ الاحتلال، أنّ "داعش" هي، في النهاية، عبء حقيقي معاد للديمقراطية والمدنية، على حد سواء، في العراق كما في سورية؟ وقد تدرك، أيضًا، أنه لا بد من طرح المطالب العربية بصيغة ديمقراطية، وأنّ الموقف ضد الطائفية السياسية، يجب أن يكون ضد كل طائفية سياسية في العراق، وفي المشرق العربي عمومًا.