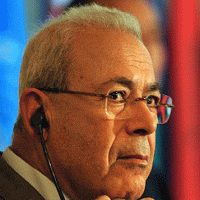17 أكتوبر 2024
الخليج في عين العاصفة
تعامل عربٌ باستهتار، وبعضهم بسخريةٍ، أو شماتةٍ، مع الأزمة المتفجرة في مجلس التعاون الخليجي، بعضهم لاعتقادهم أن الأمر لا يعني سوى بلدانٍ بعيدة عنهم، ليس جغرافيا فحسب، وإنما نفسيا، ربما بسبب التفاوت الكبير في مستويات المعيشة، واختلاف التطلعات والتحالفات والخيارات الاستراتيجية، وبعضهم الآخر لغيرتهم من الغنى الكبير الذي يميز هذه البلدان وأنماط سلوك نخبها الاجتماعية والسياسية التي تجمع بين الإنفاق الاستهلاكي الباهظ وروح المحافظة والتمسّك بالتقاليد الاجتماعية، إن لم يكن تجميدها. وبعضهم الثالث بدافع الانتقام من دولٍ يرى فيها المسؤولة الأولى عن صعود الإسلام المحافظ في المشرق، وبعض رابع لاتهامها بتمويل الحركات الإسلامية.
لكن من الخطأ أن ينظر العرب إلى النزاع الخليجي كأزمةٍ لا تعني إلا بلدان الخليج الغنية. ليس لأن الخليج جزءٌ من العالم العربي فحسب، ولكن لأن هذا النزاع داخل منطقة الخليج هو نفسه جزءٌ من النزاع المحتدم منذ سنوات داخل البلدان العربية على حسم مسألة السلطة ونظام الحكم، وبشكل أساسي، مسألة الانتقال السياسي التي أصبحت، في نظر محللين كثيرين، مسألةً راهنةً، ولا يمكن تأجيلها، والتي يشكل إدخال الشعب، بالمعنى العام والبسيط، في حقل المشاركة السياسية والحقوق المدنية، أي في دائرة ومفهوم المسؤولية العمومية الذي لا يزال محتكرا من نخبٍ محدودةٍ منذ عقود، وبصرف النظر عن الصيغ والضوابط والحدود، غايته الرئيسية. وثالثا لأن تحقيق هذه الغاية من عدمه يشكل جزءا من الصراع الأكبر الذي يدور، منذ سنوات، على تقرير مصير المشرق العربي، ومن ورائه على تقرير وضع الشعوب العربية وتحديد دورها ومكانتها، بعد أن فقدت السيطرة على مصيرها وأصبحت موضوع تنافس إقليمي ودولي شامل.
بالتأكيد، ليست هذه الأزمة هي الأولى التي شهدتها العلاقات الخليجية. ولا شك أيضا أن لها أسبابها في تباين الخيارات والتقديرات السياسية، الأيديولوجية والاستراتيجية، بين الأطراف، مما لا يمكن تجنبه بوجود أكثر من دولة مستقلة. ومن المشروع والضروري التذكير بهذه الخلافات، وعدم تغطيتها أو طمسها، حتى يمكن الحديث بصراحةٍ وجديةٍ عنها، وإيجاد حل دائم يمكّن مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على نفسه وتعزيز روح التعاون والتفاهم بين بلدانه. فهو يمثل اليوم، شئنا أم أبينا، القوة الوحيدة التي لا تزال متماسكةً نسبيا، ومن الممكن المراهنة عليها للحفاظ على الحد الأدنى من المصالح العربية أمام تغوّل القوى الإقليمية والدولية، وزجّها بقوىً غير مسبوقة في الصراع الدائر من دون أفقٍ لوقفه، في أكثر أقطار المشرق الأخرى، من اليمن إلى العراق مرورا بسورية.
1
لست من أنصار النظريات التآمرية في العلاقات والسياسة الدولية. لكن، هناك مؤشراتٌ كثيرة توحي بأن أحدا من الدول الإقليمية والكبرى لا يريد المساهمة في وضع حدٍّ لأزمة المنطقة
المتفجرة منذ سنوات، وبطريقة مأساوية. بالعكس، أعتقد أن هناك نوعا من التفاهم الدولي الضمني، وغير المعلن، على إسقاط العرب، وبالتالي المصالح العربية، من الحساب، وإعادة تقسيم المشرق إلى مناطق نفوذ بين الدول، كلٌّ على حسب قوتها واستعدادها لأخذ المخاطر في هذا الصراع الذي من المؤسف القول إنه لا يمثل صراعا مصيريا سوى بالنسبة للعرب وحدهم، بينما تنظر إليه الدول الأخرى صراعاً على المكاسب والمغانم وإعادة التموضع في خريطة التحولات والنزاعات الدولية. وليس من المبالغة القول إن من الخطأ التسليم لهذه الدول، أو الثقة بما تقدّمه من وعود، يمكن أن تتنصل منها، بالسرعة نفسها التي تعلن فيها التزامها بها. وليس لهذه الوعود غايةٌ أخرى، في نظري، سوى تسكين الأطراف العربية، وإشراكها في تنفيذ المخططات الاستراتيجية الكبرى والبعيدة المدى المرسومة مسبقا، لترتيب أوضاع المنطقة في حقبة ما بعد ثورات الربيع العربي. وتنطلق جميع هذه الاستراتيجيات من التسليم بأنه ليس من الحصافة الركون إلى الدول العربية، أو نخبها الحاكمة، والرهان عليها في تحقيق الأمن والاستقرار. وبالتالي، في ضمان المصالح الدولية الرئيسية، وفي مقدمها مصادر الطاقة والسيطرة على قوى الفوضى والتطرف المتنامية والمهدّدة بالانتشار على أوسع نطاق في العالم. وبدل أن تسعى إلى تثبيت الأنظمة الحليفة، كما كانت تفعل في السابق، أعتقد أنها قرّرت عدم التورّط معها، وتركها كما صرح الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، تدافع هي نفسها، مع دعمها إذا اضطر الأمر. لكن مع الرئيس الجديد الذي يعتبر أن لأميركا دينا على العرب بعد حرب العراق، إن لم يكن كل الحق في السيطرة على منابع النفط واستغلالها لصالحها، كما صرّح علنا في أحد مؤتمراته الصحفية قبل الانتخابات الرئاسية، بإعطائها ركلةً إضافية، لتسريع سقوطها في سبيل وراثتها، كما يعتقد ويتمنى، بعد انهيارها. ونحن لسنا الوحيدين الذين يعتقدون أن ترامب مستعدٌ للعب بالنار من دون وازع، ولا إحساس بالمخاطر، لتأمين أكثر ما يمكن من المكاسب القومية والشخصية.
وتبدو ملامح هذه الاستراتيجية التصفوية واضحةً في الطريقة التي تعاملت بها الدول الكبرى
الصناعية حتى الآن مع الأزمة السورية، بصرف النظر عن الرسائل والتصريحات الدبلوماسية المطمئئة والتحليلات الصحفية. فأنا لا أعتقد أن ما رأيناه، ولا نزال نراه، من مشاهد القتل والتدمير في سورية، وربما في الرد الباهت على الانفجار المفاجئ للأزمة الخليجية، كان عفويا أو ثمرة الفوضى أو خروج الأوضاع عن السيطرة. أعتقد أن ترك المنطقة تتفكّك وتنهار، بل والمساعدة في تقويض استقرارها وتفجيرها من الداخل، هو جزءٌ من استراتيجية الاستنزاف العميق لشعوب المنطقة وتفريغها من قواها، والتخلص من خطر تحرّرها وتطرّفها معا، بدفعها إلى الانتحار بنزاعاتها الداخلية. فهي منطقة مجاورة لأوروبا تضم قريبا جدا 400 مليون إنسان، في مجتمعاتٍ أخفقت في بناء مجتمعات منظمة ودول مستقرة، وفشلت في بناء اقتصاداتٍ ناجعة وفعالة قادرة على تقديم فرص العمل لملايين الشباب المفتقرين أكثر فأكثر للتأهيل، وأمام نظم سياسية متفسخةٍ ومتحللةٍ لم تعد تملك، بعد انفجار الثورات، لا القوة القهرية ولا الشرعية اللازمة لفرض الطاعة والاحترام على محكوميها. مجتمعاتٌ مفكّكةٌ لن تتوقف عن رمي حطامها على بقية الدول والبلدان، وإثارة المشكلات والقلاقل والاضطرابات فيها.
لذلك، لا بد من قوة ضبط أكبر بكثير، وأكثر قربا جغرافيا مما كانت تحتاج إليه السيطرة على سياساتها وتحولاتها في العقود السابقة، قبل انهيار النظم الاستبدادية. ومن هنا، حصل الانتقال، تحت مظلة الحروب السورية، من استراتيجية التدخل الجاهز الخارجي، ومنه التدخلات الإسرائيلية، إلى شرعنة الإقامة والاستيطان في قواعد عسكرية وبشرية أقوى بكثيرٍ مما نظن، ومن ورائها انتزاع حكم المنطقة من يد أبنائها وإدارتها بشكل شبه مباشر. ومنذ الآن، ترتسم معالم هذا الاقتسام، تقريبا بالتراضي، لمناطق النفوذ والموارد والمصالح والامتيازات، وحتى السكان، بين الدول المتنافسة، بما يذكّر باستراتيجيات الحقبة الاستعمارية الأولى. وذلك كله على جثة ما كنا نسميه، وما كان يشكل مشروعا وأملا لكثيرين من سكان هذه المنطقة: الأمة العربية، او أي تكتل عربي متناغم ومنسجم ومستقل، يتحكم بموارد أرضه، ويتحول ويحول العرب إلى شريكٍ فاعل ومحترم في الحياة والسياسة الإقليميتين والدوليتين.
2
ما حصل في سورية من شرعنة عملية لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، والتعامل "السينيكي" أو اللئيم مع جرائم النظام ورئيسه، والتنكّر لمأساة الملايين من أبناء الشعب السوري وشعوب المنطقة الأخرى، بأكثرياتها وأقلياتها من دون تمييز، هو الخطوة الأولى على طريق إقامة نظام السيطرة شبه المباشرة على ما يمكن تسميته "المشرق المفيد"، وهو أيضا من المصطلحات التي أدخلتها المأساة السورية في السياسة الدولية، وتهميش وتشريد ملايين العرب الذين سينظر إليهم كما ينظر للسوريين اليوم، وكانوا من أكثر الشعوب إثارة للإعجاب والاحترام في بلدان العالم الأخرى، لاجئين بؤساء وعاجزين وغير قادرين أو ليس لديهم الأهلية والكفاءة والحصافة لتنظيم شؤونهم في شكل دولة، أو لتوحيد قواهم وتشكيل قيادة سياسيةٍ مختلفةٍ عن القيادات القبلية والعائلية والدينية.
ولا نستطيع أن ننكر أن في هذا التقدير جزاء من الواقع الراهن. ولا نبالغ إذا قلنا إن علاقات السلطة تشهد في المجتمعات العربية والمشرقية منذ عقود. لكن بشكل أكبر، تعاني من أزمة
عميقة بعد الزلزال الذي مثله الربيع العربي، والمصير الذي آلت إليه مطالب الانتقال السياسي وفتح الفضاء العام، أمام شعبٍ خضع، بالمعنى الحرفي للكلمة، للاحتقار والتهميش والتحييد، ودفعه إلى أن ينمّي في داخله مشاعر الرفض والاحتجاج والمقاومة، كما لم يحصل في أي حقبةٍ سابقة. كما لا يخفى على أي مراقبٍ أن مصير الدولة نفسها قد أصبح في عموم المنطقة معلقا أو على كفّ عفريت، ما ينذر بأسوأ المخاطر والاحتمالات.
لا يساعد تأجيج الخلافات والنزاعات داخل ما تبقى من المعسكر العربي المتهاوي على حل أي مشكلة، لكنه يزيد من تأجيجها ودفع الأطراف جميعا إلى خياراتٍ كارثية. وإذا كانت المخاطر قد زادت، وقد زادت بالتأكيد، بعد الربيع العربي وتدخلات الدول الأخرى، وأولها تدخلات إيران المستيقظة على نزعة استعمارية بدائية، فليس الخيار الأفضل لمواجهتها إطلاق حروبٍ أو نزاعاتٍ إضافية بين الدول والنظم العربية. ومن الصّحي والضروري أن نشعر بخطر الحركات الإسلامية المتطرفة، ونعمل على الحؤول دون توسعها وانتشارها. لكن الحل لا يوجد في إغلاق أكبر لحقل السياسة والنشاطات المدنية، ولا التضييق أكثر على الحريات، والحد من الهامش الضئيل الذي لا تزال تتمتع به بعض الفئات الاجتماعية من حرية التعبير والتفكير، وذلك مهما كان حجم تمدد الصيغ المحافظة والمتطرفة الإسلاموية وانتشار الثقافة المناقضة لروح الإسلام وتاريخه وثقافته وفكره.
ليست الحركات الإسلامية، بكل فروعها، سوى حركات احتجاجٍ ضلت طريقها، وليس لتوسع انتشارها علاقة بما هو مكتوب في النصوص الدينية، أو في تعليقات الشراح القدامى والجدد. وليس إصلاح الدين أو تغييره هو ما يحرّكها. وضلالها نابع بالضبط من أنها لا تجد وسيلةً للتعبير عن مشاعرها الاحتجاجية، وعن تطلعاتها للعدالة والحرية إلا لغة الثقافة الدينية المحافظة المنافية لها. ولا ينبغي أن تخدعنا تحليلات الغربيين، وطرائقهم التصفوية السريعة التي فاقمت من المشكلة أكثر مما ساعدت على حلها. فلا يحرّكهم فيها سوى الرعب الذي يثيره فيهم سلوك يرون فيه عودةً إلى القرون الوسطى، ولا يهمهم سوى التخلص منه بأي ثمن، ومهما كانت العواقب على المجتمعات العربية. فليس من همومهم التفكير بمصير هذه المجتمعات، ولا تجاوز أزماتها، أتفجرت أم انهارت، أم تحولت إلى ساحة معارك مستمرة. بل هم يعتقدون خطأ أن من مصلحتهم نقل المعركة إلى داخل حدود العدو المفترض، وإشعال حربٍ أهلية مستمرة، تستنفد قوانا "العدوانية". ولن تكون نتيجة هذه السياسات سوى تعميم الفوضى التي لن تتوقف عند حدود بلداننا، ولن تفيد في حمايتهم منها إقامة الجدران العازلة على طول الحدود.
3
ما ينقذنا وينقذهم هو تخفيف الاحتقان داخل المجتمعات، وفتح الآفاق أمام الشباب والتفاوض على مشروع تنميةٍ، يضمن فتح فرص التقدم للجميع، على مستوى المنطقة ككل، وليس في بلدٍ بعينه، لاستثمار ما تحويه أرضه من موارد وثروات وشعبه من مواهب وطاقات. لن يقف في وجه تنامي حركات الاحتجاج، وتراجع الحاجة إلى صبغها بالصبغة الإسلامية سد الطريق على أي إصلاح أو انفتاح، وتشديد القبضة الأمنية، وإعلان الحرب على كل وسائل الإعلام
والكتابات النقدية. بالعكس، ما ينبغي عمله لتجنب الانفجار هو استباق الأحداث، وفتح طريق الإصلاح. ما يساعد على وقف نمو هذه الحركات، ويحد من انتشارها أمران لا بديل عنهما: السعي إلى إيجاد حلول فعلية للتناقضات العميقة التي تقوّض حياة الشعوب، وتحرمها من الأمن والسلام والاستقرار، من جهة والرد الإيجابي على الجزء الأهم من تطلعاتها الأساسية، وتشجيعها من خلال توسيع هامش حرية التعبير والتنظيم على تبني منطق السياسة العقلاني، للتعبير عن حاجاتها بدل إلباسها لبوس المطالب الدينية، أي تشجيعها على التعبير بشفافيةٍ عن تطلعاتها الطبيعية والمشروعة من جهة ثانية، ما يستدعي أيضا القبول بإقامة حياة سياسية ووضع قواعد واضحة لممارسة السلطة واتخاذ القرار.
يخطئ أشقاؤنا الخليجيون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي كان مؤامرة خارجية، وأنه لن يمر بمنطقتهم لشروط حكمها الاستثنائية، وهذا ما كان يعتقده أيضا الحكام السوريون والليبيون. ويخطئون أيضا إذا اعتقدوا أن المشكلة تكمن في الانفتاح، أو وجود وسائل الصحافة النقدية، فوسائل التواصل الجديدة كسرت أي احتكارٍ على الأفكار والمعلومات. ويخطئون إذا اعتقدوا أن الدواء الوحيد للخوف من التغيير هو إغلاق النوافذ وسد الأبواب وإقامة جدران العزلة والانعزال. ويخطئون إذا فكروا أن أسباب تصدر الإسلام المتطرف والمحافظ واجهة المعارضة والاحتجاج كامنة في غياب القبضة الحديدية أو ضعفها.
ليست المشكلة في الحرية والانفتاح، ولكنها بالعكس في غيابهما. فلا يمكن لسياسات القمع والحجر والحظر أن تعلم التسامح، ولا أن تزرع روح الحرية، ولكنها تعلم بالعكس قيم التشدّد والتقوقع ورفض الاختلاف. وما يتعلمه الشباب من خلالها هو رفض الحرية ونبذها وإنكارها، ومعها جميع قيم التسامح والتعددية واحترام الرأي الآخر.
من هنا، أعتقد أن توسيع هامش الحريات والحقوق العامة، وتعليم ثقافة الحرية وتعميم مبادئها وتطبيقها، هو الطريق الوحيد لتحرير حركات الاحتجاج الاجتماعية من الحاجة إلى ركوب طريق السوق الموازية الدينية أو الطائفية التي تميل إلى ركوبها الآن، والعودة إلى روح المعارضة السلمية والعقلانية المرتبطة بتأكيد قيم الحرية واحترام القانون والاختلاف في الرأي والعقيدة. فكما تقود ثقافة التشدّد إلى تشدّد أكبر، تقود ثقافة الحرية واستبطانها إلى مزيد من التسامح والقبول بالتعدّدية الفكرية والسياسية. وهذا هو أصل ما نشهده من نمو روح الانفتاح والتسامح في الغرب الليبرالي. والتركيز على هذه القيم هو الذي شكّل، خلال العقود الماضية، مصدر قوة الأفكار الديمقراطية وأحزابها والاشتراكية الديمقراطية ومصدر شرعيتها الرئيسي في مواجهة المحافظين واليمين المتطرّف الصاعد اليوم.
باختصار، حتى يتمثلوا معنى التسامح، على الشباب أن يتلقوا ثقافةً متسامحةً، ثقافة العقل والحرية. وهذا يستدعي نظما اجتماعية وتربوية تمارس الانفتاح، وتدعم ثقافة التسامح، وتظهر بالفعل انشغالها بمستقبل الشباب، وأوضاعهم المادية والنفسية.
ليس الحل في إغلاق الأبواب، وقطع الطريق على تيار الحرية والانفتاح والديمقراطية والمشاركة السياسية. ولكن بالعكس. وهذا يعني في الظروف الراهنة للبلدان العربية، والخليجية منها بشكل خاص، مواكبة حركة التاريخ، لا مقاومتها، والانتقال الاختياري والتدريجي نحو صيغة دستورية للحكم، تقطع مع عصر السلطة المطلقة التي تكاد تنقرض من حياة الدول الحديثة. وأخشى أن يكون البديل الوحيد لرفض هذا الانتقال السياسي المنتظر والمطلوب لتجنب كوارث جديدة، في ظروف مجتمعاتنا المعولمة والشابة عن الطوق، هو المحرقة الشاملة على الطريقة السورية. العمل بكل الوسائل لتجنب ذلك والتذكير به مسؤوليتنا جميعاً، سياسيين ومثقفين، حاكمين ومحكومين.
لكن من الخطأ أن ينظر العرب إلى النزاع الخليجي كأزمةٍ لا تعني إلا بلدان الخليج الغنية. ليس لأن الخليج جزءٌ من العالم العربي فحسب، ولكن لأن هذا النزاع داخل منطقة الخليج هو نفسه جزءٌ من النزاع المحتدم منذ سنوات داخل البلدان العربية على حسم مسألة السلطة ونظام الحكم، وبشكل أساسي، مسألة الانتقال السياسي التي أصبحت، في نظر محللين كثيرين، مسألةً راهنةً، ولا يمكن تأجيلها، والتي يشكل إدخال الشعب، بالمعنى العام والبسيط، في حقل المشاركة السياسية والحقوق المدنية، أي في دائرة ومفهوم المسؤولية العمومية الذي لا يزال محتكرا من نخبٍ محدودةٍ منذ عقود، وبصرف النظر عن الصيغ والضوابط والحدود، غايته الرئيسية. وثالثا لأن تحقيق هذه الغاية من عدمه يشكل جزءا من الصراع الأكبر الذي يدور، منذ سنوات، على تقرير مصير المشرق العربي، ومن ورائه على تقرير وضع الشعوب العربية وتحديد دورها ومكانتها، بعد أن فقدت السيطرة على مصيرها وأصبحت موضوع تنافس إقليمي ودولي شامل.
بالتأكيد، ليست هذه الأزمة هي الأولى التي شهدتها العلاقات الخليجية. ولا شك أيضا أن لها أسبابها في تباين الخيارات والتقديرات السياسية، الأيديولوجية والاستراتيجية، بين الأطراف، مما لا يمكن تجنبه بوجود أكثر من دولة مستقلة. ومن المشروع والضروري التذكير بهذه الخلافات، وعدم تغطيتها أو طمسها، حتى يمكن الحديث بصراحةٍ وجديةٍ عنها، وإيجاد حل دائم يمكّن مجلس التعاون الخليجي من الحفاظ على نفسه وتعزيز روح التعاون والتفاهم بين بلدانه. فهو يمثل اليوم، شئنا أم أبينا، القوة الوحيدة التي لا تزال متماسكةً نسبيا، ومن الممكن المراهنة عليها للحفاظ على الحد الأدنى من المصالح العربية أمام تغوّل القوى الإقليمية والدولية، وزجّها بقوىً غير مسبوقة في الصراع الدائر من دون أفقٍ لوقفه، في أكثر أقطار المشرق الأخرى، من اليمن إلى العراق مرورا بسورية.
1
لست من أنصار النظريات التآمرية في العلاقات والسياسة الدولية. لكن، هناك مؤشراتٌ كثيرة توحي بأن أحدا من الدول الإقليمية والكبرى لا يريد المساهمة في وضع حدٍّ لأزمة المنطقة
وتبدو ملامح هذه الاستراتيجية التصفوية واضحةً في الطريقة التي تعاملت بها الدول الكبرى
لذلك، لا بد من قوة ضبط أكبر بكثير، وأكثر قربا جغرافيا مما كانت تحتاج إليه السيطرة على سياساتها وتحولاتها في العقود السابقة، قبل انهيار النظم الاستبدادية. ومن هنا، حصل الانتقال، تحت مظلة الحروب السورية، من استراتيجية التدخل الجاهز الخارجي، ومنه التدخلات الإسرائيلية، إلى شرعنة الإقامة والاستيطان في قواعد عسكرية وبشرية أقوى بكثيرٍ مما نظن، ومن ورائها انتزاع حكم المنطقة من يد أبنائها وإدارتها بشكل شبه مباشر. ومنذ الآن، ترتسم معالم هذا الاقتسام، تقريبا بالتراضي، لمناطق النفوذ والموارد والمصالح والامتيازات، وحتى السكان، بين الدول المتنافسة، بما يذكّر باستراتيجيات الحقبة الاستعمارية الأولى. وذلك كله على جثة ما كنا نسميه، وما كان يشكل مشروعا وأملا لكثيرين من سكان هذه المنطقة: الأمة العربية، او أي تكتل عربي متناغم ومنسجم ومستقل، يتحكم بموارد أرضه، ويتحول ويحول العرب إلى شريكٍ فاعل ومحترم في الحياة والسياسة الإقليميتين والدوليتين.
2
ما حصل في سورية من شرعنة عملية لاستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيماوية، والتعامل "السينيكي" أو اللئيم مع جرائم النظام ورئيسه، والتنكّر لمأساة الملايين من أبناء الشعب السوري وشعوب المنطقة الأخرى، بأكثرياتها وأقلياتها من دون تمييز، هو الخطوة الأولى على طريق إقامة نظام السيطرة شبه المباشرة على ما يمكن تسميته "المشرق المفيد"، وهو أيضا من المصطلحات التي أدخلتها المأساة السورية في السياسة الدولية، وتهميش وتشريد ملايين العرب الذين سينظر إليهم كما ينظر للسوريين اليوم، وكانوا من أكثر الشعوب إثارة للإعجاب والاحترام في بلدان العالم الأخرى، لاجئين بؤساء وعاجزين وغير قادرين أو ليس لديهم الأهلية والكفاءة والحصافة لتنظيم شؤونهم في شكل دولة، أو لتوحيد قواهم وتشكيل قيادة سياسيةٍ مختلفةٍ عن القيادات القبلية والعائلية والدينية.
ولا نستطيع أن ننكر أن في هذا التقدير جزاء من الواقع الراهن. ولا نبالغ إذا قلنا إن علاقات السلطة تشهد في المجتمعات العربية والمشرقية منذ عقود. لكن بشكل أكبر، تعاني من أزمة
لا يساعد تأجيج الخلافات والنزاعات داخل ما تبقى من المعسكر العربي المتهاوي على حل أي مشكلة، لكنه يزيد من تأجيجها ودفع الأطراف جميعا إلى خياراتٍ كارثية. وإذا كانت المخاطر قد زادت، وقد زادت بالتأكيد، بعد الربيع العربي وتدخلات الدول الأخرى، وأولها تدخلات إيران المستيقظة على نزعة استعمارية بدائية، فليس الخيار الأفضل لمواجهتها إطلاق حروبٍ أو نزاعاتٍ إضافية بين الدول والنظم العربية. ومن الصّحي والضروري أن نشعر بخطر الحركات الإسلامية المتطرفة، ونعمل على الحؤول دون توسعها وانتشارها. لكن الحل لا يوجد في إغلاق أكبر لحقل السياسة والنشاطات المدنية، ولا التضييق أكثر على الحريات، والحد من الهامش الضئيل الذي لا تزال تتمتع به بعض الفئات الاجتماعية من حرية التعبير والتفكير، وذلك مهما كان حجم تمدد الصيغ المحافظة والمتطرفة الإسلاموية وانتشار الثقافة المناقضة لروح الإسلام وتاريخه وثقافته وفكره.
ليست الحركات الإسلامية، بكل فروعها، سوى حركات احتجاجٍ ضلت طريقها، وليس لتوسع انتشارها علاقة بما هو مكتوب في النصوص الدينية، أو في تعليقات الشراح القدامى والجدد. وليس إصلاح الدين أو تغييره هو ما يحرّكها. وضلالها نابع بالضبط من أنها لا تجد وسيلةً للتعبير عن مشاعرها الاحتجاجية، وعن تطلعاتها للعدالة والحرية إلا لغة الثقافة الدينية المحافظة المنافية لها. ولا ينبغي أن تخدعنا تحليلات الغربيين، وطرائقهم التصفوية السريعة التي فاقمت من المشكلة أكثر مما ساعدت على حلها. فلا يحرّكهم فيها سوى الرعب الذي يثيره فيهم سلوك يرون فيه عودةً إلى القرون الوسطى، ولا يهمهم سوى التخلص منه بأي ثمن، ومهما كانت العواقب على المجتمعات العربية. فليس من همومهم التفكير بمصير هذه المجتمعات، ولا تجاوز أزماتها، أتفجرت أم انهارت، أم تحولت إلى ساحة معارك مستمرة. بل هم يعتقدون خطأ أن من مصلحتهم نقل المعركة إلى داخل حدود العدو المفترض، وإشعال حربٍ أهلية مستمرة، تستنفد قوانا "العدوانية". ولن تكون نتيجة هذه السياسات سوى تعميم الفوضى التي لن تتوقف عند حدود بلداننا، ولن تفيد في حمايتهم منها إقامة الجدران العازلة على طول الحدود.
3
ما ينقذنا وينقذهم هو تخفيف الاحتقان داخل المجتمعات، وفتح الآفاق أمام الشباب والتفاوض على مشروع تنميةٍ، يضمن فتح فرص التقدم للجميع، على مستوى المنطقة ككل، وليس في بلدٍ بعينه، لاستثمار ما تحويه أرضه من موارد وثروات وشعبه من مواهب وطاقات. لن يقف في وجه تنامي حركات الاحتجاج، وتراجع الحاجة إلى صبغها بالصبغة الإسلامية سد الطريق على أي إصلاح أو انفتاح، وتشديد القبضة الأمنية، وإعلان الحرب على كل وسائل الإعلام
يخطئ أشقاؤنا الخليجيون إذا اعتقدوا أن الربيع العربي كان مؤامرة خارجية، وأنه لن يمر بمنطقتهم لشروط حكمها الاستثنائية، وهذا ما كان يعتقده أيضا الحكام السوريون والليبيون. ويخطئون أيضا إذا اعتقدوا أن المشكلة تكمن في الانفتاح، أو وجود وسائل الصحافة النقدية، فوسائل التواصل الجديدة كسرت أي احتكارٍ على الأفكار والمعلومات. ويخطئون إذا اعتقدوا أن الدواء الوحيد للخوف من التغيير هو إغلاق النوافذ وسد الأبواب وإقامة جدران العزلة والانعزال. ويخطئون إذا فكروا أن أسباب تصدر الإسلام المتطرف والمحافظ واجهة المعارضة والاحتجاج كامنة في غياب القبضة الحديدية أو ضعفها.
ليست المشكلة في الحرية والانفتاح، ولكنها بالعكس في غيابهما. فلا يمكن لسياسات القمع والحجر والحظر أن تعلم التسامح، ولا أن تزرع روح الحرية، ولكنها تعلم بالعكس قيم التشدّد والتقوقع ورفض الاختلاف. وما يتعلمه الشباب من خلالها هو رفض الحرية ونبذها وإنكارها، ومعها جميع قيم التسامح والتعددية واحترام الرأي الآخر.
من هنا، أعتقد أن توسيع هامش الحريات والحقوق العامة، وتعليم ثقافة الحرية وتعميم مبادئها وتطبيقها، هو الطريق الوحيد لتحرير حركات الاحتجاج الاجتماعية من الحاجة إلى ركوب طريق السوق الموازية الدينية أو الطائفية التي تميل إلى ركوبها الآن، والعودة إلى روح المعارضة السلمية والعقلانية المرتبطة بتأكيد قيم الحرية واحترام القانون والاختلاف في الرأي والعقيدة. فكما تقود ثقافة التشدّد إلى تشدّد أكبر، تقود ثقافة الحرية واستبطانها إلى مزيد من التسامح والقبول بالتعدّدية الفكرية والسياسية. وهذا هو أصل ما نشهده من نمو روح الانفتاح والتسامح في الغرب الليبرالي. والتركيز على هذه القيم هو الذي شكّل، خلال العقود الماضية، مصدر قوة الأفكار الديمقراطية وأحزابها والاشتراكية الديمقراطية ومصدر شرعيتها الرئيسي في مواجهة المحافظين واليمين المتطرّف الصاعد اليوم.
باختصار، حتى يتمثلوا معنى التسامح، على الشباب أن يتلقوا ثقافةً متسامحةً، ثقافة العقل والحرية. وهذا يستدعي نظما اجتماعية وتربوية تمارس الانفتاح، وتدعم ثقافة التسامح، وتظهر بالفعل انشغالها بمستقبل الشباب، وأوضاعهم المادية والنفسية.
ليس الحل في إغلاق الأبواب، وقطع الطريق على تيار الحرية والانفتاح والديمقراطية والمشاركة السياسية. ولكن بالعكس. وهذا يعني في الظروف الراهنة للبلدان العربية، والخليجية منها بشكل خاص، مواكبة حركة التاريخ، لا مقاومتها، والانتقال الاختياري والتدريجي نحو صيغة دستورية للحكم، تقطع مع عصر السلطة المطلقة التي تكاد تنقرض من حياة الدول الحديثة. وأخشى أن يكون البديل الوحيد لرفض هذا الانتقال السياسي المنتظر والمطلوب لتجنب كوارث جديدة، في ظروف مجتمعاتنا المعولمة والشابة عن الطوق، هو المحرقة الشاملة على الطريقة السورية. العمل بكل الوسائل لتجنب ذلك والتذكير به مسؤوليتنا جميعاً، سياسيين ومثقفين، حاكمين ومحكومين.