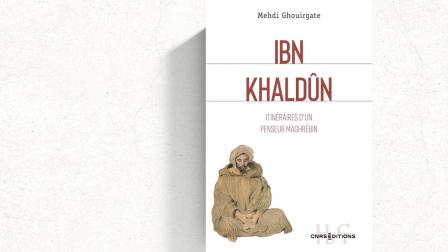كما تشيع ترجماتٌ، بعضها جديد، للقرآن بلغة موليير، تتسم عموماً بصرامة أقلّ من تلك التي ميّزت ترجمات أنجزها المستشرقون الفرنسيون، في القرن الماضي، مثل ألبير كازيمرسكي (1808-1887) ساعدَه عليها إدراكٌ لأسرار العربية الكلاسيكية ودقائقها، وهو الذي صاغ أحدث قاموسٍ مزدوج للضاد، وريجيس بلاشير (1922-1978) وقد اعتمد فيها دقة المنهج التاريخي في ترتيب نزول السور، في مسعىً لفهم صياغتها فَتَرجمها بناءً ليس فقط على دلالتها الأولى، التي شهدَت لها بالثبوت القواميسُ القديمة، وإنما على أسباب النزول وما أحاط بالآيات من معلوماتٍ سياقية، فكانت ترجمةً عالِمَةً، سار فيها صاحبها وفق النزعة الفيلولوجية.
وبعدهما جاك بارك (1910-1995) وقد تميّزت ترجمته باستحضار الخصائص الموسيقية والتصويرية للنص القرآني والحفاظ عليها، وجهد هذا العلَّامة في نقلها بأمانةٍ عبر اختياراتٍ له بديعة، وحتى توليد لكلماتٍ في الفرنسية مستحدثةٍ، تستعيد ما في مفردات العربية من دلالاتٍ حقيقية، واشتهرت عنه ترجمته كلمة: "كافر" بمقابلٍ فرنسيٍّ، Dénégateur يستدعي فكرَتَيْ الإخْفاء والنُكْر الموجودتيْن في مادة: كَفَرَ البائدة. ولا ننسى مساعيَ المستشرقة دينيز ماسون (1901-1994) التي عادت إلى ترجماتٍ لاتينية للقرآن تليدةٍ، فَمزجتها بما توصّلت إليه الترجمات الراهنة، وجهدت أن يكون نصُّها وفياً، فيه من طراءة العربية ودقة الفرنسية.
هذا، وفي المقابل، ثمة بعض العوالق والنزعات الاستشراقية، وحتى الاستعمارية، أساءت عمداً أو جهلاً إلى معاني النص القرآني، بما يخدم الموقف الرافض للإسلام واعتباره من انتحال التاريخ وكَتَبَتِه، فجَرى تمرير هذه الإيديولوجية، بما فيه من استعلاء، في اختيار مقابلات فرنسية، ومن أشهر من جَسَّدها أندري شوراكي (1917-2007). وغير هذه الأعمال عشراتٌ، لا يسع المجال لاستعراضها.
يدفعنا شيوع هذه الترجمات، وبعضها تجاريٌّ، وتلك التي تنشرها الشبكة الإلكترونية واللوحات والهواتف الذكية، إلى التساؤل، مرةً أخرى، عن قضية الترجمة الأبدية: مدى وفاء النص الناقل للأصل، خاصة وقد تعلق الأمر بالنصوص المقدسة، ذات البنية القَصصيَّة والدلالية المخصوصة، كما درسها محمد أركون ("قراءات في القرآن"، 1990).
وما يبرّر التساؤل ليس فقط انتشار هذه الترجمات وكثرتها واستخدامها في حالٍ من فوضى الترجمات، وإنما وقوف مؤسسات نشر وجمعيات وحتى دول لها علاقات - بعضها مشبوهة - بالقرآن وترجمته. وبما أنَّ الموضوع متشعب وَعْرٌ، فسنقتصر فيه على إشكال ترجمة معاني القرآن الحافة، وهو ما اصطلح عليه في الألسنية والأسلوبية بــ Connotation أي مجموع الدلالات التي تحيط بالكلمة، انطلاقاً من جذرها الدلالي، ومعناها الحقيقي، وما تحمله صيغها الصرفية، ثمَّ ما يتراكب عليها من التأويلات والإضافات التي تكتسبها خلال الترحال في دروب السجلات والسياقات.
وعليه، فكل مفردة في الكتاب، ومهما كان معناها الأول، هي عبارة عن مساراتٍ طويلة من التراكم والإحالات، وَظَّفها القرآن وجعلها من أوْجُه إعجازه، حسب مَنظور علماء الإسلام الذين اشتغلوا على "سرِّ فصاحته" كابن سنانٍ الخفاجي (1032ـ1073) وجلال الدين السيوطي في "مُعترك أقرانه" (1445-1505)، وتبعهم حتى المستشرقون فتبنوا هذا الرأيَ وأشهرهم: بلاشير في قسمٍ خَصَّصه لأسلوب القرآن، من مقدمته (1947)، وجاك بارك، في خاتمة ترجمته (1995).
ولكن أليست الترجمة نقلاً للمعنى المستقر أخيراً في سطح النص المغلق؟ أليست هي ذاتها اختياراً لهذا المعنى دون سواه؟ وهو يقصي بالضرورة التعددية المحتَمَلة، ويفرض على المفردة تأويلاً واحداً، يغمط حقَّ المعاني الأخرى في الظهور؟ وهو ما يَجعل متلقي النص يتعلق بالمقابل الفرنسي المترجَم، ولا يتعداه إلى طبقاته الدلالية وهي محفورةٌ في الصور والأخيلة.
ولاختبار هذه الفرضية يكفي أن نعالج كلمة "الحمد"، وهي مفردة وردت في القرآن، حسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لفؤاد عبد الباقي، ثمانيةً وثلاثين مرةً، وكلها ترجمت، بشكلٍ يكاد يكون آلياً وواحداً، في الفرنسية بـ Louange وفي الإنكليزية بـ Praise، وكلاهما لا يأتي على ما أشار إليه المعجميون العرب والمفسّرون من قيمٍ متصلة بمَعْنَى "الحمد"، نقيض الذم، ولا على ذلك الفصل اللطيف، الذي خَصَّصه لهذه المفردة، فخرُ الدين الرازي، في "مفاتيح الغيب"، مُبيناً الفرق بينها وبين المَدح والشكر والثناء والإشادة. وما أدق ما ذكره علماء النحو حول الإمكانيات الثلاث في إعراب هذه الكلمة، في جملة "الحمد لله"، نصباً ورفعاً وخفضاً، ولكلٍّ معنىً. وما أعسر أخيراً استعادة تقسيم أربابِ الإشارة "الحمدَ" إلى قوليٍّ وفعليٍّ وحاليٍّ. فكل هذه التعالقات التي انضافت عبر بوابة التأويل ومن الذاكرة التفسيرية والثقافية لا تحضر لدى التلقي العربي العفوي لها، ناهيك عن حضورها في الترجمة.
وهكذا، يقدّم هذا المثل السريع، على بساطته، نموذجاً بَيِّناً عن القَطيعة الدلالية بين النص القرآني وبين قارئه في خطابٍ مُترجَمٍ، ويظهر حجم الهوّة التي تفصله عن إدراك الأكوان الرمزية التي تتفجّر في النص المقدس. ولا بد من إجراء هذا التحليل على كل مفردات القرآن، وقد بلغ عددها، حسب إحصاء السيوطي، 17458 كلمةً من غير المكرّر. ولا مندوحةَ عن القول بالاستحالة.
بيدَ أنَّ الإيغال في رفض إمكانية الترجمة، مثل الإفراط في زعم التطابق التام بين النص الأصلي والمنقول إليه، وكلاهما من أوهام العقل، إذ حصول ترجمة النصوص الدينية دليل إمكانيتها، كما أكده عالم الترجمة جورج مونان (1910-1993)، ولكنَّ هذا الدليل لا يستلزم وفاءها في إعادة درجات المعنى وآفاق تشكله عبر التاريخ.
وهكذا يظلُّ الطريق إلى معاني القرآن غير معبّد، تحيط به أشواك القصور ومخاطر النقل. وتذليلها يكون بالوعي بوجودها، والعمل من ثمة على تجاوزها بما يتاح للعقل النقدي من أدواتٍ، وهذا من التدبّر الذي إليه دعا القرآن، ومن مظاهره إرفاق الترجمات بنصوص تأويلية تفسيرية تساعد على إيضاح مشكلاته وتقريب البعيدِ من استعاراته، ولا سيما أنَّ المجاز فيه غالب، والشبهات بسببه متراكمة، وحضورها امتحانٌ لأهل الإيمان، وكم أمتع المفسّرون بتدبيرات رفع إشكال المعنى وتناقضاته. جهود عربية أيضاً
جهود عربية أيضاً
لا يمكن إغفال ما أنتجه العرب والمسلمون من ترجماتٍ إلى الفرنسية، نَفذوا من خلالها إلى شيء من أسرار الوحي، كونهم استفادوا من تراث التفسير ووظفوا ثَرواتِه في اختيارات المعجم وتصاريف التركيب، فتلافوا أخطاء النقل الحَرْفي، وأشهرهم محمد حميد الله (1908-2002)، وسي حمزة بوبكر (1912-1995)، والصادق مازيغ (1906-1990)، وكلهم وفّق بين مقتضيات الإيمان وإكراهات الترجمة، وإنَّها لَمن عسير المُعادلات.