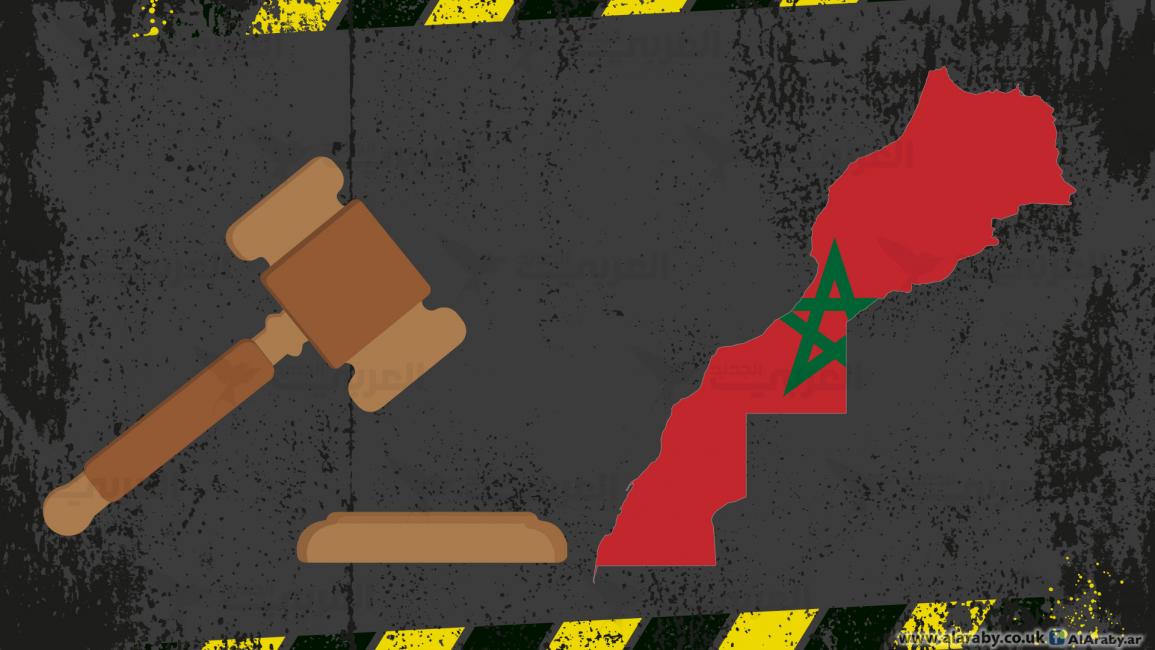أسئلة السياسة الجنائية في المغرب
لا يزال الرأي العام المغربي تحت وقع الجريمة الشنعاء التي شهدتها مدينة طنجة (أقصى شمال المغرب)، الأسبوع الماضي، وراح ضحيتها الطفل عدنان بوشوف (11 عاما)، بعد تعرّضه للاغتصاب والقتل. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة أسئلة كثيرة بشأن السياسة الجنائية المتبعة في المغرب، وصلتها بالسياسات العمومية الأخرى و''النموذج التنموي الجديد''.
وعلى الرغم من بعض الإصلاحات التي عرفتها منظومة العدالة في المغرب في غضون الأعوام الأخيرة، إلا أن ذلك لم يكن له تأثير على السياسة الجنائية التي بقيت تقليدية في محاورها الكبرى، في وقتٍ كان يُنتظر أن تنتقل إلى أطوارٍ أخرى، تغدو معها أكثر انفتاحا على المتغيرات المجتمعية الحاصلة، وقدرةً على حماية حق المجتمع، وضمان الحريات الأساسية، وحفظ السلم الأهلي والاجتماعي. وقد ظلت هذه السياسة مرتهنةً للجدليات التي تحكم الاجتماع المغربي، ولا سيما في ما يتعلق بجدلية التقليد والحداثة؛ فمن جهة، وعلى الرغم من كل ما يقال عن تحديث الترسانة القانونية المغربية في هذا الصدد، بقيت هذه السياسة وثيقة الصلة بالبنية المحافظة للمجتمع. ومن جهة أخرى، فرضت الالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب تحديثا متقطّعا في بعض مضامينها. ولعل ذلك ما يفسّر، ليس فقط غلبة المقاربة الزجرية (السلطوية) داخل هذه السياسة، وإنما أيضا تردّد الدولة في الحسم بشأن التوازن المفترض بين الحقوق والحريات الفردية، والمصلحة العامة للمجتمع، في ضوء مشروع تعديل القانون الجنائي، فقد باتت مطالبةً باجتراح صيغة قانونية متوازنة، تتيح لها الإمساك بالعصا من الوسط في مواجهة مجتمعٍ أنهكته التوترات الفكرية والقيمية.
التردّد في تبنّي سياسة جنائية ناجعة يجعل معدّل العودة إلى الجريمة في ارتفاع مضطرد، خصوصا في الجرائم المقترنة بالعنف، كما يؤثر على أداء الجهاز القضائي، في ظل ارتفاع كلفة الجرائم، وإخفاق السجون في القيام بدورها الإصلاحي. ويزداد المشهد قتامةً مع غياب برامج اجتماعية وثقافية للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي والنفسي لمرتكبي هذه الجرائم، سواء داخل السجون أو بعد الإفراج عنهم.
تقتضي أي سياسة جنائية متوازنة وفعالة اضطلاع المؤسسات المجتمعية الكبرى بأدوارها في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، فما جدوى استيراد المدونات الجنائية الدولية أو استنساخها من دون قيام الدولة والمدرسة ومؤسسات الوساطة بأدوارها في بناء المجتمع وتحصينه. ويمكن القول إن المغرب يخسر كثيرا بعدم إصلاح منظومة التربية والتكوين وترميم أعطابها، إذ يعني ذلك تحمّل مزيد من الأعباء الأمنية والمادية والاجتماعية، في مواجهة مجتمع يعرف تحولاتٍ متسارعة على غير صعيد.
انتبهت دول كثيرة إلى أهمية تعدّد مداخل مكافحة الجريمة والعنف الاجتماعي، فأصلحت التعليم، وجعلت الإعلام هادفا، واهتمت بوسائل التنشئة الاجتماعية، وشجّعت المجتمع المدني ليكون شريكا في إعادة بناء المواطن، وتوسيع مساحات التأطير داخل المجتمع من خلال استثمار طاقاته، ووازت ذلك كله بتدابير وقائية فعالة للحد من ارتفاع معدّلات الجريمة.
يُسجّل مؤشر الجريمة في المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ما يعدّ تحدّيا للمقاربة الزجرية والأمنية التي أضحت في حاجة للمراجعة وإعادة النظر والتقييم، فالمجتمع أصبح يُفرز أشكالا غير مسبوقة من العنف، خصوصا ضد الأطفال والنساء، ومن شأن الاستمرار في التعاطي مع هذه الظاهرة بوسائل تقليدية أن يُفاقم الوضع أكثر.
عودة عقوبة الإعدام إلى واجهة النقاش العمومي، بعد واقعة طنجة، فرصة لمراجعة السياسة الجنائية في جوانبها الفلسفية والقانونية والاجتماعية. ولا شك أن المزاوجة بين التنصيص القانوني على هذه العقوبة، وتعليق تنفيذها (نُفّذ آخر حكم إعدام سنة 1993)، تمثّل أحد العناوين البارزة للارتباك الواضح الذي يسم هذه السياسة، ويحول دون تطور مقتضياتها.
الإبقاء على هذه العقوبة، مع تعليق تنفيذها، لا يعدو كونه مناورةً معياريةً لتدبير الضغوط الوافدة من المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتدويرها، وذلك بما لا يؤثر على السياسة الجنائية المتبعة التي يُفترض أنها تحمي المصلحة العامة للمجتمع. ويعود إخفاق هذه السياسة في الحد من انتشار الجريمة داخل المجتمع إلى افتقادها رؤية سياسية وقانونية واجتماعية متكاملة، وعدم تقاطعِها مع سياسات عمومية أخرى، كفيلة بالقيام بأدوارها المفترضة في هذا الشأن.