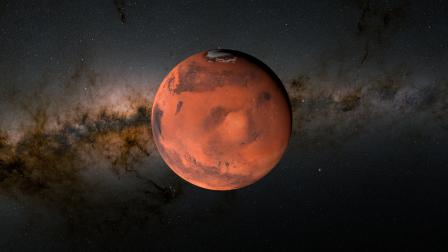علاء الدين الجم: سوريالية ساخرة (الملف الصحافي للفيلم)
شارك "سيّد المجهول" (2019)، للمغربيّ الواعد علاء الدين الجم، في المسابقة الرسمية للدورة 18 (29 نوفمبر/ تشرين الثاني ـ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2019) لـ"المهرجان الدولي للفيلم بمراكش". كوميديا اجتماعية عميقة، بلمسة سوريالية ساخرة، عن فائض الأولياء الصالحين في المغرب المعاصر. لزيادة عمقها، توضع الأحداث في أرضِ قدّيسٍ مجهول.
تعصر الكاميرا وحدة المكان إلى أقصى حدّ ممكن، لإظهار قبّة الوليّ، فوق الجبل، والشعب في السفح. يساعد المكان على تشكيل مناخ الحكاية بمصداقية. يصنع المخرج ديكورا يُخبِر عن مهنة وطبقة وممارسة راسخة في المجتمع المغربي. ففي كلّ قرية ومدينة مغربية وليّ يزوره ذوو العاهات، ويتبرّكون به. يُخدَم ضريحه، الذي يدرّ أرباحا. يزرع المخرج فيلمَه على تربة خصبة. الزرع في أرضية قاحلة مُضرّ بنموّ الزرع وتطوّر الحكاية. من يزرع جيدا يحصد كثيرا. الأرضية واعدة.
تعصر الكاميرا وحدة المكان إلى أقصى حدّ ممكن، لإظهار قبّة الوليّ، فوق الجبل، والشعب في السفح. يساعد المكان على تشكيل مناخ الحكاية بمصداقية. يصنع المخرج ديكورا يُخبِر عن مهنة وطبقة وممارسة راسخة في المجتمع المغربي. ففي كلّ قرية ومدينة مغربية وليّ يزوره ذوو العاهات، ويتبرّكون به. يُخدَم ضريحه، الذي يدرّ أرباحا. يزرع المخرج فيلمَه على تربة خصبة. الزرع في أرضية قاحلة مُضرّ بنموّ الزرع وتطوّر الحكاية. من يزرع جيدا يحصد كثيرا. الأرضية واعدة.
لتبرير التحوّل في المكان، يستخدم علاء الدين الجمّ لقطة قطع تغطّي زمنا كبيرا. قطع يُبرّر به عودة البطل (يونس بواب) إلى المكان نفسه لاسترجاع غنيمته. بعد العودة، يجد البطل أنّ القبر مركب، وأنّ القبر يتمأسَس. تظهر حوله نافورة مباركة وفندق وحارس وحجّاج. رغم هذا، يُخطّط البطل لانتهاك حرمة القدّيس. هكذا يتحدّد البطل وخصمه. يحثّ القدّيس على التقشّف، بينما يحبّ اللص الاستمتاع بالحياة، وهو جاهز لفعل أيّ شيء في سبيل ذلك. لذا، يوجد تناقض شامل بين نهج اللص ونهج الوليّ. هذه مقاربة تجعل الحبكة مشوّقة. بفضل هذا العمق الاجتماعي، تكتسب الحبكة طرافتها.
في انتظار الانتقال للفعل، يتمّ التعرّف على شخصيات جديدة.
يصل طبيب شاب إلى منطقة تعاني فائضَ حجر وقلّة مطر. يكتشف مغربا يسير بإيقاعات مختلفة للغاية. يندهش مما حوله: تلفزيون من القرن الماضي، وهاتف نقّال قديم، ومصباح غاز. شخصية الطبيب (أنس الباز) من صلب الحكاية، لأنّ الوظيفة الرئيسية للوليّ هي العلاج. يُتوقَّع أنّ يكون هناك تنافس بين المُعالِجَين، فأحدهما تقليدي والآخر حديث. لكن الفيلم يرسم للطبيب شخصية كاريكاتورية بائسة.
منذ ظهور الطبيب، تتعطّل الحبكة الرئيسية. يملأ الجمّ هذا الزمن بحشوة غير مترابطة، هي عبارة عن طرائف مختلفة عن الممرض والحلاق. لا صلة صراع أو تعاون بينهما وبين البطل.
في اللقطات التي يظهر فيها الطبيب والممرض (حسن باديدا)، هناك كوميديا لا صلة لها بالحبكة الرئيسية، تجعل الفيلم خفيفا، لأنّه يسمح للمتفرّج المديني بالإطلالة من علِ على مغرب غير نافع. يجري حوار كوميدي على حدود العبث، لكن في المستوصف فقط. يتفوّق باديدا في كل حركة يقوم بها. يصنع "ليتموتيف" الفيلم، وهو يسلّم الدواء للطبيب، بالحركة نفسها، مرات عدّة. التكرار يصير كوميديا. يرفع الممرض أداء الطبيب، ليصير كوميدياً ساخراً.
لكن، بعد ربع ساعة، تتعطّل الحبكة الرئيسية. يشتغل المخرج على شخصيات هامشية، كالحلاق والكلب وحارسه. عندما لا يعرض الفيلم الحلاق (أحمد يرزيز) والممرض، يظهر لصان عملاقان يخافان حارساً نحيفاً، تلتفّ ساقاه حين يمشي، لذا لا يفعلان شيئاً. ينتظران، ومع الانتظار يتولّد الملل، لأن السيناريو لم يستثمر الأرضية العَقَدية المزروع فيها. بين الدقيقتين 5 و90، لا معلومات جديدة عن البطل. لم يُطوّر السيناريو شخصيته لتتغيّر بسبب أفعاله. يبقى كما هو، بينما لا يتناوله مَنْ حوله بالتعليق لشرحه. يُركّز المخرج على شخصيات هامشية. هكذا تغلب الحشوةُ الحبكةَ. لذا، سيتذكّر الجمهور الكلب وصاحبه والممرض والمساعد الغبي، أكثر من البطل.
تحتفظ ملامح الممثل يونس بواب بشكل واحد طيلة الفيلم. حتى زمن السجن لم يغيّر شكله. يبقى وجهه على حاله. لا يتأثّر شكله بالزمن، ولا نفسيّته بالأحداث. طيلة الفيلم، ينظر غاضباً بالملامح نفسها. أين التمثيل؟ أين التغيّر تبعاً لفعل الزمن وتحوّل الوضعيات؟
على صعيد رسم الشخصيات، يتشابه القرويون، المستسلمون جداً. لم يمنحهم علاء الدين الجم وعياً معارضاً، لجعل المتفرّج يرى الواقع من زاوية جديدة. لذا، السرد مونولوغيّ لا حواري. حتى الطبيب يبدو متعايشاً مع الوليّ، وسلبياً تماماً. كأنّ علمه ودرسه لم يساعداه ليلاحظ مفارقة أن قبر القدّيس، الذي ينافسه في علاج زوّاره، يحتاج إلى كلب يحرسه. هذا طبيب بعيد من شخصية إسماعيل، خصم زيت "قنديل أم هاشم" (1940)، للمصري يحيى حقي. ينتهي "سيّد المجهول" بتكرار حدث البداية نفسه. الأولياء النكرات ظاهرة مغربية قديمة، يذكرها ابن الزيات مرات عديدة، في كتابه "التشوف إلى رجال التصوف" (1220 م.). الوليّ أكثر من عظام في قبر. في المغرب، هناك آلاف الأضرحة، لذا يسمّيه المستشرقون "بلد الشرفاء".
يُصدّر المغرب أولياء كثيرين إلى مصر، لا تزال لهم فيها قبب إلى اليوم. تُدرّ الأضرحة المغربية دخلاً، ويحوم حولها شرفاء ولصوص ومتبرّكون كثيرون، خصوصاً في المغرب العميق. أما في مغرب المدن الكبيرة، فيتراجع سلوك زيارة الأولياء، لكنّ قداستهم راسخة في الذهنية السائدة.
للإشارة: يظهر وزن الأضرحة في السينما المغربية مع "الزفت" (1984)، للمسرحيّ الطيب الصديقي، المقتبس من مسرحية "سيدي ياسين في الطريق". فيها، تأتي الدولة الحداثية بمشروع تعبيد طريق. يرسم المهندسون مسارها، فيتضح أنّه يجب هدم ضريح سيدي ياسين، لتمر الطريق مكانه. هل تسمح القبلية المحافظة بهدم الضريح أو نقله، لإنشاء طريق؟ القبيلة تقول: لا. فالوليّ يجلب البركة، والمس به يجلب اللعنة. في النهاية، يُغيّر مسار الطريق. هذا حلّ وسط. يحصل المغرب على طريق ملتوية. يبدأ جينريك "الزفت" بلقطة لأرضٍ قاحلة لا تُنبِت، يهطل عليها مطر. تتراجع الكاميرا إلى الخلف، فيتضح أنّها جمجمة شخص أصلع. واضح أنّ الزفت والجفاف هما في الدماغ، لا في الأرض.