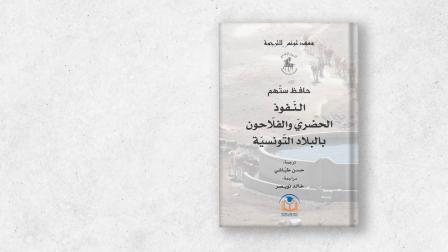محاولاً تجاوزَ "الفهم البرّي" للجذور التاريخية في الحضارة الغربية، يقيم المؤرّخ الأميركي جون. آر غيليس، ركائز عمله "الساحل البشري" الصادر حديثاً عن سلسلة "عالم المعرفة" بترجمة ابتهال الخطيب، مطلقاً حكمه على الحضارة الغربية بأنها مرتبطة بالأرض ومسجونة ذهنياً داخلها؛ حيث التخيّل الرئيسي للتاريخ الإنساني يبدأ وينتهي عند اليابسة، في حين كان موضع ولادة الحضارة، وبشكل مستقل عن الحضارات الداخلية، على السواحل.
غياب الأدلة على المواقع الأرضية، بسبب تذبذب مستويات البحر التي عملت على مدى الــ 150 ألف سنة الأخيرة على مسح علامات الاستيطان الإنساني، وتجاهلُ الجغرافيين سبعة أعشار سطح الكوكب من خلال تركيزهم على تاريخ اليابسة قبل أن "يبلّل علم الآثار قدميه"، كل ذلك أدى إلى ترسّخ "الفهم البرّي"، في حين ظلّ المحيط خارج كل من جغرافيا وتاريخ البشر، وكان علم المحيطات آخر العلوم الوليدة.
منذ الأساطير والحكايات الأولى حول البحر واليابسة، وأولى الجزر التي وُجدَ عليها الإنسان، يبدأ غيلس عمله؛ حيث فكرة جنّة عدن التي أتت كأساس أسطوري للمجتمع الزراعي، في حين كان معظم التطوّر الإنساني يحدث حيث تلتقي اليابسة بالماء، وتبعاً لذلك، يعتقد غيليس أن البشرية مطالبة بإعادة اكتشاف شعوب الساحل، بهدف إيجاد سردٍ تاريخي أقل تركيزاً على اليابسة؛ سردٌ يتبيّن العلاقة الطويلة للإنسانية بالبحر.
كانت الأرض اللاعب الرئيس في جغرافيا الكتاب المقدّس، ويظهر بالمقابل البحر كبيئة غريبة فيه، وكتهديد للبشرية من خلال ذاكرة الفيضانات والسيول والطوفان، حيث يلعب الماء هنا دوراً مدمّراً، في حين كانت اليابسة الملاذ والملجأ، لتبدأ رحلة الفزع من الماء والبحر عبر التاريخ. ومثل أتباع الديانات، كان الوثنيون هم أيضاً ينظرون إلى البحر باعتباره فراغاً مرعباً لم يروا فيه سوى الموت والخراب.
يضع غيليس يده على بداية تغيّر النظر للبحر على أساس شيطاني في بدايات القرن السادس عشر، حين اكتُشفَ أن الأرض ليس كما كان يُعتقد، بأنها جزيرة محاطة بنهر لا يمكن عبوره، بل مجموعة من الجزر والقارات المتّصلة، حيث بدأ البحر "يفقد صفاته الشيطانية". وسينتظر العالم أيضاً قرنين إضافيين لتتحول النظرة إلى الجزر، على أنها نقطة عبور نحو التطوّر، ومعها بدأت فكرة السواحل كعوائق تُستبعد شيئاً فشيئاً.

سيستعين غيليس هنا بوصف الجغرافي الإدريسي، في القرن الثاني عشر، من "أن أحداً لا يعرف ما وراء السواحل بسبب أن أحداً لا يجرؤ على قطع أو اختراق البحر"، للتدليل على أن النشاط البحري ظلّ أكثر قرباً إلى الشاطئ منه إلى عمق البحر. بعدها، يدخل غيليس المحيطات لا من خلال المتوسّط، الذي حضر في العقول ذات المركزية الأوروبية محوراً، رغم أنه ليس أكبر ولا أقدم المحيطات، بل يدشّن دخوله التحليلَ من خلال المحيط الهندي الذي عبره البشر منذ خمسة آلاف عام كنقطة انطلاق، حيث أبحر البشر أوّلاً من هناك.
ينتقل المؤرخ إلى المتوسط، حيث تطوّرت الحضارات الساحلية ببطء عن طريق تنقّلها على طول الساحل لا بالرحلات البعيدة عنه، أمّا سواحل الأطلنطي الشمالية ذات التأثير الأكبر، فقد تأخّرت في استقبال المكتشفين وحتى المسيطرين عليها، بسبب تجمّد الكثير من أجزائها الشمالية الغربية، والشمالية الشرقية، أمّا الشمال الأوروبي فقد حدّد هناك الماءُ اليابسةَ؛ فمع سقوط الإمبراطورية الرومانية تشكّلت "الدويلات البحرية" بالقرب من السواحل، عوضاً عن اليابسة. وأبعد من ذلك، كان لهذه السواحل ما يربطها ببعضها أكثر ممّا كان يربطها بأراضيها الداخلية.
ليست السواحل والمحيطات فحسب، إنما الأرخبيلات التي استمرت ثقافتها وأسلوب العيش فيها من دون انقطاع مقارنة بالأنظمة الزراعيّة الداخلية، وجدت ما يقوله عنها المؤرخ في عمله هذا، أما قول المؤرّخين من أن شعوب الساحل غير مرئية، فيُرجعه غيليس إلى صعوبة ملاحقة الشعوب المتحرّكة؛ حيث يؤشّر هنا على مغالطات المؤرّخين بالتعامل مع السواحل، كأماكن "يبدأ عندها التاريخ وينتهي، أهميتها تنحصر فقط في كونها عتبات" مكرّسين تفضيل الأرض على الماء، والشعوب الداخلية على تلك الساحلية".
هكذا، ظلت الشواطئ على الدوام مراكز للعالم، أمّا الآن وعندما أصبحت السواحل حدوداً لشيء آخر، لقارّات أو جزر، "أصبحنا لا نعيش فيها ولكن عليها"، حيث صارت العلاقة الحالية للإنسانية بالساحل علاقة غريب بغريب، وخلال نصف القرن الماضي، حيث استعمرت شعوب الداخل السواحل، تغيّرت البيئة بشكل جذري، ومعها تغيّرت طبيعة الشعوب الساحلية، إذ يعتقد غيلس أن شعوب السواحل ليست فقط مخلوقات حواف جغرافياً، وإنما نفسياً كذلك.
لا تقف المعلومات التي يقدّمها جون آر غيليس على البحث والتحليل، إنما شاركت تجربته الشخصية كساكن موسمي على شاطئ ولاية ماين، في الجزء الشمالي الشرقي لأميركا في إضفاء أسلوبه الخاص، مازجاً روح الأدب بالتاريخ، ومقتبساً من أعمال أدبية وشعرية وحكايات كلاسيكية عن البحر والساحل، وحتى من حكايات رحلات البحّارة في المحيطات.
اقرأ أيضاً: فيليب مانسيل: القسطنطينية في سيرة سلاطينها