عاد اسم الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، الذي تحلّ اليوم ذكرى ميلاده الحادية عشرة بعد المئة، إلى التداول في 2011 مع تبلور مقولة "الشعب يريد" ضمن أحداث الثورة في تونس ثم التقاطها في ساحاتٍ أخرى في مصر وليبيا واليمن وسورية. فقد درجت الإشارة إلى أنّ شعار "الربيع العربي" مقتبس من البيت الافتتاحي لقصيدة "إرادة الحياة" (1933). أتت هذه العودة بعد خروج الشابي (1909 - 1934) تدريجاً من المدوّنة النقدية، وهو الذي عَرف قبل ذلك اشتغالاً نقدياً، مبالغاً فيه أحياناً، على نصوصه وحياته.
رغم كل ذلك، يبدو الشابي غائباً، أو بعبارة أدقّ غير مقروء، وقد يفسّر ذلك - للمفارقة - الحضورُ المكثّف للنقد حول شعره بين خمسينيات وثمانينيات القرن الماضي، فقد بدا وكأنما جرى استهلاك مدوّنته نقدياً، وإن جرى ذلك بكثير من تشابه المقاربات والقراءات، ثم أتى زمن من الانسحاب المفاجئ من عوالمه، وصولاً إلى اختزاله في بيت واحد من أبياته بعد 2011. كلّها حالات من الهجر وعدم القراءة تتعدّد أشكالها ولكنها تؤدّي إلى النتيجة نفسها.
توجد بلا شكّ أسباب أخرى لهذا الهجر، بعضها يتعلّق بالسياق التونسي؛ حيث إن تكريس الدولة للشابي من خلال المدرسة وحضوره في مفردات الخطاب الرسمي (مثل إضافة بيتين من القصيدة نفسها إلى النشيد الوطني "حماة الحمى") أنتج نفوراً منه ضمن نفور أوسع من مقولات الدولة جميعها وانسحاب الشعب منها بشكل تدريجي. لكن أيّ ذنب للشابي في ذلك؟ فالأمر متعلّق بمنطق التوظيف، والدولةُ توظّف الشعراء كما توظف النقّاد والصحافيين والتشكيليين والمسرحيين وغيرهم، سواء كانوا من الأحياء أو الأموات.
يتعلّق الأمر أيضاً بسياقات الثقافة العربية في مجملها. فمثلاً جرت مياه كثيرة تحت جسر الكتابة الشعرية العربية، ومن البديهي أن تتحوّل قصيدة الشابي إلى قطعة متحفية ما لم تجد قارئاً يمدّها بأسباب الحياة الجديدة، والأرجح أنها لم تجد ذلك القارئ، فقد جرى الاكتفاء بما كُتب عنه لسنوات، على تشابهه، واختُزلت التجربة في لافتات كبيرة كرّستها القراءة المدرسية مثل تجديد الشعر العربي، ومقولة الكلمة كأداة مقاومة للاحتلال، وعبقرية الشاعر الذي رحل في العقد الثاني من عمره.
لكن ماذا لو قرأنا "أغاني الحياة" كما نقارب النصوص اليوم بغضّ النظر عن تصنيفاتها الجاهزة، أن نقرأه مثلاً كما تُقرأ قصيدة النثر، أو النثر بشكل عام؟ ماذا لو قرأنا سيرة الديوان بعيداً عن سيرة الشاعر؟ ماذا لو وضعنا فرضية تقول بأن الشابي - لو أُتيح له الأمر - كان سيُسقط من ديوانه ما هو شعر تدريبي لا غير، ولعلّه كثير، وهي فرضية يسندها أن الشاعر لم يشرف على طباعة ديوانه؛ حيث صدر بعد رحيله بقرابة عقدين. أليس حريّاً بنا أن نقرأه، بالتالي، قراءة تُسقط الكثير من القصائد التي كان الشاعر سُيسقطها بنفسه لو أشرف على نشر ديوانه؟
من المهم فهم سياق تاريخ ولادة "أغاني الحياة" ككتاب، فقد أتى خلال مرحلة انتقالية من تاريخ تونس، في آخر سنة من الاستعمار الفرنسي، وكان على دولة الاستقلال الناشئة أن تجمع مفردات مبعثرة هنا وهناك لصياغة وعي شعبي متجانس، وقد وجدت في الشابي - خصوصاً في شعره الوطني - بعضاً ممّا تريد، فصار مادّةً ضمن تشكيلة الخطاب الرسمي، إضافة إلى غياب مدوّنة أخرى تفي بالغرض نفسه؛ فلا يخفى أن معظم الشعر التونسي آنذاك كان تقليدياً ولا يخدم "المشروع الحداثي" الذي تقول به دولة الاستقلال. وفي السياق نفسه، خدم رحيلُ الشاعر المبكّر نصّه، فهو ممّن يمكن الاستثمار الرسمي فيهم دون أن يحرجوا أسطورة "الأب المؤسّس" (الرئيس بورقيبة).
تهيّأت كل هذه الظروف لـ"أغاني الحياة" كي يصبح موضوع استثمار رسمي، وهنا ظهر عدد من النقّاد لتلبية طلب استشعروا أن الدولة قد فتحته، لنشهد موجة من الكتابات حول الشابي وعبقريته المبكرة، وصولاً إلى الاستقصاء عن قصة كل قصيدة من قصائده والبحث عن بقايا مخطوطاته وكأنها ستنير أجزاءً أخرى من عوالمه الشعرية، غير أن تلك الإضافات التي ظهرت في طبعات ديوانه اللاحقة لم تكن سوى تشتيت أكبر للقارئ ومزيدٍ من خنق الجيّد في شعر الشابي. بهذا أصبح "أغاني الحياة" ديوان الدولة التونسية بقدر ما هو ديوان الشابي.
على مستوى التصنيف، وُضع شعر الشابي بكثير من الطمأنينة المريحة ضمن المدرسة الرومنطيقية انطلاقاً من معجمه الذي يزخر بمفردات الطبيعة وتخلّصه التدريجي من أثر الشعر العربي القديم وعدم تشابهه مع المدرسة الإحيائية في مصر، من محمود سامي البارودي إلى أحمد شوقي، ثم لتقاربه مع جماعة "أبولو" التي راسلها فأحدث شعره صدى في المشرق. لكن ما الذي يفسّر هذا الخيار العفوي بولوج عالم الشعر من خلال الرومنطيقية؟
هنا لا بدّ من نسيان المكانة التي حظي بها الشاعر بعد رحيله، ورغم غياب تأريخ دقيق للحياة الثقافية في تونس في فترة ما بين الحربين، فإنّ من السهل أن نعرف أن الشابي فهم مبكّراً أن أخذ موقع متقدّم في المشهد الثقافي ليس من السهولة بمكان، بسبب قدرة النخب على تسييج مساحتها من جهة ونفوره من العقلية السائدة داخلها من جهةٍ أُخرى، ولو جرّب هذا التوجّه لعلّه كان سيواجه ما عاشه صديقه الطاهر الحدّاد من تضييق وتدمير نفسي. هكذا اتجه الشابي نحو فضاء مختلف بحثاً عن اعتراف، فكانت جماعة "أبولو" ومن ورائها الشعر الرومنطيقي، فاستثمر لغته في هذا الاتجاه ضمن طقوس العبور المعروفة داخل هذا التيار الفنّي على مستوى المعجم أو المواضيع.
لكن ماذا لو نظرنا إلى شعر الشابي من زاوية نثرية بحتة، سردية أساساً؟ نقف مع الشابي على خط تصاعديّ، إذ نجح بالتدريج في التخلّص من أثر التصنّع في شعره بعد تجارب متنوّعة على مستوى العروض والقافية لم يكن من الممكن أن تذهب إلى أقصى ممكناتها في فترة وجيزة، والأهم من ذلك أنه نجح في نصوصه الأخيرة في وضع قدمه على طريق تجاوز الرومنطيقية التي تعتمد على "برنامج سردي" - بعبارة المنظّر الروسي الفرنسي ألجيرداس جوليان غريماس - وحيدٍ وثابت، وهو أن شخصية المتكلّم في القصيدة (لا تطابق بالضرورة المؤلّف) تقوم على مخطّط الهروب من المجتمع إلى الطبيعة، الغابة والبحر والليل أساساً، ثم الانتقال إلى تأمّل في النفس بثيمات معروفة مثل الطفولة والحب.
سينكسر هذا البرنامج السردي عند الشابي في عدد قليل من القصائد، وهي بالمناسبة قصائده الأساسية؛ مثل: "الاعتراف"، و"فلسفة الثعبان المقدّس"، و"الدنيا الميتة"، و"الصباح الجديد"، و"إرادة الحياة". مثلاً أحسن الشابي في "النبي المجهول" توظيف المعجم الطبيعي في مقولة ناجعة ضمن سياقها السوسيوسياسي، وفي "نشيد الجبّار" نلمس انتقالاً أشمل في الشخصية الضمنية للشاعر يشبه انتقال الرومنطيقية الأوروبية بصورتها المعروفة في منتصف القرن التاسع عشر إلى فكرة الإرادة والفعل لدى نيتشه في نهاية القرن نفسه، ولعلّ الشابي التقط هذا الخط عبر قراءة جبران خليل جبران وتأثّره هو الآخر بنيتشه والاستناد إليه للخروج من الرومنطيقية بشكلها القديم إلى أفق أدبي أوسع.
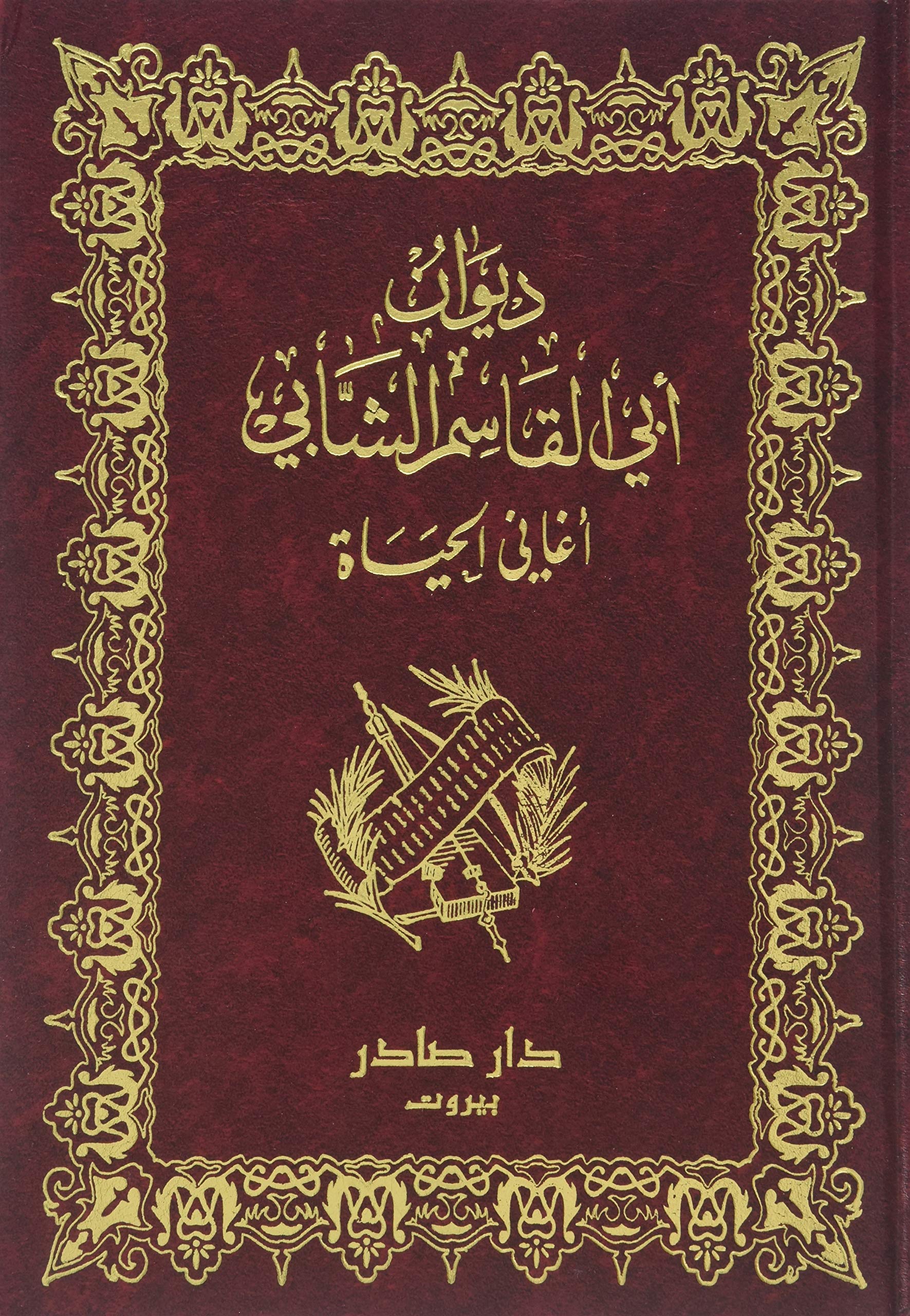 حين وقف أبو القاسم الشابي عند آخر عتبة من عتبات الرومنطيقية وبدأ يشعر بأنها كرؤية للعالم لا يمكنها أن تمثّل مرجعية في تطوير النص الشعري ومن ورائه المجتمع، توقّفت به الرحلة، فلا نعرف أيَّ مسار كان سيأخذه شعره. لكن من المفيد اليوم أن نتساءل عن وعي مثقّفي ذلك العصر، ومن بينهم الشعراء، بالمدارس التي يُصنَّفون داخلها، وتمثّل الرومنطيقية إشكالية مزدوجة على اعتبار أنها كانت تُقدَّم كـ"حداثة" ذلك العصر، في حين أنها في الوقت نفسه كانت منتهية الصلاحية منذ عقود في أرض نشأتها الأولى، تاركةً مكانها لتيارات جديدة.
حين وقف أبو القاسم الشابي عند آخر عتبة من عتبات الرومنطيقية وبدأ يشعر بأنها كرؤية للعالم لا يمكنها أن تمثّل مرجعية في تطوير النص الشعري ومن ورائه المجتمع، توقّفت به الرحلة، فلا نعرف أيَّ مسار كان سيأخذه شعره. لكن من المفيد اليوم أن نتساءل عن وعي مثقّفي ذلك العصر، ومن بينهم الشعراء، بالمدارس التي يُصنَّفون داخلها، وتمثّل الرومنطيقية إشكالية مزدوجة على اعتبار أنها كانت تُقدَّم كـ"حداثة" ذلك العصر، في حين أنها في الوقت نفسه كانت منتهية الصلاحية منذ عقود في أرض نشأتها الأولى، تاركةً مكانها لتيارات جديدة.
الإجابة عن سؤال كهذا قد تساعد في بناء علاقة أكثر جديّة مع تيارات تعبُر الأدب والفن اليوم، من قبيل ما بعد الحداثة والنسوية والديكونيالية.



