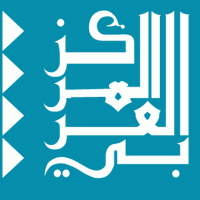24 أكتوبر 2024
حدود التدخل العسكري الروسي في سورية.. وآفاقه
بوتين والأسد لدى توقيع اتفاقية تعاون في موسكو(25 يناير/2005/أ.ف.ب)
بعد أن أعطت روسيا إشارات متعدّدة، توحي باستعدادها دعم جهد التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية، عادت إلى تأكيد موقفها الرافض تنحي الرئيس السوري، بشار الأسد، جزءاً من عملية انتقالية، نصّ عليها بيان "جنيف 1". كما تبيّن أنّ المرونة التي أبدتها روسيا، طوال السنة الماضية، لم تكن سوى تكتيكات سياسية، هدفت من خلالها إلى امتصاص النجاحات العسكرية التي كانت تحققها المعارضة المسلحة السورية على الأرض من جهة، واستخدام اتصالاتها بالمعارضة غطاءً للتمويه على توجّهها المضمر لرفع مستوى دعم النظام السوري، والذي جرت ترجمته، مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، بتدخلٍ عسكري مباشرٍ، ينذر بتداعيات سياسية وعسكرية كبيرة.
تحتفظ روسيا بوجود عسكري قديم في سورية، يشمل عشرات من جنود البحريّة في قاعدة طرطوس التي يستخدمها الروس، بين فترة وأخرى، منصةً للتزوّد بالمؤن والوقود، كما تحتفظ بمستشارين ومدربين تتفاوت التقديرات بشأن أعدادهم، وتتراوح في الغالب بين خمسمئة إلى ألف مدربٍ ومستشارٍ عسكري، ويوجدون في مواقع بحثية أو قطع عسكرية أو منشآت تصنيع عسكري. ومع أنّ موسكو عدّت تدّخلها الراهن امتدادًا لوجودها القديم، فإنّ صور أقمار صناعية نشرتها وسائل إعلام مختلفة تظهر بدء العمل على إقامة قاعدة عسكرية روسية في مطار حميميم (باسل الأسد) الذي يبعد نحو 22 كيلومترًا إلى الجنوب من مدينة اللاذقية، ويجري توسيع مدارج المطار وتأهيله، لاستقبال طائرات الشحن الكبيرة، وتجهيز مساكن مسبّقة الصنع لإقامة الجنود. كما أرسلت موسكو ست دبابات حديثة من طراز T-90، و15 مدفع هاوتزر، و35 ناقلة جند مدرعة، و200 جندي من مشاة البحرية الروسية إلى القاعدة الجديدة لتأمين الحماية لها.
وعلى الرغم من أنّ روسيا تصرّ على أنّ طبيعة وجودها العسكري في سورية لم تتغير، وأنّ معظمه يتشكل من "خبراء يقدمون المساعدة في ما يتعلق بإمدادات الأسلحة الروسية إلى سورية التي تهدف إلى محاربة الإرهاب"، فإنّ حركة طائرات الشحن الروسية توضح أنّ التدخل العسكري الروسي في سورية يتعاظم يومياً، ويأخذ أشكالًا مختلفة: قوات خاصة، وتدخل سريع، وخبراء، ومدربون، ومستشارون، بالإضافة إلى مدِّ النظام السوري بمعدات وأسلحة ذات قدرات تدميرية عالية، استخدمت في قصف مدينتي الرقة وحلب في الأيام القليلة الماضية. كما نشرت مواقع معارضة سوريّة، أخيراً، مقاطع فيديو تُبيِّن مشاركة قوات روسية في قصف مواقع عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة في جبال اللاذقية (ما أصبح يسمى التركمان والأكراد). وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صور لجنود روس في بعض نقاط المواجهة العسكرية في جبال الساحل (صلنفة) وسهل الغاب.
دوافع التدخل
وفرت روسيا على مدى السنوات الخمس الماضيّة، أي منذ اندلاع الثورة، غطاءً سياسيًا ودبلوماسيًا فعالاً، حمى النظام السوري من أشكال الإدانة القانونية والسياسية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى الرغم من مشاركتها في صوغ بيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012 الذي نصّ على تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة، خطوة لازمة وضرورية على طريق حل الأزمة سياسياً، سعت روسيا إلى فرض تفسيرها الخاص للبيان، من خلال الإصرار على اعتبار الأسد جزءاً من المرحلة الانتقالية، ثم ربط مصيره وبقائه "بإرادة الشعب". في هذه الأثناء، أخذت موسكو على عاتقها مهمة تقسيم المعارضة وشرذمتها على نحو أوسع، كما سعت إلى تفريغ الاعتراف الدولي بالائتلاف الوطني المعارض، باعتباره ممثلاً لقوى الثورة والمعارضة، من مضمونه، ودعت إلى مؤتمرات حوارية (موسكو 1، و2) بغية تصنيع معارضات أقرب إلى مواقفها. بيد أنّ المكاسب التي حققتها المعارضة المسلحة، في النصف الأول من عام 2015، أفشلت هذه المساعي، ودفعت باتجاه تحركٍ دبلوماسي نحو السعودية خصوصًا.
وتحت عنوان محاربة "إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية - داعش"، دعت موسكو إلى إنشاء تحالفٍ عريضٍ، يضم إلى جانب النظام السوري، "المُطعّم" ببعض المعارضة، كلًا من السعودية وتركيا والأردن. ولهذا الغرض، نجحت موسكو في ترتيب اجتماعٍ بين المسوؤل الأمني السوري الأول، اللواء علي مملوك، ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة في يوليو/تموز الماضي. ولما فشلت المساعي الروسية في تحقيق أي نتيجةٍ على صعيد إقناع السعودية بقبول الصيغة الروسية للحلّ في سورية، بدأت روسيا تدّخلها المباشر إلى جانب النظام، منعاً لانهياره بشكل مفاجئ، بعد أن بلغ مرحلة متقدمة من الضعف والإنهاك على يد فصائل ذات توجهات إسلامية معادية للنظام ولتنظيم "داعش" في آنٍ معاً، بما يؤدي إلى فقدان موسكو جميع استثماراتها السياسية في الأزمة السورية، وفي ظل مؤشرات كثيرة أيضاً على أنّ موسكو تفقد نفوذها بشكل متزايد في المناطق التي يسيطر عليها النظام، لمصلحة إيران وحزب الله.
اختارت روسيا ظرفاً إقليمياً ودولياً ملائماً لتدخلها، وبرّرته بعجز التحالف، بعد عامٍ على بدء ضرباته في سورية، في إضعاف "تنظيم الدولة"، وفشل أميركا في تدريب شريك ميداني مقبول وتجهيزه لمواجهته على الأرض. وللتغطية على تدخلها إلى جانب النظام، عرضت موسكو على واشنطن التنسيق في "الحرب على الإرهاب" في سورية، وهو عرض لم تملك إدارة أوباما التي يتملّكها هاجس مواجهة تنظيم "داعش" أن ترفضه. وزيادة في طمأنة واشنطن، قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بتنسيق خطواته في سورية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مؤشرٍ جديدٍ آخرَ على عمق العلاقة والتعاون التي تربط موسكو وتل أبيب، والتي كانت محطة بوتين الخارجية الأولى، بعد إعادة انتخابه عام 2012.
كما تزامنت الخطوة الروسية مع موجة لجوء كبرى إلى أوروبا، من المهجّرين السوريين، أفرزت خطاباً أوروبياً جديدًا (ألمانيا، والنمسا، وإسبانيا، وبريطانيا، والمجر) يدعو إلى التعاون مع روسيا، لإيجاد حلٍ عاجلٍ، يوقف تدفق اللاجئين، حتى لو تطلب ذلك الانفتاح على الأسد أو التخلي عن مطلب رحيله في المدى المنظور. إقليمياً، استغلت روسيا انشغال الدول الداعمة للمعارضة السورية بمسائل أخرى أكثر إلحاحاً لتمرير تدخلها، من دون ردود فعل كبيرة؛ إذ تنشغل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا في حربها ضد حزب العمال الكردستاني، وبانتخابات مبكرة مفصليّة، في حين يمثل الملف اليمني أولويةً قصوى، بالنسبة إلى السعودية ودول الخليج الأخرى.
التداعيات والنتائج
على الرغم من شعور القوة الخادع الذي يبديه النظام السوري، إثر شيوع أنباء التدخل العسكري الروسي لمصلحته، وتصريحات مسؤوليه عن "قلب الطاولة"، وتغيير المعادلات العسكرية والسياسية، فإنّ التدخل الروسي لن يصنع فارقاً كبيراً في موازين القوى القائمة حالياً كون هدفه يبقى محصوراً في منع سقوط النظام، وليس استعادة ما خسره النظام من أراضٍ ومدنٍ في الفترة الماضية؛ فهذا أمر عجزت عن فعله إيران، وجميع المليشيات الطائفية التي تعمل لحسابها. كما أنّ التدخل الروسي سيظلّ مقتصراً على الأرجح على دمشق ومنطقة الساحل التي توليها روسيا أهميةً خاصةً، بوصفها منفذاً بحرياً على البحر المتوسط، وتمتلك فيها امتيازات حصرية (25 عامًا) تسمح لها بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السوريّة، وذلك بحسب الاتفاقية الموقعة بين النظام والحكومة الروسية في أواخر عام 2013. وبناءً عليه، قد يساهم التدخل الروسي في تعزيز مواقع النظام ومنع سقوطه، وفي رفع الروح المعنوية المنهارة لقواته وحاضنته الشعبية، وفي عرقلة مساعي المعارضة للسيطرة على الساحل وجباله اللصيقة بمنطقة سهل الغاب، لكنه لن ينجح أبداً في إعادة النظام إلى المناطق التي خرجت عن سيطرته، كما أنه يصعب تخيّل تدخلٍ عسكري روسي برّي في مناطق تسيطر عليها المعارضة. وبهذا، سوف يؤدي التدخل الروسي فحسب إلى إطالة أمد الصراع، وزيادة معاناة السوريين من الفئات كافة.
وإذا ما تجاوزنا التداعيات الميدانية، فإنّ روسيا تحاول، من تدخلها العسكري، فرض رؤية جديدة للحل، تنسف بيان "جنيف 1"، وتربطه، بحسب تصريحات بوتين أخيراً، بانتخابات برلمانية "مبكرة"، وتشكيل حكومة تضم ما أسماها "معارضة رشيدة" تحت قيادة الأسد. وجاءت تصريحات وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أخيراً عن إمكانية بقاء الأسد في مفاوضات تستمر فترة غير محددة، لتزيد من مخاوف المعارضة السوريّة، لجهة رضوخ الولايات المتحدة والدول الغربيّة للرؤية الروسية حول سبل حل الأزمة في سورية، وقبول مقترحها القيام بالمهمة المستحيلة، المتمثلة بإعادة تأهيل النظام، واعتماده شريكاً ميدانياً في الحرب على تنظيم الدولة.
وأخيراً، تواجه المعارضة السورية مستجدات سياسيّة وعسكريّة، لا تصبّ في مصلحتها. ولمواجهة ذلك، تحتاج المعارضة إلى توحيد الجهد السياسيّ والعسكريّ في تيارٍ واحدٍ، ذي أذرعٍ عسكرية وسياسية وإعلامية، والتعامل مع الوجودين العسكرييّن، الروسي والإيراني، بوصفهما احتلالًا أجنبيًا مباشرًا وصريحًا، كما تحتاج إلى إطلاق نوعٍ من حركة تحررٍ وطنيّ، ذات برنامجٍ ديمقراطي موحدٍ، لقطع الطريق على محاولات تسويف نضال الشعب السوري وتضحياته، واعتماد حلولٍ جزئيةٍ لا تلبي طموحاته وأهداف ثورته، والتوجه إلى مقاومة الوجود العسكري الروسي، بجميع الوسائل المتاحة، وخصوصاً أنّ الرأي العام الروسي يبدو شديد الحساسية تجاه خسائر ومغامرات في مناطق وأزماتٍ، لا تشكل بالنسبة إليه أولوية، بل تعيد إليه ذكريات أفغانستان المريرة.