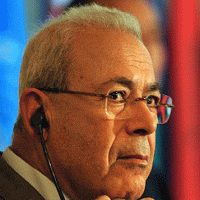11 نوفمبر 2024
لم تنته الحرب والأسد خاسر
دمار في حمص جراء قصف النظام (مايو 2014 أ.ف.ب)
يستغل النظام السوري نتائج حرب التجويع التي فرضها على المدن والقرى التي خرجت عن سيطرته، والاتفاقات التي تمت مع بعض الفصائل المقاتلة، ليوحي للسوريين، والعالم، بأنه في طريقه إلى ربح الحرب، وفرض إرادته من جديد على الشعب الذي طالب بإسقاطه، كما لم يحصل لأي رئيس.
يحذو حذوه صحفيون عرب وأجانب لم يصدّقوا ما حصل من مقاومةٍ بطوليةٍ للشباب السوريين، وآخرون ممن لم يؤمنوا أصلاً بالثورة، ولم يصدق أحد منهم أن شعباً يمكن أن يقاوم همجية نظام، كالنظام السوري، وينتصر عليه. وجميع هؤلاء يكرسون مقولة النظام إن خروج المقاتلين من حمص نصر مؤزر له، وبداية مرحلة استعادة نظام القتل والاغتيال والتعذيب بالجملة سيطرته على مقاليد الأمور في البلد الذي لم يبقِ منه حجراً على حجر وهجر نصف سكانه، وقتل ما استطاعت أسلحة حلفائه أن تفعل.
ومما يعزز هذا الانطباع الذي يريد فرضه على السوريين والعالم مسرحية الانتخابات الرئاسية التي نظمها، كما كان ينظم دائماً هذا النوع من الانتخابات التي يقرر جهاز الأمن، المختص بالتزوير، كل شيء فيها: شعارات الحملة الانتخابية لجميع المرشحين، ونسبة المقترعين، ومحتوى صناديق الاقتراع، ونتائج الانتخابات، قبل أن تطأ قدم مقترع واحد غرف الاقتراع.
يمنّي النظام السوري نفسه بالنجاح في الخداع الإعلامي والسياسي في ما عجز عن تحقيقه بقوة السلاح، وبالتدخل العسكري الواسع النطاق لثلاث دول مجاورة، وبتغطيةٍ دوليةٍ من روسيا، ودول أخرى وجدت في مشاركتها في النزاع السوري فرصة لتعزيز موقفها الإقليمي والدولي.
على الرغم من كل الدعاية الخادعة، لم يحقق النظام السوري أي نصر، لا في حمص ولا في غيرها، لكنه يحاول اللعب على مشاعر الإنهاك الذي سببه للشعب، من أجل بث اليأس في قلوب خصومه، وزرع الأمل الكاذب في قلوب الموالين له، وتعزيز جبهتهم المهددة بالتفكك والانهيار، بعد ثلاث سنوات من القتل والانتحار وتنامي الشعور بالخسارة وضياع الأمل والمستقبل.
لحمص رمزيتها الكبيرة، بالتأكيد. لكن، لم يحسم خروج مئات المقاتلين منها الحرب، ولا أنهى المفاجآت الكبيرة التي ينتظرها الجميع. في المقابل، من الصحيح أن هذا الخروج الذي يعيد إلى الذاكرة سيرة مقاتلي الثورة من بابا عمرو ومن القصير ويبرود، وغيرها من الأحياء والمدن الكثيرة، يختتم حقبة من الحرب، اتسمت بالانعدام الكامل للتوازن بين مسلحي المعارضة، المؤلفة بأغلبيتها الساحقة من المدنيين، وجيش نظامي مدجج بالسلاح، من رأسه حتى أخمص قدميه، كما اتسمت بسيطرة أساليب قتالٍ تعود إلى حروب المقاومة الشعبية المعروفة. وهو يفتتح حقبة جديدة من الحرب التي ستتخذ بشكل أكبر طابعاً عسكرياً منظماً، ويكون فيها لعوامل المبادرة والهجوم والتسلح النوعي الدور الأول في تغيير منحى الصراع، وتقرير مصيره. وفي هذه الحقبة، التي بدأت بالكاد، ليس من الضروري أن تبقى المبادرة بيد الميليشيات الأجنبية التي يعتمد عليها النظام، ولا أن تستمر هذه الميليشيات في احتكار التفوق في السلاح النوعي، أو في النجاح في تجنيب مناطق ولائها الحرب، أو تأمينها ضد الهجمات التي ستزداد أكثر فأكثر مع الوقت. وإذا توفرت المساعدات، تستطيع المعارضة أن تراهن على تطوع وتدريب مئات آلاف الشباب الذين شرّدتهم ميليشيات النظام، والذين لن يكون أمامهم أي مخرج من حالة التشرد والفقر والضياع سوى العودة إلى بلادهم، واستعادة وطنهم الذي أبعدوا عنه بالعنف والقهر والعدوان.
مهما كان الأمر، يعيش نظام الأسد، والأسد نفسه، آخر أحلام اليقظة التي اعتادوا عليها. وهم يخفون، وراء الحديث الاجوف والمكرور عن انتصاراتٍ وهمية، وإنجازات تذكّرنا بكلمة "خلصت" التاريخية، قلقهم وخوفهم من المرحلة المقبلة التي ستبدأ فيها مفاوضات الكبار، بعد أن وصل كل منهم إلى جزءٍ على الأقل من رهاناته. وسيكون رأس الأسد وزبانيته المقربين الثمن الوحيد، الممكن لأي تفاهم إقليمي ودولي، سواء جاء ذلك لصالح تحقيق مطالب الشعب السوري، أو من دونه.
يمثل الأسد اليوم أمام السوريين والعالم آخر أدواره الهزلية/المأسوية على مسرح السياسة السورية والإقليمية، ويبدو، وهو يحتفي بنصره العسكري والسياسي على الثورة الأنبل في التاريخ، ألعوبة لا حول لها ولا قوة، في قبضة حلفاء شرهين مستعدين في أي لحظة لبيعه وشرائه. وينتظر الجميع، اليوم، الأطراف الداخلية والخارجية التي شاركت في الجريمة، الإعلان عن نهاية اللعبة، للبحث عن كبش المحرقة المثالي الذي سيعلقون عليه جرائمهم وانتهاكاتهم. ومنذ الآن، يشكل الإعداد لتقديم ملف النظام إلى محكمة الجنايات الدولية الخطوة الأولى على طريق نصب المشنقة التي تسعى المجموعة الدولية، التي تواطأت سنوات مع العنف ضد الشعب السوري، إلى استخدامها لتبرئة نفسها، ودفع التهم عنها. ولن يتحقق ذلك إلا بجعل الذين خانوا شعبهم، وفتحوا أبوابه لأعدائه، كي يحتفظوا بسلطانهم، أول ضحاياها. وسيكون هذا أقل من القليل مما يستحقونه من عقاب.
يحذو حذوه صحفيون عرب وأجانب لم يصدّقوا ما حصل من مقاومةٍ بطوليةٍ للشباب السوريين، وآخرون ممن لم يؤمنوا أصلاً بالثورة، ولم يصدق أحد منهم أن شعباً يمكن أن يقاوم همجية نظام، كالنظام السوري، وينتصر عليه. وجميع هؤلاء يكرسون مقولة النظام إن خروج المقاتلين من حمص نصر مؤزر له، وبداية مرحلة استعادة نظام القتل والاغتيال والتعذيب بالجملة سيطرته على مقاليد الأمور في البلد الذي لم يبقِ منه حجراً على حجر وهجر نصف سكانه، وقتل ما استطاعت أسلحة حلفائه أن تفعل.
ومما يعزز هذا الانطباع الذي يريد فرضه على السوريين والعالم مسرحية الانتخابات الرئاسية التي نظمها، كما كان ينظم دائماً هذا النوع من الانتخابات التي يقرر جهاز الأمن، المختص بالتزوير، كل شيء فيها: شعارات الحملة الانتخابية لجميع المرشحين، ونسبة المقترعين، ومحتوى صناديق الاقتراع، ونتائج الانتخابات، قبل أن تطأ قدم مقترع واحد غرف الاقتراع.
يمنّي النظام السوري نفسه بالنجاح في الخداع الإعلامي والسياسي في ما عجز عن تحقيقه بقوة السلاح، وبالتدخل العسكري الواسع النطاق لثلاث دول مجاورة، وبتغطيةٍ دوليةٍ من روسيا، ودول أخرى وجدت في مشاركتها في النزاع السوري فرصة لتعزيز موقفها الإقليمي والدولي.
على الرغم من كل الدعاية الخادعة، لم يحقق النظام السوري أي نصر، لا في حمص ولا في غيرها، لكنه يحاول اللعب على مشاعر الإنهاك الذي سببه للشعب، من أجل بث اليأس في قلوب خصومه، وزرع الأمل الكاذب في قلوب الموالين له، وتعزيز جبهتهم المهددة بالتفكك والانهيار، بعد ثلاث سنوات من القتل والانتحار وتنامي الشعور بالخسارة وضياع الأمل والمستقبل.
لحمص رمزيتها الكبيرة، بالتأكيد. لكن، لم يحسم خروج مئات المقاتلين منها الحرب، ولا أنهى المفاجآت الكبيرة التي ينتظرها الجميع. في المقابل، من الصحيح أن هذا الخروج الذي يعيد إلى الذاكرة سيرة مقاتلي الثورة من بابا عمرو ومن القصير ويبرود، وغيرها من الأحياء والمدن الكثيرة، يختتم حقبة من الحرب، اتسمت بالانعدام الكامل للتوازن بين مسلحي المعارضة، المؤلفة بأغلبيتها الساحقة من المدنيين، وجيش نظامي مدجج بالسلاح، من رأسه حتى أخمص قدميه، كما اتسمت بسيطرة أساليب قتالٍ تعود إلى حروب المقاومة الشعبية المعروفة. وهو يفتتح حقبة جديدة من الحرب التي ستتخذ بشكل أكبر طابعاً عسكرياً منظماً، ويكون فيها لعوامل المبادرة والهجوم والتسلح النوعي الدور الأول في تغيير منحى الصراع، وتقرير مصيره. وفي هذه الحقبة، التي بدأت بالكاد، ليس من الضروري أن تبقى المبادرة بيد الميليشيات الأجنبية التي يعتمد عليها النظام، ولا أن تستمر هذه الميليشيات في احتكار التفوق في السلاح النوعي، أو في النجاح في تجنيب مناطق ولائها الحرب، أو تأمينها ضد الهجمات التي ستزداد أكثر فأكثر مع الوقت. وإذا توفرت المساعدات، تستطيع المعارضة أن تراهن على تطوع وتدريب مئات آلاف الشباب الذين شرّدتهم ميليشيات النظام، والذين لن يكون أمامهم أي مخرج من حالة التشرد والفقر والضياع سوى العودة إلى بلادهم، واستعادة وطنهم الذي أبعدوا عنه بالعنف والقهر والعدوان.
مهما كان الأمر، يعيش نظام الأسد، والأسد نفسه، آخر أحلام اليقظة التي اعتادوا عليها. وهم يخفون، وراء الحديث الاجوف والمكرور عن انتصاراتٍ وهمية، وإنجازات تذكّرنا بكلمة "خلصت" التاريخية، قلقهم وخوفهم من المرحلة المقبلة التي ستبدأ فيها مفاوضات الكبار، بعد أن وصل كل منهم إلى جزءٍ على الأقل من رهاناته. وسيكون رأس الأسد وزبانيته المقربين الثمن الوحيد، الممكن لأي تفاهم إقليمي ودولي، سواء جاء ذلك لصالح تحقيق مطالب الشعب السوري، أو من دونه.
يمثل الأسد اليوم أمام السوريين والعالم آخر أدواره الهزلية/المأسوية على مسرح السياسة السورية والإقليمية، ويبدو، وهو يحتفي بنصره العسكري والسياسي على الثورة الأنبل في التاريخ، ألعوبة لا حول لها ولا قوة، في قبضة حلفاء شرهين مستعدين في أي لحظة لبيعه وشرائه. وينتظر الجميع، اليوم، الأطراف الداخلية والخارجية التي شاركت في الجريمة، الإعلان عن نهاية اللعبة، للبحث عن كبش المحرقة المثالي الذي سيعلقون عليه جرائمهم وانتهاكاتهم. ومنذ الآن، يشكل الإعداد لتقديم ملف النظام إلى محكمة الجنايات الدولية الخطوة الأولى على طريق نصب المشنقة التي تسعى المجموعة الدولية، التي تواطأت سنوات مع العنف ضد الشعب السوري، إلى استخدامها لتبرئة نفسها، ودفع التهم عنها. ولن يتحقق ذلك إلا بجعل الذين خانوا شعبهم، وفتحوا أبوابه لأعدائه، كي يحتفظوا بسلطانهم، أول ضحاياها. وسيكون هذا أقل من القليل مما يستحقونه من عقاب.